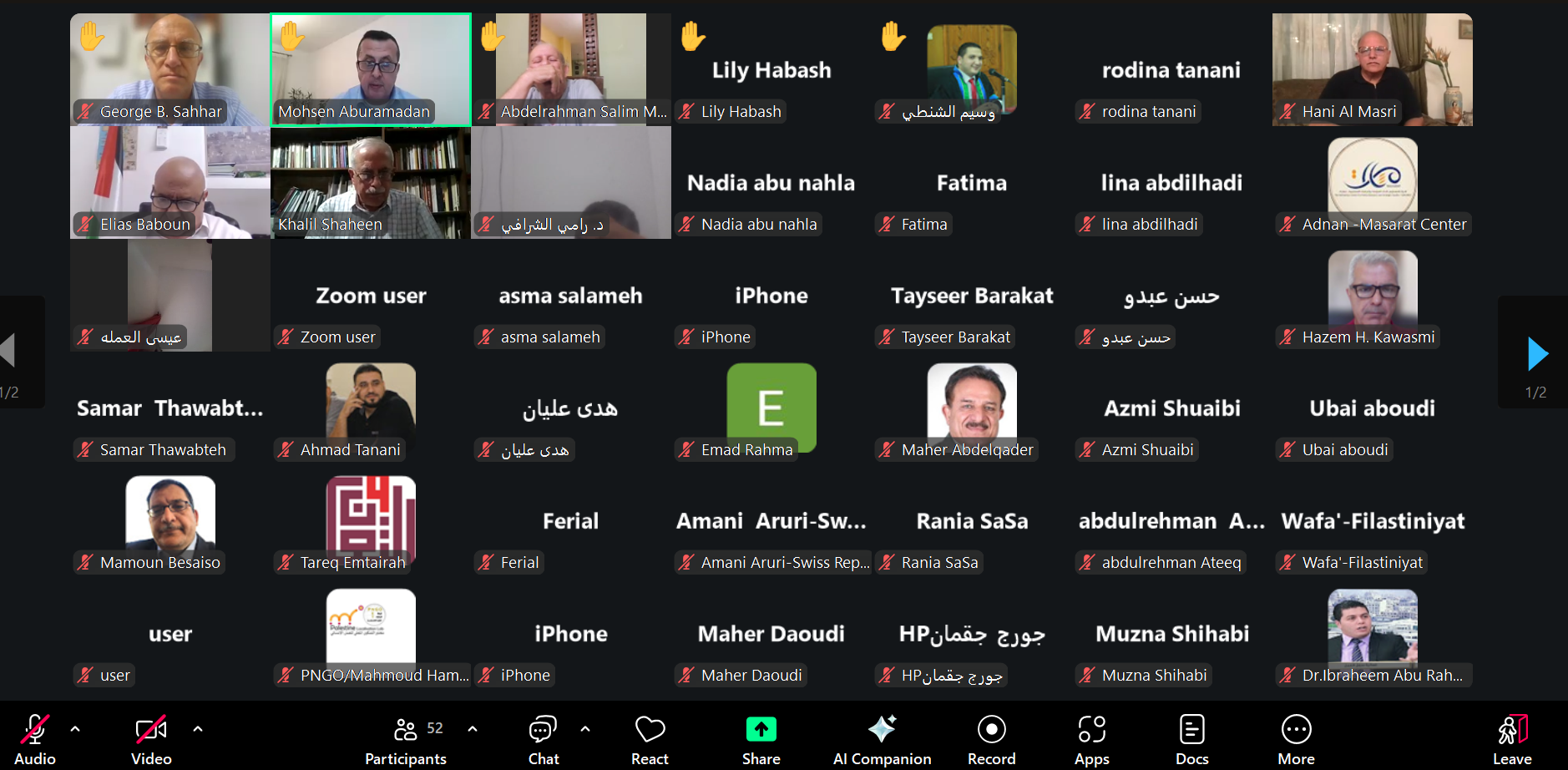نحو تعزيز دور المجتمع المدني
في الوحدة ووقف العدوان والإعمار
وإحباط الضم والتهجير
السبت، 22 آذار/ مارس 2025
يتضمن هذا الإصدار أوراق العمل المقدمة إلى جلسات المؤتمر
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية –مسارات
2025
مؤتمر
نحو تعزيز دور المجتمع المدني
في الوحدة ووقف العدوان والإعمار
وإحباط الضم والتهجير
تدقيق لغوي
عبد الرحمن أبو شمّالة
الطبعة الأولى: حزيران/ يونيو 2025
جميع الحقوق محفوظة
ISBN: 978-9950-400-00-0
المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات)
المقر الرئيسي: مقابل بلدية البيرة، عمارة كراكرة، ط2
هاتف: 009722973816
www.masarat.ps
masarat.ps@gmail.com
المحتويات
تقديم
ملخص جلسات المؤتمر
الجلسة الأولى
طلال أبو ركبة: نحو مبادرات فعالة للإصلاح السياسي والتمثيلي لأطر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية
أمجد الشوا: آفاق تفعيل مبادرات منظمات المجتمع المدني في الاستجابة للمخاطر وتعزيز الصمود
حسن أيوب: سياسات التوافق في مواجهة سياسات الإقصاء
عماد أبو رحمة: تطبيق إعلان بكين ومقومات تجاوز التحديات والعقبات
الجلسة الثانية
أحمد الطناني: نحو رؤية وطنية موحَّدة لتعزيز الصمود ومواجهة مخططات التهجير والضم
أنطوان شلحت: إسرائيل وفلسطينيو 1948 تحت وطأة الحرب على قطاع غزة: تعزّز نظرة "العدو من الداخل"!
هدير البرقوني: آفاق نجاح الخطة العربية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة
إبراهيم فريحات: إطار مقترح لحوار فلسطيني إقليمي دولي لتوسيع مساحات التوافق والفعل الداعم للحقوق الفلسطينية
الجلسة الثالثة
أبي العابودي: حق تقرير المصير الفلسطيني وتعزيز الصمود ... نداء الحرية والكرامة
المشاركون/ ات
تقديم
عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والمنتدى الاجتماعي التنموي، السبت، 22 آذار/مارس 2025، مؤتمر "نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير"، وجاهيًا في البيرة والقاهرة، وعبر زوم من غزة والشتات، بمشاركة نحو 300 ممثل/ة عن منظمات المجتمع المدني، ومختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، والشباب، وشخصيات فلسطينية مستقلة تقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وبلدان الشتات.
وجاء تنظيم المؤتمر في مرحلة مهمة في ضوء انفلات العدوانية الإسرائيلية في توسيع شن الإبادة الجماعية وتدمير مقومات الحياة والتهجير القسري الداخلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وانقلاب حكومة بنيامين نتنياهو، بدعم أميركي سافر، على الجهود الرامية لوقف العدوان، وكذلك بعد نتائج القمة العربية في القاهرة، التي اعتمدت الخطة المصرية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، كما أكدت الدعم للجهود المصرية لتسويق الخطة على المستوى الدولي، والتحضير لعقد مؤتمر دولي داعم لتنفيذ الخطة، بما يمكّن من إحباط أي مخططات تسعى إلى تهجير سكان قطاع غزة.
وهدف المؤتمر إلى تفعيل دور مكونات المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير رؤية فلسطينية وطنية كفيلة بتفعيل دور المجتمع المدني، وتنبثق عنها خطط وأدوات عمل موجهة خصوصًا لدعم هذه الجهود، والضغط لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، ومواجهة مخططات العدوان والضم في الضفة الغربية. وتم تنظيمه بناءً على توصيات الورشة الحوارية التي عقدت في القاهرة، على مدار يومين، في 23 و24 آب/أغسطس 2024، بعنوان "رؤى وحلول سياساتية فلسطينية"، بمشاركة مجموعة من الشخصيات والخبراء الفلسطينيين، واستهلت بكلمة افتتاحية قدمها ممثل عن وزارة الخارجية المصرية.
كما تم عقد مؤتمر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تحت عنوان "فلسطين 2025: من أجل الوحدة ووقف العدوان"، للبناء على توصيات ورشة القاهرة، بمشاركة قيادات في فصائل سياسية ووزراء وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء وكتاب ومحللين سياسيين وأكاديميين من فلسطين وخارجها، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومجتمعية.
يتضمن هذا الإصدار 9 أوراق عمل قدمت خلال أعمال المؤتمر، وتم تطويرها وإغناؤها بشكل نهائي في ضوء النقاشات والتوصيات التي طرحت خلال جلسات المؤتمر.
ملخص جلسات المؤتمر
"نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة
ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير"
عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والمنتدى الاجتماعي التنموي، مؤتمر "نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير"، في البيرة، وعبر زوم من غزة والقاهرة، بمشاركة أكثر من 250 ممثلًا/ة عن منظمات المجتمع المدني، ومختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، والشباب، وشخصيات فلسطينية مستقلة تقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وبلدان الشتات.
وجاء تنظيم هذا المؤتمر في مرحلة مهمة في ضوء انفلات العدوانية الإسرائيلية في توسيع شن الإبادة الجماعية، وتدمير مقومات الحياة، والتهجير القسري الداخلي في قطاع غزة والضفة الغربية، وانقلاب حكومة بنيامين نتنياهو، بدعم أميركي سافر، على الجهود الرامية لوقف العدوان، وكذلك بعد نتائج القمة العربية في القاهرة، التي اعتمدت الخطة المصرية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، وأكدت الدعم للجهود المصرية لتسويق الخطة على المستوى الدولي، والتحضير لعقد مؤتمر دولي داعم لتنفيذ الخطة، بما يمكّن من إحباط أي مخططات تسعى إلى تهجير سكان قطاع غزة.
وهدف المؤتمر إلى تفعيل دور مكونات المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير رؤية فلسطينية وطنية كفيلة بتفعيل دور المجتمع المدني، وتنبثق عنها خطط وأدوات عمل موجهة، وبخاصة لدعم هذه الجهود، والضغط لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، ومواجهة مخططات العدوان والضم في الضفة الغربية.
ونُظم المؤتمر بناءً على توصيات الورشة الحوارية التي عقدت في القاهرة، على مدار يومين، في 23 و24 آب/أغسطس 2024، بعنوان "رؤى وحلول سياساتية فلسطينية"، بمشاركة مجموعة من الشخصيات والخبراء الفلسطينيين، واستهلت بكلمة افتتاحية قدمها ممثل عن وزارة الخارجية المصرية.
الجلسة الافتتاحية
خلال الجلسة الافتتاحية التي يسّرتها الإعلامية سمر ثوابتة، قال مدير عام مركز مسارات هاني المصري، إن المؤتمر هو نداء من أجل الوحدة الوطنية، وبخاصة مع تجدد الإبادة الجماعية، مضيفًا أنه بدون وحدة وطنية سنكون ساهمنا في ضياع القضية وتطبيق مخطط التصفية لها.
وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع المجتمع المدني الذي أصبح في تراجع، كما أن منظمة التحرير في تراجع، حيث يتم بحث سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة بدون الفلسطينيين، وما يساعد على ذلك هو عدم توحد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هناك تصفية لكل المكونات الفلسطينية "القضية والشعب والأرض والمؤسسات"، وهذا يلقي أعباءً مضاعفة على المجتمع المدني للقيام بدوره الوطني والمهني.
وأوصى المصري بضرورة تطبيق إعلان بكين، وتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الشعب الفلسطيني، لأن التصفية تستهدف القضية الفلسطينية، مؤكدًا على وجوب عدم إعادة إنتاج الأخطاء السابقة في أي عملية سياسية مستقبلية.
وقال مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) د. عزمي الشعيبي، إنه في الحالة الفلسطينية يتطلب أن يكون للمجتمع المدني الواسع دور مؤثر في القضايا الوطنية، وإنهاء الاحتلال، وتقرير المصير، وتشكيل هوية وشكل النظام السياسي والحياة الديمقراطية.
وأشار إلى أن المجتمع المدني الفلسطيني يعاني من بعض "الأمراض" التي تعاني منها السلطة أيضًا، من حيث القيادات، وتقديم ملفات شبهات فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، والتحول إلى عمل نخبوي، ووجود الشخصنة داخل المؤسسات.
وأوصى الشعيبي بإعادة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، وبناء الائتلافات، وليس العمل النخبوي، والعودة إلى منظومة العمل الجماهيري من خلال العمل التطوعي، وتعزيز العمل الوطني، وإنشاء مرصد للبيانات والمعلومات ذات العلاقة.
بدوره، استعرض مدير البرامج في مؤسسة الحق تحسين عليان دور المجتمع المدني في مساءلة الاحتلال على الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة، من خلال رفع قضايا في محكمة العدل الدولية، وغيرها من المحاكم والمؤسسات الدولية، ورفع قضايا في المحاكم الوطنية بالدول، ورفع قضايا من أجل وقف تصدير السلاح للاحتلال، إلى جانب المناصرة في مؤسسات الأمم المتحدة والكثير من الدول.
وأوصى عليان بضرورة تضمين تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المدنية عن جرائمها في قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من تعويض للمواطنين عن جراء الاحتلال.
وأشارت المديرة العامة لمركز شؤون المرأة آمال صيام، إلى أن المنظمات النسوية لعبت دورًا مهمًا ومحوريًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحياة بالضفة وغزة، وعملت على حماية حقوق النساء في الوصول إلى العدالة والحقوق، وتحسين أوضاعهن في المجتمع، ونقل القضايا من قضايا نسائية إلى قضايا مجتمع. كما ساهمت المنظمات، خلال حرب الإبادة، في تنسيق الجهود الإنسانية، ولعبت دورًا في الدعم النفسي والوقاية من العنف وتقديم رزمة مساعدات متعددة للنساء، ونفذت العديد من البرامج الإغاثية والتغيير الإيجابي لصالح قضايا النساء.
وأوصت بتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة، وإحقاق الوحدة الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات النسوية في كل الحوارات المتعلقة بالوحدة الوطنية، وتعافي غزة، والمفاوضات.
الجلسة الأولى
في الجلسة الأولى التي يسرتها الناشطة الشبابية روان زقوت، استعرض محلل السياسات د. طلال أبو ركبة، جوهر أزمة الإصلاح السياسي في منظمة التحرير، وهي: أزمة البنية التنظيمية المتمثلة بترهل الهيكل المؤسسي وتراجع الفعالية، وأزمة التمثيل وغياب الانتخابات وتهميش الشتات الفلسطيني، وغياب المؤسسية جراء مركزية القرار، وإضعاف المؤسسات الرقابية، والتفرد في القرار، وتهميش الأطر الفاعلة.
وقدّم أبو ركبة توصيات تتعلق بالخطوات المطلوبة على المستويات البعيدة والمتوسطة والمباشرة، وقال إن الخطوات الإستراتيجية بعيدة المدى تتمثل في إعادة بناء المنظمة عبر إصلاح جذري لمؤسساتها، وضمان ديمقراطيتها واستقلاليتها عن السلطة، وإجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني، ووضع آليات قانونية تضمن تمثيل جميع الفلسطينيين، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، تشمل المقاومة الشعبية والدبلوماسية والسياسية. وتتمثل الخطوات متوسطة المدى في تفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وإصلاح مؤسسات المنظمة الداخلية، مثل الدوائر التنفيذية والصندوق القومي الفلسطيني، لضمان الشفافية والكفاءة، وتعزيز العلاقات مع الشتات الفلسطيني، عبر إنشاء هيئات تمثيلية جديدة تضمن إشراكهم في القرار الوطني. أما الخطوات القابلة للتطبيق فورًا، فإنها تتمثل في إطلاق حوار وطني شامل لوضع آليات تنفيذية واضحة للإصلاح، واتّخاذ قرار سياسي بتحديث سجل الناخبين، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل المجلس المركزي لمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاح وضمان عدم تعطيلها.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن قطاع غزة شهد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق في المخاطر التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية، ما فرض على منظمات المجتمع المدني تبني منهجيات تحليل مخاطر جديدة، وفهم أعمق للتحولات السياسية والاقتصادية. ومن أبرز هذه المخاطر: "حرب الإبادة، تدمير البنية التحتية، حرب التجويع، التهجير القسري، تشديد الحصار، الانقسام الفلسطيني".
ووِفق الشوا، يتطلب تعزيز إستراتيجيات الصمود، أولًا: تحليل المخاطر والتكيف مع الواقع المتغير، ثانيًا: تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة، ثالثًا: فهم سياسات المانحين وتأثيرها على نماذج التدخل والاستجابة.
ولاستنهاض دور المنظمات الأهلية (بالتركيز على قطاع غزة)، أوصى الشوَّا، بإعادة تأهيل الهياكل الإدارية والتنظيمية للمنظمات الأهلية، وضرورة أن تكون لدى المنظمات الإنسانية خطط طوارئ قابلة للتنفيذ لمجموعة من السيناريوهات، وتنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والضغط لتضمين المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط، وتدشين حملات على المستوى الدولي بمشاركة الشباب، وفتح علاقات مع قطاعات جديدة في العالم، وبخاصة في أوروبا.
بدوره، قال أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح د. حسن أيوب، إن انتظار الانتخابات وفق إعلان الرئيس محمود عباس في القمة العربية، سيكون مكلفًا سياسيًا ووطنيًا، وفي ظل التراجع المفزع لروافع الكفاح الوطني والمقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، وما يجري من محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، لذلك لا بد من العمل، وبدون تأخير، من أجل فرض التوافق كمهمة وطنية تعيد تأسيس العلاقات الداخلية على قاعدة مشروع تحرر وطني يتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة، ويبني على مكتسباتها وإنجازاتها.
وأضاف أنه يجب التحرك قدمًا من خلال جذب مزيد من القوى السياسية والاجتماعية إلى الحراكات الشعبية الضاغطة، وبما يشمل هيئات منظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها، بما يمكنها من أن تطلق ديناميكية ذات زخم شعبي تفرض نفسها، وتفرض التوافق على قاعدة تمثيل سياسي وطني تقوده المنظمة بربط إصلاحها واستعادة دورها، لتتمكن من القيام بدورها وفرض التوافق المؤسسي والسياسي على السلطة.
وطرح مستشار مركز مسارات في غزة د. عماد أبو رحمة، متطلبات تجاوز العقبات والتحديات، أبرزها: توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف كافة، لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام على أسس الشراكة والتعددية، وعدم رهن المصالحة بالضغوط الداخلية والخارجية، أو بالاعتبارات التكتيكية لهذا الطرف أو ذاك، وضرورة تبني منظور شامل للمصالحة، يقوم على ضرورة التوافق على البرنامج السياسي وإستراتيجية التحرر الوطني، والاتفاق على أشكال النضال ومرجعيتها، والتوافق على أسس الشراكة التعددية، وإعادة بناء المؤسسات التمثيلية لمنظمة التحرير وفقًا لهذه الأسس، علاوة على ضرورة الاتفاق على آليات بجدول زمني ملزم لتطبيق بنود اتفاق بكين، والنأي بالنفس عن المحاور والصراعات العربية والإقليمية، وتحصين البيت الفلسطيني من التدخلات الخارجية، والتصدي لمحاولات فرض الوصاية الدولية والعربية على الشعب الفلسطيني، وأخيرًا صياغة خطة وطنية للاستفادة من زخم ثورة الرأي العام الدولي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
الجلسة الثانية
خلال الجلسة الثانية التي يسرتها مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، رأى الباحث في الشأن السياسي أحمد الطناني، أنه لمواجهة مخططات التهجير والضم، تتطلب بلورة رؤية فلسطينية موحدة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية باتت ضرورة لمواجهة هذه المخططات والتهديدات الوجودية للقضية الفلسطينية، ولاستكمال المشروع الوطني.
ودعا لإصلاح منظمة التحرير بما يشمل الفصائل، وعقد مؤتمر وطني يوفر البرنامج السياسي للمنظمة، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات المنظمة. كما أكد على ضرورة تبني إستراتيجية للمقاومة الشاملة الموحدة، وتعزيز حملات المقاطعة للاحتلال، واستعادة وحدة المؤسسات وإنهاء الانقسام، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة وتذليل العقبات أمامها.
وأشار الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، إلى أنه مُنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يوم عملية طوفان الأقصى وإعلان إسرائيل حرب الإبادة الجماعيّة والتدمير الشامل على قطاع غزة، يتعرّض الفلسطينيّون في أراضي 1948 إلى ملاحقة سياسية بذرائع أمنيّة، وإلى حملة قمع شعواء لحرية التعبير المُقيّدة أصلًا.
وبيّن أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين في أراضي 1948 إبان الحرب على غزة، على أنهم عدو داخلي وطابور خامس ومثار قلق إستراتيجي، ما يستلزم استمرار التعامل معهم بمقاربة أمنية فقط، والتنائي عن الاستثمار في التربية على مناهضة العنصرية حيال الفلسطينيين والعرب عمومًا، بما يخدم تكريسها ضدهم كجنس بشري أدنى، غير مستحق لأي حقوق جماعية.
وقال إنه في الأسابيع الأخيرة، أطلق التجمّع الوطني الديمقراطي مبادرة جديدة لحوار وطني ومجتمعي شامل، يهدف إلى إعادة تنظيم عمل المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعمل مؤسساته السياسية، وذلك لخطورة المرحلة التاريخية التي تواجه شعبنا وقضيّتنا الفلسطينية، وحالة الانقسام المُزمن بين الفصيلين الأساسيين في قيادة شعبنا، إضافة إلى حالة الانقسام والتشرذم السياسي في الداخل، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.
من جانبها، أوصت الباحثة السياسية هدير برقوني، بضرورة تبنِّي نهج وطني وحدوي فلسطينيًا، والضغط العربي والدولي من أجل إلزام الاحتلال بوقف الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتأمين التمويل لإعادة الإعمار، وإشراك المجتمع المحلي والمدني في قطاع غزة، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وضرورة وضع خطة وطنية إستراتيجية وتنموية شاملة.
وقالت إنه لا يمكن أن يقتصر التعافي في قطاع غزة على إعادة الإعمار، بل يجب أن يترافق مع سياسات إستراتيجية وتنموية شاملة، تأخذ الدروس من التجارب السابقة، وتأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن تحقيق تنمية مستدامة، وتهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، وضمان الوصول إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.
وأضافت برقوني أن تطبيق خطة إعادة الإعمار المصرية، المتبناة عربيًا، يجب أن يُمنَح الأولوية في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وأن تكون الخطة مدخلًا جديدًا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيدًا لبدء أية عملية تسوية. ومن شأن آلية عمل جادة تعطي المجتمع المدني في قطاع غزة دورًا أقوى في عملية إعادة الإعمار، أن تكون بمثابة عامل أساسي في تفعيل دور المجتمع المدني في قطاع غزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية نحو النهوض بالحالة الفلسطينية الراهنة، بما يتجاوز الآفاق الضيقة التي خلقها الاحتلال وعزَّزها الانقسام الفلسطيني.
وقال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا د. إبراهيم فريحات، إن هناك غيابًا للاستثمار الفلسطيني في الساحة الدولية، في ظل التحولات الجارية، حيث بلغت نسبة المؤيدين للحقوق الفلسطينية في الحزب الديمقراطي 59%، ولكن لا استثمار فلسطيني لذلك.
وأضاف أن الفلسطينيين مدعوون للعمل على ثلاث ساحات رئيسية: الداخلية، والإقليمية، والدولية، للاستفادة من التحولات الدولية والتقدم باتجاه تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني:
أولًا. المستوى الداخلي: من المهم جدًا فهم العلاقة ما بين المستوى الداخلي مع المستويات الإقليمية والدولية؛ إذ يضطلع بالداخل أخذ دور القيادة في النضال الوطني حتى تعززه المستويات الإقليمية والدولية.
ثانيًا. المستوى الإقليمي: لم ينخفض الدعم العربي للقضية الفلسطينية تاريخيًا كما هو الحال اليوم، وذلك لأسباب متعددة، منها ما هو خاص بالوضع العربي نفسه، مثل حالة الاستقطاب الإقليمي والثورات العربية الداخلية، ومنها ما هو مسؤول عنه الطرف الفلسطيني نفسه، حيث سمح بأن يكون جزءًا من حالة الاستقطاب العربي.
ثالثًا. المستوى الدولي: تاريخيًا، وجد التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية بدرجات عالية في ساحات مثل دول عدم الانحياز، والكتلة الشرقية، والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى القوى العربية والإسلامية. ولكن، تمدد هذا التأثير لدرجات غير مسبوقة حديثًا لدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وما لها من تأثير في صناعة القرار الدولي على المستويين الرسمي والشعبي.
الجلسة الثالثة
في الجلسة الثالثة والأخيرة التي يسَّرها مدير البرامج في مركز مسارات خليل شاهين، عرض المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أُبي العابودي وثيقة تضمنت تصورًا لتفعيل دور المجتمع المدني في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي جاءت نتاجًا لنقاش مع عشرات الشخصيات من مديري مؤسسات أهلية وشخصيات عامة وناشطين وحقوقيين، مؤكدًا أن المجتمع المدني يتمسك بحق تقرير المصير، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وبحاجة للإصلاح وفق إعلان بكين.
واستعرض العابودي آلية العمل في الوثيقة، وهي: ضرورة وجود تنظيم شعبي فلسطيني وإحياء اللجان الشعبية الفلسطينية، بما يساهم في تعزيز صمود المواطن، ويمكن أن تشكل قوة لإصلاح النظام السياسي؛ العودة إلى الناس ورفع الصوت لإجراء الانتخابات وغيرها؛ ضرورة وضع إستراتيجية وطني للنضال؛ الاستفادة من القرارات الدولية ومحاسبة الاحتلال؛ وضع إستراتيجيات عاجلة للمناطق التي تعاني من عدوان الاحتلال والتهجير وتوفير مساكن بديلة للمهجرين قسرًا؛ تعزيز مشاريع التأهيل المجتمعي لمنع تفريغ الأرض من المواطنين؛ تعزيز مؤسسات التضامن الاجتماعي وحماية الفلسطينيين من التهجير؛ التكافل الاجتماعي حصن ضد التهجير القسري، ومواجهة تفكيك البنية الاجتماعية.
وأوصت الوثيقة بتشكيل ائتلاف لاستكمال الحوار المجتمعي حولها، والإسراع في تشكيل اللجان الشعبية في المناطق كافة، وليس المتضررة فحسب، والتخطيط لمؤتمر واسع لإطلاقها بشكل واسع، والعمل على توفير مقومات الصمود المعنوية والمادية على أرض فلسطين، وبخاصة في المخيمات، وتنسيق الجهود بين المؤسسات التنموية والإغاثية والحقوقية والقطاع الخاصة واللجان الشعبية من أجل رفع دور الكفاءات لتعزيز الصمود، ومخاطبة المجتمع من قبل القائمين على المبادرة بشكل مستمر.
نداء المجتمع المدني
وفي ختام أعمال المؤتمر، تم إطلاق نداء "من أجل الوحدة ووقف الإبادة وإحباط الضم والتهجير" للتوقيع عليه من أفراد ومؤسسات منخرطة في العمل الأهلي والمدني الفلسطيني، لضم صوتهم/ن إلى "كل الأصوات والمبادرات والحراكات التي تدعو لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية فورًا، ودون إبطاء"، مع التعهد "بمواصلة هذا العمل وممارسة مختلف أشكال الضغط السياسية والجماهيرية والقانونية حتى يتكلل بالنجاح".
وطالب النداء بتطبيق إعلان بكين، من خلال الشروع الفوري في تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات وطنية، بمرجعية وطنية، على أساس برنامج وطني يحفظ الحقوق والمصالح الفلسطينية، وقابل للتطبيق، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتعزيزه، إلى حين إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن على كل المستويات، وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير بما يمكنها من تمثيل الشعب الفلسطيني في كل مكان بفاعلية وأفضل شكل ممكن.
ودعا إلى "إعطاء الأولوية العليا لتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري، التي تستهدف الشعب في الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين، ومصادرة الأرض واستعمارها، وتهويد القدس، والعمل على تحرير الأسرى والأسيرات".
كما أكد ضرورة "توفير كل أنواع المساعدات المادية والمعنوية لشعبنا في قطاع غزة، وفي طولكرم وجنين وكل المواقع المستهدفة، التي تتعرض لكل أنواع الجرائم الجماعية على مرأى ومسمع العالم كله، وذلك لتوفير متطلبات الإغاثة والتعافي والعلاج والسكن الآمن، والشروع في عملية إعادة الإعمار بعيدًا عن الشروط السياسية المجحفة".
وطالب بتشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بوقف الإبادة الجماعية، وانسحاب القوات المحتلة، أو تبادل الأسرى، أو إعادة الإعمار، أو فيما يتعلق بالكفاح لتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي يشمل حقه في إنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وممارسة حق العودة للاجئين.
وأكد "حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بجميع الأشكال، على أن تخضع هذه المقاومة للقيادة الوطنية الشرعية الموحدة، وتجسد إستراتيجية وطنية متفق عليها".
وأشاد "بكل أشكال الدعم والتضامن مع شعبنا، وبخاصة في غزة الأبية الصابرة"، مؤكدًا على ضرورة "مواصلة وتوسيع حركات التضامن والدعم، والعمل لمناصرة القضية الفلسطينية العادلة والمتفوقة أخلاقيًا، ومن أجل عزل دولة الاحتلال ومحاصرتها، ومقاطعتها، وفرض العقوبات عليها، وفضح مواقف الدول المنحازة للعدوان، وبخاصة الإدارة الأميركية".
الجلسة الأولى
إدارة الجلسة: روان زقوت
طلال أبو ركبة: نحو مبادرات فعالة للإصلاح السياسي والتمثيلي لأطر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية
أمجد الشوا: آفاق تفعيل مبادرات منظمات المجتمع المدني في الاستجابة للمخاطر وتعزيز الصمود
حسن أيوب: سياسات التوافق في مواجهة سياسات الإقصاء
عماد أبو رحمة: تطبيق إعلان بكين ومقومات تجاوز التحديات والعقبات.
نحو مبادرات فاعلة للإصلاح السياسي
والتمثيلي لأطر منظمة التحرير الفلسطينية
د. طلال أبو ركبة
مقدمة
تمثل منظمة التحرير الفلسطينية حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني منذ تأسيسها العام 1964، حيث لعبت دور الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووفرت إطارًا سياسيًا جامعًا للقوى والفصائل المختلفة. إلا أن المنظمة تواجه اليوم أزمة وجودية عميقة، لا تقتصر على تحديات خارجية أو صراعات مع الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل تمتد إلى بنيتها الداخلية، حيث تعاني من تفكك هيكلي، وتراجع في مستوى التمثيل، وغياب آليات العمل المؤسسي، ما أدى إلى حالة من التفرد في صنع القرار وتهميش الأطر الفاعلة. هذه الأزمة تجعل من المنظمة كيانًا مترهلًا، غير قادر على تلبية التحديات الراهنة، سواء فيما يتعلق بإعادة توحيد الفلسطينيين، أو مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
على الرغم من أن مسألة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، على مدار العقود الماضية، قد حظيت بالعديد من السجالات والنقاشات في الحقل السياسي الفلسطيني، إلى الدرجة التي تحوّل فيها النقاش والرأي في مسألة الإصلاح إلى معركة سياسية، بفعل حالة الاشتباك التي شهدتها الساحة الفلسطينية بين المصالح الفصائلية والتوازنات الداخلية من جهة، والحسابات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، فإنها كانت مقتصرة على مسألة إدماج فصيل جديد من عدمه في المنظمة، مع أنه كان يجب أن تذهب إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير، وبخاصة السؤال المرتبط بطبيعة النظام السياسي، والبحث في إمكانية بناء منظومة سياسية ديمقراطية دون أن تؤدي إلى تفكيك المؤسسات القائمة، وتحقيق شراكة وطنية دون أن تتحول إلى شكل من أشكال الاستبداد الجديد بأدوات مختلفة، وإلى تقديم معالجات للإصلاح السياسي داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها.
فالرهان على نجاح أو فشل الفلسطينيين في إصلاح منظمتهم يرتكز، في جوهره، على أسس مستدامة، تتمثل في إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، بحيث يضمن تمثيل الجميع دون أن يعرّض الاستقرار السياسي لخطر الانقسام أو الاستحواذ الأحادي، وهو ما يتطلب اعتماد آليات إصلاح تضمن الفصل الواضح بين المصالح الفصائلية والمصلحة الوطنية العليا، مع وضع نظام رقابي صارم،[1] يمنع أي طرف؛ سواء كان من التيارات الإسلامية أو الفصائل التقليدية، من تحويل المنظمة إلى أداة لخدمة أجندته الخاصة.
تسعى الورقة إلى إبراز جوهر أزمة الإصلاح السياسي والتمثيلي داخل أطر منظمة التحرير، من خلال استعراض مكثف لمواقف الفاعلين في السياق الفلسطيني، وإلى المبادرات التي قدمت خلال العقود الأخيرة لإصلاح المنظمة، والخروج بخارطة طريق تقدم رؤية إجرائية وإستراتيجية لتحقيق الإصلاح السياسي والتمثيلي المطلوب داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها بشقيها الرئيسي والفرعي.
جوهر أزمة الإصلاح السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية: تفكك البنية، تآكل التمثيل، غياب المؤسسية
يمكن رصد أزمة منظمة التحرير الفلسطينية في أربعة عناصر أساسية، وهي:
- أزمة البنية التنظيمية: ترهل الهيكل المؤسسي وتراجع الفعالية
خضعت منظمة التحرير الفلسطينية، منذ إنشائها، إلى تحولات جوهرية عدة، إلا أن بنيتها التنظيمية لم تتكيف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها الشعب الفلسطيني، فمع توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، دخلت المنظمة في مرحلة جديدة، حيث تراجعت فعاليتها كمؤسسة قرار، لصالح السلطة الفلسطينية، التي باتت تمثل الإدارة الفعلية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تفكيك تدريجي للمؤسسات الحيوية للمنظمة؛ مثل المجلس الوطني، والمجلس المركزي، حيث تراجع دورهما لصالح دوائر جديدة من صناعة القرار، الأمر الذي أدى لتعطيل آليات صنع القرار الجماعي الذي كانت تتميز به المنظمة في العقود السابقة.[2]
بجانب ذلك، لم يتم تحديث اللوائح والهياكل التنظيمية للمنظمة بما يتلاءم مع التطورات السياسية، حيث لا تزال بعض المؤسسات تعمل وفق أنظمة قديمة، لا تعكس الواقع الحالي، ولا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الدمج بين الفصائل المختلفة أو استيعاب التيارات السياسية الجديدة التي نشأت في أعقاب الانتفاضتين الأولى والثانية.
- أزمة التمثيل وغياب الانتخابات وتهميش الشتات الفلسطيني
تعاني منظمة التحرير من أزمة تمثيلية خانقة، حيث غابت الانتخابات عن مؤسساتها منذ عقود، ما جعل قيادتها غير منتخبة بشكل ديمقراطي، بل قائمة على تعيينات توافقية بين الفصائل (الديمقراطية التوافقية) أو (المحاصصة الفصائلية)، غالبًا ما تتمحور حول حركة فتح، التي تحتفظ بالهيمنة على مفاصل المنظمة. هذا الأمر أدى إلى تهميش أصوات واسعة من الشعب الفلسطيني؛ سواء في الداخل أو الشتات، حيث يشعر ملايين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والمهجرين حول العالم، بأنهم غير ممثلين بشكل حقيقي في مؤسسات المنظمة.[3]
إضافة إلى ذلك، فإن عدم إدماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي ضمن أطر المنظمة، أدى إلى خلق حالة من الانقسام، حيث فقدت المنظمة قدرتها على تمثيل الكل الفلسطيني، وباتت أقرب إلى كيان يعبر عن فصائل محددة، وليس عن الشعب الفلسطيني بأسره. وعلى الرغم من العديد من المحاولات لإعادة هيكلة المنظمة بحيث تضم جميع التيارات السياسية، فإن هذه المبادرات ظلت معطلة بسبب خلافات داخلية، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
- غياب المؤسسية: مركزية القرار وإضعاف المؤسسات الرقابية
تفتقر منظمة التحرير إلى آليات الحوكمة الرشيدة التي تضمن صنع القرار بطريقة جماعية وشفافة؛ إذ أصبح مركز القرار محصورًا في دائرة ضيقة من القيادات، مع غياب واضح للمؤسسات الرقابية الفاعلة. فالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي من المفترض أن يكون برلمانًا يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات، لم ينعقد بانتظام، ولم يتم تجديد عضويته بطريقة تعكس التغيرات الديموغرافية والسياسية للمجتمع الفلسطيني.[4] كما أن المجلس المركزي، الذي كان من المفترض أن يلعب دورًا تنفيذيًا فاعلًا، أصبح مجرد أداة لتمرير قرارات القيادة العليا، دون أن يتمتع بسلطة فعلية تمكنه من محاسبة الجهات التنفيذية داخل المنظمة.[5]
إضافة إلى ذلك، فإن صندوق المنظمة القومي، الذي يفترض أن يكون الجهة المالية المسؤولة عن تمويل الأنشطة الوطنية، يفتقر إلى الشفافية، حيث تدار أمواله بطرق غير خاضعة للرقابة،[6] ما يعزز الفساد ويفقد المنظمة شرعيتها أمام الفلسطينيين. كما أن غياب آليات المساءلة الداخلية جعل المنظمة عاجزة عن تصحيح مسارها، حيث لم يتم تفعيل أي مراجعات نقدية جادة لمسار عملها منذ عقود.
- التفرد في القرار وتهميش الأطر الفاعلة
أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تعاني منها المنظمة هو تفرد القيادة باتخاذ القرارات، دون العودة إلى الأطر التنظيمية التي من المفترض أن تشارك في صنع القرار. فالمؤسسات الرسمية للمنظمة أصبحت شكلية، حيث يتم اتخاذ القرارات السياسية الكبرى في إطار ضيق يضم القيادة التنفيذية، دون إشراك الفصائل الأخرى أو الشخصيات المستقلة أو ممثلي المجتمع المدني.[7] هذا النمط من الإدارة، أدى إلى حالة من الإحباط في الأوساط الفلسطينية، حيث بات الكثيرون يرون أن المنظمة لم تعد تعبر عن طموحاتهم،[8] وإنما تحولت إلى أداة للحفاظ على الوضع القائم، بدلًا من أن تكون محركًا لمشروع التحرير الوطني. كما أن الفصائل الصغيرة داخل المنظمة، مثل فصائل اليسار، أصبحت مهمّشة تمامًا، حيث لا يتم الأخذ بآرائها في القرارات المصيرية، ما جعل دورها شكليًا في معظم الأحيان.
مواقف الأطراف الفاعلة في السياق الفلسطيني من مسألة الإصلاح السياسي
برزت مطالب الإصلاح كجزء من محاولات تجديد الشرعية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع دائرة تمثيلها ليشمل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية الفلسطينية، وبخاصة عقب تصاعد الدور السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتان بقيتا خارج إطار المنظمة لعقود، غير أن هذا المسعى الإصلاحي لم يكن محل إجماع، وقوبل بمخاوف واعتراضات، وبخاصة من حركة فتح التي تمثل العمود الفقري للمنظمة، إضافة إلى فصائل اليسار التي تتوجس من إمكانية سيطرة التيارات الإسلامية على القرار الفلسطيني.
موقف حركة فتح
بالنسبة لحركة فتح، التي قادت المنظمة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، تعتبر الحديث عن الإصلاح ينطوي على معضلة معقدة، فمن جهة، لا تستطيع إنكار أن تراجع فاعلية المنظمة وانخفاض شرعيتها التمثيلية يستدعيان إصلاحًا جذريًا يعيد تجديدها وفق أسس ديمقراطية حديثة، ولكنها تخشى من أن تؤدي هذه العملية إلى فقدانها السيطرة على مؤسسات المنظمة، وبخاصة إذا ما أجريت انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى داخل الأطر القيادية. وتشعر فتح بالقلق من أي إعادة هيكلة شاملة قد تعني تقليص نفوذها التاريخي لصالح فصائل منافسة ولها ثقل ووزن شعبي على الأرض، وبخاصة حركة حماس التي تعتبرها فتح تهديدًا أساسيا وأيديولوجيا لنهجها الوطني القائم على الخطاب العلماني والاعتدال السياسي.[9]
كما أن تجربة غزة منذ العام 2007، التي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع بعد صدامات دامية، زادت من مخاوف فتح من أن يؤدي إدخال حماس ضمن منظمة التحرير الفلسطينية إلى تكرار سيناريو مشابه، حيث يمكن لحركة حماس أن تستفيد من نفوذها الشعبي المتنامي -وبخاصة في الضفة الغربية والشتات- لفرض أجندتها السياسية داخل المنظمة، وهو ما تعتبره فتح تهديدًا مباشرًا للمشروع الوطني الفلسطيني برمته. من هنا تجد فتح نفسها في معادلة صعبة، فهي لا تستطيع رفض الإصلاح بشكل علني، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تأطيره بطريقة تضمن استمرار تفوقها السياسي داخل المنظمة.
موقف حركة حماس
تنظر حركة حماس إلى مسألة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها فرصة إستراتيجية لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يعكس التغيرات الحقيقة التي طرأت على موازين القوى منذ آواخر تسعينيات القرن الماضي، فبعد فوزها الكبير في انتخابات المجلس التشريعي الثاني في العام 2006، باتت الحركة تمتلك قاعدة شعبية واسعة، تجعلها ترى نفسها ممثلًا شرعيًا لجزء كبير من الفلسطينيين، إلا أن مسألة دخولها إلى منظمة التحرير تواجه عقبات عديدة، أهمها إصرار المنظمة على التزام الحركة بالاتفاقيات السياسية الموقعة سابقًا، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، والالتزام بالمفاوضات كخيار إستراتيجي، وهو ما ترفضه حركة حماس، التي تعتبر أن هذه الشروط تهدف إلى تحجيمها قبل أن تصبح جزءًا من المؤسسة السياسية الرسمية.[10]
موقف فصائل اليسار
أما فصائل اليسار مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حزب الشعب الفلسطيني، فتدرك أن إدماج حماس في المنظمة قد يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يساهم في كسر احتكار فتح للقرار السياسي داخل المنظمة، وإعادة التوازن بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، ومن ناحية أخرى، فإن تجربة حماس في غزة جعلت العديد من القوى الوطنية تخشى من أن دخولها إلى المنظمة قد يعني إلحاق القرار الفلسطيني بأجندات خارجية، سواء من إيران أو قطر أو تركيا، ما يضعف استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
كما أن بعض القوى اليسارية تخشى من أن تحاول حماس فرض رؤيتها الإسلامية على السياسات العامة للمنظمة، وهو ما يتناقض مع الهوية العلمانية والتقدمية التي قامت عليها منظمة التحرير منذ نشأتها. وعليه، فإن هذه الفصائل تتبنى موقفا مزدوجًا، فهي تؤيد إصلاح المنظمة من حيث المبدأ، ولكنها تدعو إلى وضع ضمانات تمنع أي طرف بعينه من الاستحواذ على القرار الوطني أو رهنه لحسابات إقليمية.
مبادرات الإصلاح السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 2005
شهدت منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 2005 محاولات متكررة لإصلاح هياكلها السياسية والتنظيمية، بهدف استيعاب الفصائل الفلسطينية كافة، وتجديد شرعيتها التمثيلية، وتعزيز دورها كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، مثل اتفاق القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006، واتفاق القاهرة 2011 والاتفاقات اللاحقة، وتفاهمات بيروت 2017، واجتماعات 2020-2021، التي تم التوافق فيها على جملة من النقاط لإصلاح منظمة التحرير، والتي يمكن استخلاصها في النقاط التالية:[11]
- إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، بحيث تصبح مظلة جامعة لكل القوى الفلسطينية.
- إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام ديمقراطي، يتم انتخابه وفق تمثيل يشمل الفلسطينيين في الداخل والشتات، بما يعكس تمثيلًا أوسع للشرائح الفلسطينية المختلفة، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية بما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
- إعادة هيكلة مؤسسات المنظمة لضمان تفعيل دورها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني.
- تشكيل إطار قيادي مؤقت يضم جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، للإشراف على عملية إصلاح المنظمة.
- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني متزامنة لضمان إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
- تشكيل لجان متخصصة لصياغة رؤية مشتركة لإصلاح المنظمة، بما يشمل آليات الانتخابات وإعادة الهيكلة المؤسسية.
- الاتفاق على برنامج سياسي موحد يرتكز على المقاومة الشعبية والدبلوماسية والقانونية، مع الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع.
- تشكيل حكومة توافق وطني للإشراف على المرحلة الانتقالية، ولضمان تنفيذ بنود الاتفاق.
مع ذلك، اصطدمت هذه المبادرات بعقبات وعراقيل حالت دون تنفيذها، ما أدّى إلى استمرار الجمود السياسي داخل المنظمة، وهي:
- عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ بنود الإصلاح، حيث بقيت القرارات في إطار التصريحات دون إجراءات تنفيذية فعلية.
- عدم جدية الأطراف في تنفيذ الاتفاق، حيث بقي مجرد إعلان سياسي دون خطوات عملية على الأرض.
- تباين المواقف السياسية بين الفصائل، حيث استمرت الخلافات حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، ودور المقاومة المسلحة.
- عدم التوافق على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل، والالتزام بالمسار التفاوضي، والخلاف حول مرجعية منظمة التحرير، حيث أصرت فتح على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد، في حين رأت حماس ضرورة إعادة هيكلتها قبل الانضمام إليها.
- استمرار الانقسام بين الضفة وغزة، حيث ظلت المؤسسات السياسية منقسمة بين السلطتين في كل من رام الله وغزة.
- تأثير التطبيع العربي مع إسرائيل، حيث أدى إلى انقسام في الرؤى حول كيفية مواجهة المستجدات الإقليمية.
- عدم الالتزام بتحديد مواعيد واضحة للانتخابات، ما أدَّى إلى فقدان الثقة في إمكانية تنفيذ الإصلاحات.
آليات الإصلاح وتجاوز العقبات
لا تنظر الورقة إلى العقبات باعتبارها قدرًا لا بد من التسليم به، ولكنها تنطلق من إيمان بإمكانية تجاوز العقبات كافة إذا ما توفرت إرادة سياسية حقيقية للإصلاح؛ إرادة تستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي الفلسطيني، وتؤمن به كمدخل من أجل استعادة المنظمة بريقها ودورها الحقيقي في تمثيل أطياف الشعب الفلسطيني كافة، وفي أماكن تواجده كافة، إلا أنه، وقبل الإشارة إلى طرق الإصلاح السياسي التمثيلي الممكنة في السياق الفلسطيني، لا بد من التأكيد على أن مفتاح النجاح الفلسطيني، يكمن في تطوير ميثاق وطني جديد، يكون بمثابة العقد الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، الذي ينتظم الكل الفلسطيني خلفه في بناء إستراتيجياتهم الوطنية، وتحديد أدواتهم النضالية، باعتبار هذا العقد بمثابة الدستور الناظم للتفاعلات والعلاقات الفلسطينية الداخلية كافة.
أما على مستوى تحقيق الإصلاح السياسي والتمثيلي الفلسطيني في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها كافة، فإن الورقة تطرح طريقتين مباشرتين للإصلاح السياسي، وهما:
الأولى: الديمقراطية من أعلى؛ أي التوجه المباشر نحو التجديد الديمقراطي للأجسام المركزية الثلاثة في المنظمة، وهي المجلسان الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك عبر إجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الفصائل، وعلى قاعدة التمثيل النسبي حيثما أمكن ذلك، واعتماد التوافق الديمقراطي بين الفصائل والقوى في الأماكن التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.
الثانية: الديمقراطية من أسفل؛ أي استهداف الاتحادات والأجسام والأطر النقابية للمنظمة؛ مثل الاتحاد العام لطلبة فلسطين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لعمال فلسطين ... إلخ، وهي خطوة لتجديد هذه الأطر والأجسام النقابية، بحيث تكون مقدمة لتجديد شامل للهيئات القيادية العليا كافة؛ مثل المجلس الوطني، والمركزي، واللجنة التنفيذية، ويمكن لهذه الخطوة التدريجية أن تعزز من جسور الثقة بين الفرقاء في المشهد السياسي الفلسطيني، من خلال انتظام سيرها وسلامة إجراءاتها، بما يمهد الطريق، لاحقًا، للانتقال إلى التجديد الديمقراطي الشامل.
الخاتمة
في النهاية، يبقى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية معركة مفتوحة بين ضرورات التحديث ومخاوف الاحتكار، وبين طموحات الشراكة وهواجس الاستحواذ. والمستقبل مرهون بقدرة القوى الفلسطينية المختلفة على تجاوز خلافاتها الفصائلية، والاتفاق على رؤية وطنية موحدة، لا تكون مجرد تسوية مؤقتة، بل تأسيس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الفلسطيني، مرحلة إعادة بناء وتجديد المنظمة كإطار مؤسساتي ممثل للكل الفلسطيني، بما يراعي خصوصية التجمعات الفلسطينية، ويضمن، في الوقت ذاته، شمولية التمثيل الوطني لمكونات المجتمع الفلسطيني كافة، دون تمييز أو تهميش مناطقي أو فصائلي، وبما يضمن تمثيلًا عادلًا للفئات الهشة في المجتمع الفلسطيني، وبخاصة النساء والشباب، وذلك لكي تصبح المنظمة بتكوينها مرجعية وطنية لا تهمّش أو تستثني أيًَّا من مكونات الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، تعزز تلك المشاركة الواسعة والتمثيل الشامل من قابلية المساءلة للأجسام كافة في المنظمة من قاعدتها الاجتماعية، ولذلك تقدم الورقة التوصيات الإصلاحية التالية:
أولًا. خطوات إستراتيجية بعيدة المدى:
- إعادة بناء منظمة التحرير عبر إصلاح جذري لمؤسساتها، وضمان ديمقراطيتها واستقلاليتها عن السلطة الفلسطينية.
- إجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني الفلسطيني، ووضع آليات قانونية تضمن تمثيل جميع الفلسطينيين.
- تبني إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل المقاومة الشعبية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية.
ثانيًا. خطوات متوسطة المدى:
- تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ليضم الفصائل كافة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، للتحضير لمرحلة الإصلاح الشامل.
- إصلاح مؤسسات المنظمة الداخلية؛ مثل الدوائر التنفيذية، والصندوق القومي الفلسطيني، لضمان الشفافية والكفاءة.
- تعزيز العلاقات مع الشتات الفلسطيني، عبر إنشاء هيئات تمثيلية جديدة تضمن إشراكهم في القرار الوطني.
ثالثًا. خطوات منظورة قابلة للتطبيق فورًا:
- إطلاق حوار وطني شامل برعاية محايدة يضم الفصائل كافة، لوضع آليات تنفيذية واضحة للإصلاح.
- اتخاذ قرار سياسي بتحديث سجل الناخبين الفلسطينيين، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجلس الوطني.
- إعادة تفعيل المجلس المركزي الفلسطيني لمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاح وضمان عدم تعطيلها.
المراجع
- جياب، نادية. "هل يكون إحياء منظمة التحرير الفلسطينية سيئة أفضل من عدم وجودها"، رام الله: مسارات.
- برهم، عبد الله. 2007. "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية-إشكالية الهيكلية والبرنامج" (رسالة ماجستير)، نابلس: جامعة النجاح الوطنية.
- نجم، علي. 2020. "مسألة التمثيل الفلسطيني: الانتخابات مقابل الإجماع"، شبكة السياسات الفلسطينية: https://al-shabaka.org/policy-focusview .
- محسن، صالح. 2007. "المجلس الوطني الفلسطيني: إعادة التشكيل وعدالة التمثيل، منظمة التحرير الفلسطينية تقيم التجربة وإعادة البناء"، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
- دراغمة، أمين. 2020. "دورة المجلس المركزي الفلسطيني وتحديات المرحلة"، مركز رؤية للتنمية السياسية: https://vision-pd.org/wp-content/uploadst.com .
- الروس، عماد. 2018. "خبراء وقادة بفتح يكشفون معلومات صادمة عن الصندوق القومي": https://arabi21.com/story/119%8A
- نائلة، خليل. 2018. "إعادة تشكيل المؤسسات السياسية الفلسطينية: الهدف تكريس تفرد عباس"، العربي الجديد: https://www.alaraby.co.uk/% B3
- المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. "استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 57": https://pcpsr.org/ar/node/622
- حيدري، نبيل. "منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس": الصراع في شأن النفوذ"، مجلة الدراسات الفلسطينية:
https://www.palestine-studies.org/ar/node/34919?utm_source=chatgpt.com
- الشوبكي، بلال. 2022. "انضمام حماس والجهاد إلى منظمة التحرير: هل هو ممكن، وكيف؟، شبكة السياسات الفلسطينية: https://al-shabaka.org/commentaries/%D8tgpt.com
- قدس برس. 2025. "محاولات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية... تحديات ومالات" (ورقة حقائق): https://qudspress.com/181049/
- العجري، محمود. 2019. "تحليل مضمون اتفاقيات المصالحة الفلسطينية من منظور سيكوإستراتيجي: دراسة لاتفاقيات المصالحة من (2007- 2017)"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإنسانية:
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/viewFile/4943/3185
- سوارت، ميا. 2019. "المصالحة الفلسطينية وإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية"، مركز بروكنجز الدوحة:
آفاق تفعيل مبادرات منظمات المجتمع المدني
في الاستجابة للمخاطر وتعزيز الصمود
أمجد الشوا
أولًا. حرب الإبادة والتغيرات في تحليل المخاطر وإستراتيجيات الاستجابة
شهد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا غير مسبوق في المخاطر التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية، ما فرض على منظمات المجتمع المدني تبني منهجيات تحليل مخاطر جديدة، وفهمًا أعمق للتحولات السياسية والاقتصادية. ومن أبرز هذه المخاطر:
- حرب الإبادة: شهدت مناطق عديدة من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية استهدافًا مباشرًا للمدنيين، ما أدى إلى خسائر بشرية جسيمة وتدمير ممنهج لمقومات الحياة، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في شهر كانون الثاني/يناير 2025، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تنتهك وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حيث أفادت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية بأنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، وحتى 11 آذار/مارس، تم انتشال 845 جثة من مناطق كان الوصول إليها متعذرًا سابقًا. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 11 آذار/مارس 2025، أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 48,503 فلسطينيين، وإصابة 111,927 آخرين.[12]
- تدمير البنية التحتية: طالت الهجمات المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية، ما جعل من الصعب تقديم الخدمات الأساسية للسكان. أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الأضرار لحقت بالعديد من القطاعات، بما في ذلك الإسكان، والبنية التحتية، والتجارة، والصناعة، والسياحة. "وتقدر الأضرار في البنية التحتية المادية والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزاع في قطاع غزة، بنحو 29.9 مليار دولار و19.1 مليار دولار على التوالي، ليصل إجمالي الآثار المقدرة للنزاع إلى 49 مليار دولار. وفيما يتعلق بالأضرار المادية، كان قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا بقيمة 15.8 مليار دولار (53% من إجمالي الأضرار)، يليه قطاع التجارة والصناعة بقيمة 5.9 مليار دولار، والنقل بقيمة 2.5 مليار دولار، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بقيمة 1.53 مليار دولار. وتعادل الأضرار وحدها 1.8 ضعف إجمالي الناتج المحلي السنوي للضفة الغربية وقطاع غزة".[13] كما أكد التقرير على الحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي، مع التركيز على تعزيز الصمود وتحسين الخدمات الأساسية.
- حرب التجويع: تم فرض قيود صارمة على دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما فاقم من أزمة الأمن الغذائي في المناطق المتضررة، وأدى ذلك إلى:
- طبقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان المصنفين في المرحلة الخامسة من التصنيف (الكارثة) ثلاث مرات تقريبًا خلال الأشهر المقبلة. بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025، يُصنف ما يقرب من مليوني شخص؛ أي أكثر من 90% من السكان، في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة) أو أعلى، منهم 345,000 شخص (16%) في مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، و876,000 شخص (41%) في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). وعلى الرغم من قلة عدد سكانها، فمن المرجح أن تواجه رفح والمحافظات الشمالية انعدام أمن غذائي حادًا أكثر حدة.[14]
- انتشار سوء التغذية بين الأطفال والنساء وكبار السن، ما تسبب في ارتفاع معدلات الأمراض الناجمة عن نقص الغذاء.
- انهيار الأنظمة الصحية بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والمكملات الغذائية الأساسية.
- ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الجوع، وبخاصة في المناطق التي تواجه حصارًا مشددًا.
- تدهور الاقتصاد المحلي بسبب فقدان الأمن الغذائي وتعطيل سلاسل التوريد التجارية.
- تفكك البنية المجتمعية نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن نقص الغذاء والمساعدات.
- التهجير القسري: تعرضت آلاف العائلات للتهجير الداخلي، في حين تصاعدت المخاوف من محاولات التهجير خارج الوطن. فقد تصاعدت سياسة التهجير القسري؛ سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لدرجة أصبحت تشكل تحديًا إنسانيًا وقانونيًا خطيرًا. فقفي الضفة الغربية، وبخاصة في شمالها، تصاعدت عمليات التهجير القسري مؤخرًا، حيث أثرت على نحو 40,000 شخص،[15] أما في قطاع غزة، فقد أُجبر سكان المناطق الشمالية على النزوح إلى الجنوب نتيجة العمليات العسكرية المكثفة، ما أسفر عن نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع، بعضهم اضطر للنزوح مرات عديدة في ظل انعدام الأمن والخدمات الأساسية مع صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية بالذات إلى فئات النساء والأطفال الذين هم أكثر عرضة للمخاطر الصحية والنفسية. وطبقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يُعتبر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة انتهاكًا جسيمًا، وقد يرقى إلى جريمة حرب. كما أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن التدمير الواسع للممتلكات، والتهجير القسري للمدنيين، قد يشكلان جريمة حرب.[16] وتتطلب هذه الممارسات تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
- تشديد الحصار: أدى الحصار المتزايد إلى إغلاق تام لقطاع غزة، وقطع أوصال الضفة الغربية، ما عرقل الحركة والتنقل والتجارة.
- منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2007، شهدت حياة المواطنين هناك تدهورًا مستمرًا في مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية. قبل الحصار، كانت نسبة البطالة في العام 2005 حوالي 23.6%، لكنها ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى 50.2% بحلول العام 2021، ما يجعلها من أعلى معدلات البطالة عالميًا. إضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات الفقر من 40% في العام 2005 إلى 69% في العام 2021، ما يعكس التدهور الاقتصادي المستمر في القطاع.[17] إلى جانب ذلك، أدى الحصار إلى تدهور الخدمات الأساسية والبنية التحتية، حيث تعرض قطاع غزة لأربع هجمات عسكرية مدمرة خلال فترة الحصار، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير واسع للمنازل والمنشآت المدنية، ما زاد من معاناة السكان.
- في الضفة الغربية، يواجه المواطنون تحديات كبيرة بسبب انتشار الحواجز العسكرية الإسرائيلية. وبحسب تقارير صادرة في كانون الثاني/يناير 2025، بلغ عدد هذه الحواجز والبوابات الحديدية 898 حاجزًا، ما يعوق حركة الفلسطينيين ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.[18] وهذه الحواجز لا تعرقل حركة الأفراد فحسب، بل تؤثر، أيضًا، على الاقتصاد المحلي، حيث تعيق نقل البضائع وتحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان في الضفة الغربية.
- الانقسام السياسي: ساهم الانقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية في إضعاف الاستجابة للأزمة من خلال:
- ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية.
- غياب إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الأزمة، ما أدّى إلى استجابات متفرقة وغير متكاملة.
- استمرار الخلافات السياسية التي أثرت على وصول المساعدات وتوزيعها بفعالية.
- التأثير السلبي على العلاقات مع المانحين، ما أدّى إلى تراجع الدعم الدولي بسبب عدم وضوح الرؤية الوطنية.
- تراجع الخدمات الحكومية: عجزت المؤسسات الحكومية عن تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب التدمير ونقص الموارد.
- البطالة والفقر: ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، ما أثر على الأمن الاقتصادي للسكان.
- تفكك شبكات الحماية الاجتماعية: تعرضت الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر متزايدة بسبب غياب أنظمة الحماية الاجتماعية.
- العنف الداخلي والفوضى: تزايدت التوترات الأمنية والاجتماعية، ما ينذر بمخاطر فوضى داخلية.
ثانيًا. الصمود في السياق الفلسطيني
يعد مفهوم الصمود إحدى الركائز الأساسية في مواجهة الأزمات الممتدة التي يمر بها الفلسطينيون. فمفهوم الصمود في السياق الفلسطيني فريد ومتميز من حيث تنوعه وارتباطه بوجود الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يستوجب البناء عليه واستثماره في بناء الصمود وبرمجته بما يتوافق مع المفهوم الوطني. كما أن بناء الصمود هو ثقافة مجتمعية متجذرة في عمل المنظمات الأهلية، إلا أنها محدودة بمحدودية الموارد وبمدى قدرة المنظمات على التخطيط والتنفيذ ضمن إطار واضح يؤدي إلى تعزيز الصمود. كما أنه، وعلى الرغم من أن المنظمات الأهلية ترفع شعار بناء الصمود وتتبناه، فإنها تواجه تحديات في امتلاك الأدوات المنهجية لتطبيقه. ومن أجل تعزيز إستراتيجيات الصمود يتطلب الأمر:
- تحليل المخاطر والتكيف مع الواقع المتغير: من خلال إدماج منظور الصمود في جميع إستراتيجيات التدخل؛ إذ خلصت دراسة نشرتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية العام 2023 إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن عنف الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة للفئات الهشة، والتهجير القسري، وتقييد الحريات، إلى جانب محدودية مساحة العمل الأهلي، من أبرز مخاطر الحماية في الأراضي الفلسطينية. كما تشكل صعوبة الوصول إلى مصادر الغذاء، وفقدان سبل العيش، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، أبرز مخاطر الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية. كما مثّل ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمنازل والمجتمعات، وعدم توفر المساحات الكافية للبناء والتوسع، أبرز المخاطر المحيطة بقطاع المأوي في الأراضي الفلسطينية.[19] كل هذه المخاطر بحاجة إلى تحليل دقيق من أجل وضع إستراتيجيات تدخل مناسبة لها.
- تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة: عبر تطوير أطر تعاون بين المنظمات الأهلية، والسلطة الفلسطينية، والهياكل الحاكمة في قطاع غزة.
- فهم سياسات المانحين وتأثيرها على نماذج التدخل والاستجابة.
ثالثًا. التوصيات المتعلقة بأدوار الأطراف ذات العلاقة
- سياسات السلطة الفلسطينية وتدخلاتها:
- التوصل إلى توافق سياسي بشأن هياكل الحكم لتعزيز الفاعلية الإدارية.
- وضع إستراتيجيات للإغاثة والتعافي والإعمار وتطوير البنية التحتية.
- تطوير برامج دعم الصمود بما تشمل خلق فرص اقتصادية وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
- ضمان الشراكة بين الأطراف المختلفة، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- وكالات الأمم المتحدة:
- توسيع نطاق عمليات الإغاثة مع ضمان عدم تسييس المساعدات.
- دعم برامج إعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة.
- يوصى المانحون ووكالات الأمم المتحدة بتعزيز الشبكات والاتحادات المحلية لتشجيع آليات التنسيق المثمرة وتبادل المعلومات بشكل سليم.
- سياسات المانحين الدوليين:
- إعادة توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تدعم التنمية طويلة الأمد.
- يجب تخفيف القيود المفروضة على التمويل، مع توفير المزيد من المرونة لضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني المحلية، وبخاصة تلك التي تأثرت بالحرب.
- يجب إعطاء الأولوية لمنظمات المجتمع المدني المحلية للاستفادة من منح التعافي وإعادة التأهيل، وينبغي زيادة تخصيص التمويل المتعلق بالبناء وبناء القدرات، وبما يتيح لها المرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات الناشئة.
- يتم تشجيع الجهات المانحة على بدء علاقات طويلة الأمد مع منظمات المجتمع المدني المحلية للاستثمار في قدراتها، وتشكيل شبكة أمان لضمان استمرارها واستدامتها.
- ينبغي لخطط تمويل التعافي المبكر والمساعدات الإنسانية أن تأخذ في الاعتبار حجم التأثير ليس على الأشخاص المحتاجين فحسب، ولكن، أيضًا، على منظمات المجتمع المدني نفسها، الأمر الذي يتطلب برامج ومنح إنعاش طويلة الأمد.
- المنظمات الأهلية الفلسطينية:
- تبني النهج القائم على مشاركة الفئات المستهدفة في تحديد الأولويات، وفي تنفيذ الأنشطة وتقييمها.
- تعزيز الشراكة بين المنظمات المحلية والدولية لضمان فعالية أكبر في الاستجابة.
- تحسين آليات الحوكمة والشفافية لضمان استدامة التمويل والدعم الدولي.
- تعزيز التمويل المحلي التضامني المستدام بهدف الاستغناء عن المساعدات الخارجية والاعتماد على الذات.
- العمل على تعزيز التوطين وصمود منظمات المجتمع المدني، من خلال التشاور مع الفاعلين الدوليين والمحليين كافة.
رابعًا. استنهاض دور المنظمات الأهلية (بالتركيز على قطاع غزة)
تمر المنظمات الأهلية في قطاع غزة بمرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة لدورها وإستراتيجياتها. ومن أبرز التوصيات:
- إعادة تأهيل الهياكل الإدارية والتنظيمية: من خلال تحسين آليات الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث اللوائح الداخلية لضمان مرونة الأداء وفعاليته في حالات الطوارئ.
- يجب أن تكون لدى المنظمات الإنسانية خطط طوارئ قابلة للتنفيذ لمجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك: تصعيد الحرب، النزوح الجماعي إلى مواقع مختلفة، تفشي المجاعة والأمراض المعدية على نطاق واسع.
- تنويع مصادر التمويل: عبر تعزيز التمويل المحلي، وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لا تتأثر بالاعتبارات السياسية، إضافة إلى تطوير إستراتيجيات استدامة مالية تعتمد على مشاريع مدرة للدخل.
- رفع كفاءة العاملين: من خلال برامج تدريب متخصصة في إدارة الأزمات، والتخطيط الإستراتيجي، والمناصرة، لضمان قدرة الكوادر على التعامل مع الأوضاع المتغيرة بفعالية. كما ينبغي تنفيذ مبادرات بناء القدرات لتعزيز مهارات موظفي منظمات المجتمع المدني وخبراتهم في مجال جمع البيانات وتحليلها وإدارتها. سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المعلومات الناتجة ودقتها، وتعزيز فعالية التدخلات الإنسانية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: عبر إطلاق مبادرات مشتركة لدعم المشاريع التنموية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- الضغط لتضمين المجتمع المدني في عمليات صنع القرار: من خلال تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية والدولية، والمشاركة في رسم السياسات الوطنية، بما يضمن تمثيل مصالح الفئات الأكثر تضررًا.
- ضرورة تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط، وتدشين حملات على المستوى الدولي بمشاركة الشباب، وفتح علاقات مع قطاعات جديده في العالم، وبخاصة في أوروبا.
- تعد استعادة منظمات المجتمع المدني المحلية وتعزيزها أولوية لتعزيز جهود إنقاذ الأرواح والتعافي. وينبغي للمنظمات الدولية والحكومات والجهات المانحة إعطاء الأولوية للاستثمارات في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لخلق بيئة أكثر ملاءمة للتدخلات والعمليات الإنسانية. ويشمل ذلك توفير التمويل والمساعدة الفنية لإعادة بناء مقرات المنظمات الأهلية واستعادة دورها الحيوي.
- يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية منظمات المجتمع المدني من الهجمات الإسرائيلية. ويشمل ذلك إدانة هذه الهجمات ومطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي، والدعوة إلى رفع الحصار والتدفق الحر للسلع والمواد الأساسية إلى قطاع غزة.
- ينبغي بذل الجهود لاستعادة الاتصال بالإنترنت وتحسين البنية التحتية للاتصالات في المنطقة المتضررة. هذا من شأنه أن يسهل تبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة الإنسانية، ويتيح التنسيق في الوقت الحقيقي لجهود الإغاثة.
- ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة عمال الإغاثة وموظفي منظمات المجتمع المدني.
- ينبغي تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني لإعادة بناء قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعلومات الخاصة بها. وقد يشمل ذلك تقديم المساعدة الفنية والمعدات والتمويل لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مرنة ومستدامة.
- إن التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى أنظمة البيانات والمعلومات الخاصة بها وإدارتها أثناء الحرب، تسلط الضوء على الحاجة إلى الاستعداد القوي للكوارث وخطط التعافي. يجب على منظمات المجتمع المدني إعطاء الأولوية للنسخ الاحتياطي المنتظم، وحلول تخزين البيانات الآمنة، وخطط الطوارئ لضمان الوصول دون انقطاع إلى المعلومات المهمة في حالات الطوارئ. إضافة إلى ذلك، تعد الاستثمارات في البنية التحتية المرنة؛ مثل الاتصال الموثوق بالإنترنت، والأجهزة المناسبة، ضروريةً لتمكين منظمات المجتمع المدني من مواصلة عملها الحيوي في مواجهة الشدائد.
- إن غياب خطط واضحة بين عدد كبير من منظمات المجتمع المدني خلال الحرب، وفي فترة ما بعد الحرب، يطرح العديد من التحديات، وقد يعيق قدرتهم على الاستجابة بفعالية للاحتياجات الفورية للمجتمعات المتضررة والمساهمة في جهود الإنعاش وبناء السلام على المدى الطويل. إن تطوير خطط قوية تتوافق مع الظروف والأولويات المحددة لسياق ما بعد الحرب، أمر بالغ الأهمية لمنظمات المجتمع المدني لتعظيم تأثيرها، والمساهمة في عملية التعافي المستدامة والشاملة.
- هناك حاجة إلى قيام منظمات المجتمع المدني بإعطاء الأولوية لقنوات الاتصال الفعالة، وضمان المشاركة المنتظمة مع أعضاء مجلس إدارتها. تعد معالجة التحديات مثل ضعف الوصول إلى الإنترنت، وغياب أعضاء مجلس الإدارة، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الحكم الرشيد، وضمان الأداء الفعال لمنظمات المجتمع المدني. ومن خلال تنفيذ تدابير لتحسين الاتصال وتسهيل اجتماعات مجلس الإدارة المنتظمة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني تعزيز عمليات صنع القرار لديها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق أهدافها وغاياتها التنظيمية في نهاية المطاف.
- يجب على منظمات المجتمع المدني وضع خطط طوارئ ميدانية بناءً على سيناريوهات الحرب المحتملة، وتنفيذ هذه الخطط فورًا وبفعالية عند الحاجة.
- يمكن لمنظمات المجتمع المدني تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والمؤسسات الحكومية لضمان التوزيع الفعال للخدمات والبرامج الأساسية.
- يجب على المنظمات الاستجابة بسرعة لاحتياجات السكان المتضررين من الحرب، من خلال تقديم الدعم الطبي والإغاثي والنفسي بشكل فوري.
- يجب على المنظمات تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي لتوعيتهم بالخدمات المتوفرة، وكيفية الوصول إليها.
- على الرغم من صعوبة التفكير في المستقبل البعيد بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فإنه يجب على المنظمات البدء بالتخطيط للمستقبل، ووضع إستراتيجيات مستدامة لتقديم الخدمات على المدى الطويل.
أبرز الأمثلة على مبادرات المنظمات الأهلية أثناء الحرب على قطاع غزة:
خدمات إيواء النازحين: قامت بعض المؤسسات بتحويل مقارها إلى مراكز لإيواء النازحين واستضافتهم وتوفير كافة إمكانياتها المتاحة لخدمتهم، كما قامت بعض المؤسسات بتقديم المعونة النقدية للنساء النازحات في مناطق قطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومزودي الخدمات المصرفية والصرافة، كما عملت العديد من المنظمات الأهلية على توزيع الطرود الغذائية ذات القيمة الغذائية من الخضروات الطازجة والمعلبات والمواد غير الغذائية ودعم شراء الملابس الشتوية للأشخاص النازحين في قطاع غزة، وكذلك توفير مواد الإيواء من فرشات وأغطية في ظل تعدد الاحتياجات المختلفة للفئات النازحة من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وشح هذه المواد في الأسواق، هذا إضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين لتعزيز قدراتهم على الصمود ومواجهة الظروف الاقتصادية المتردية بسبب الحرب والحصار المستمرين على قطاع غزة.
المطابخ المجتمعية (التكيات): قامت العديد من المنظمات الأهلية بإنشاء التكيات لتوزيع الوجبات الساخنة، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي أتى في ظل اشتداد أزمة التجويع واشتداد الهجمة من قبل الاحتلال على الأهالي في مناطق القطاع كافة.
الخدمات الصحية والعلاجية: في مجال الخدمات الصحية والإسعاف، ظهر جليًا دور المنظمات الأهلية وموظفيها في تعزيز صمود المواطنين والعمل في ظل ظروف لا يمكن تخيلها تحت تهديد سلطات الاحتلال للطواقم الطبية لهذه المؤسسات بإخلاء مقراتهم، إلا أنهم استمروا في البقاء مع المرضى وتقديم الخدمة الصحية المتوفرة لديهم، حيث ظهرت العديد من الأمثلة التي لم تغادر فيها الطواقم الطبية مقرات الخدمة لأسابيع عدة.
خدمات الحماية: عملت معظم المؤسسات على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات كافة، وبخاصة النساء والفتيات، وذوات الإعاقة، وتوزيع حقائب الكرامة عليهن، وكذلك تنظيم لجان للحماية المجتمعية تستهدف مجتمعات النزوح والإيواء، حيث تهدف هذه اللجان إلى فهم أشمل وأعمق لاحتياجات النازحين في مختلف القطاعات، ومشاركة هذه الاحتياجات مع أصحاب العلاقة، وصولًا إلى استجابة إنسانية مرنة وكريمة في ظل استمرار الأزمة حتى بعد إعلان مراحل وقف إطلاق النار.
لم يقتصر تقديم الخدمات على الجانبين الإغاثي والغذائي فحسب، فقد اتسع ليتشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال، وتقديم المساعدات الممكنة كافة لذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، حيث وفرت المنظمات العاملة في قطاع التأهيل الكراسي الخاصة بذوي الإعاقة الحركية والسماعات والبطاريات لذوي الإعاقة السمعية، وغيرها من المساعدات التي تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة على التعامل مع الأوضاع أثناء الأزمة.
كما عقدت المنظمات الأهلية العديد من البرامج والدورات التدريبية حول "الإسعاف الأولي النفسي" لمقدمي الخدمة والأخصائيين النفسيين في مراكز الإيواء، وتوزيع المعلومات الخاصة بالتواصل والإبلاغ عن مشاكل الحماية في مراكز النزوح.
خدمات التعليم: في المجال التعليمي قامت بعض المؤسسات بمبادرات تعليمية في الخيام والمدارس التي تحولت لمراكز إيواء، حيث تم تنفيذ أنشطة تعلمية وترفيهية من خلال المساحات التعلمية المؤقتة التي قامت بإنشائها في أماكن النزوح.
الحقوق والمناصرة: قامت العديد من المنظمات الأهلية بإصدار البيانات والتقارير الخاصة وأوراق الحقائق التي اشتملت على توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، من صحافيين ومرضى وأطباء وعاملين في مجال الإسعاف والدفاع المدني والمعتقلين، حيث طالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان منح آليات التحقيق الدولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تفعيل دور الرقابة الدولية في ظل ازدياد خطر حدوث المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ما يعزز حلقة الانتهاكات والإفلات من العقاب.
التنسيق والتكامل: تواصل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التنسيق مع الفاعلين المحليين والدوليين كافة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين والعائدين إلى بيوتهم المدمرة. وخلال الفترة القادمة، ستقوم الشبكة بإنشاء العديد من مراكز الخدمات الشاملة للمواطن الفلسطيني، التي تكفل الوصول إلى الخدمات بسهولة، والحصول عليها بكرامة ومساواة، وكذلك توفير أماكن عمل للمنظمات الأهلية التي فقدت مقراتها ومقدراتها من أجل تمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية والمجتمعية.
وأخيرًا، لا بد من تحقيق الشراكة على المستوى الوطني في مواجهة الاحتلال ومخططات التهجير والضم والتوسع والاستيطان، ومدخل ذلك يكمن في إنهاء الانقسام السياسي الذي أضعف وأنهك شعبنا، وقوّض مقومات صموده.
إن إعمار قطاع غزة لا يمكن أن يتحقق بدون مشاركة الفئات المستهدفة من شباب ونساء ومؤسسات قطاع غزة، ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون الإعمار برؤى وبأيدٍ فلسطينية، وبوجودنا على أرض قطاع غزة.
سياسات التوافق في مواجهة سياسات الإقصاء
د. حسن أيوب
الخلفية
على مدى العام ونصف العام من حرب الإبادة "الإسرائيلية" الجماعية في قطاع غزة، وحرب الإبادة السياسية والاستعمارية في الضفة الغربية، ظل الواقع السياسي والوطني الفلسطيني رهينة السياسات التي سادت العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ سياسات الانقسام والمزاودة. وكأن عملية طوفان الأقصى بكل مفاعيلها وتداعياتها لم تحدث. ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت على مستوى اللقاءات الفلسطينية-الفلسطينية في دفع الحالة الفلسطينية نحو صيغة مقبولة وقابلة للتحقق لتجاوز الانقسامات الفلسطينية، التي باتت مستعصية بحكم أنها اكتسبت حياة من ذاتها، ولم تعد تلك الأسباب التي قادت إلى الانقسام هي ذاتها، بالضرورة، التي تحدد استمراره أو إمكانية تجاوزه. فلا التوازنات الداخلية الفلسطينية تسمح ببروز قوة -أو تحالف قوى- قادر على فرض خيارات وحدوية على طرفي الانقسام، في حين أن القوى الإقليمية والدولية في غالبيتها -وبخاصة إسرائيل وحلفاءها- تمارس ضغوطها للحيلولة دون توحيد الموقف الفلسطيني سياسيًا ومؤسسيًا.
لقد كشفت الأشهر القليلة الماضية، وبخاصة منذ طرح فكرة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة، ومخرجات اجتماع "بكين"، عن حالة استعصاء بنيوي وسياسي رست عليه مصالح الأطراف المعنية بعدم التقدم نحو صيغة وطنية توافقية، وبخاصة الرفض المتكرر لهذه الصيغ من قبل القيادة السياسية الفلسطينية المتفردة بالقرار، لأن ذلك يعني القبول بدور لحركة حماس. كما ترفض هذه القيادة، أيضًا، تشكيل حكومة توافق وطني نصت عليها مخرجات اجتماع بكين، للسبب ذاته. وكانت كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية خير تعبير عن هذا الانسداد.
وقد تقدم الرئيس محمود عباس بخطته الخاصة لقطاع غزة أمام القمة العربية الأخيرة، ما يشير إلى أنه يقبل جزئيًا بالخطة المصرية، وبخاصه قبوله بالمكون المتعلق بإعادة بالإعمار الواردة في تلك الخطة. لكنه لم يعلن قبوله بمقترح لجنة التكنوقراط. في الوقت ذاته، فإنه لم يدع مجالًا للشك بأنه لن يقبل بدخول حركة حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، معيدًا تكرار شروطه المسبقة لتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت لواء (م.ت.ف)، وأهمها الاعتراف بالالتزامات (أي الاتفاقيات) التي تلتزم بها المنظمة، والقبول بمقولة: سلطة واحدة، وتمثيل واحد، وسلاح واحد.
بات من الواضح أن الوضع السياسي الفلسطيني أصبح أسيرًا لمعضلة يبدو ألا فكاك منها: فلا المؤسسات المعنية بصنع القرار السياسي، وبخاصة (م.ت.ف) قادرة أو حاضرة للبت في هذا الشأن، وقرارها مرتهن لإرادة ومناورات قيادتها في مواجهة استحقاقات عديدة أقرتها مؤسسات المنظمة؛ ولا توجد ظروف موضوعية ولا ذاتية يمكن لها أن تفرض خيار الانتخابات العامة لمؤسسات كل من السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية على السواء، من شأنها أن تجدد شرعيات مؤسسات صنع القرار، وتعكس الإرادة الشعبية.
في ظل هذه المعطيات المعقدة، وحالة الاستعصاء السياسي والوطني، التي تشل الإرادة الكفاحية وقدرات المقاومة بكل أشكالها لحرب الإبادة والإفناء المادي والسياسي، يحول الانقسام دون تقديم الفلسطينيين لأنفسهم على أي طاولة تفاوض يتعلق بقطاع غزة أو بغيره من القضايا التي تخص القضية الفلسطينية، والعدوان "الإسرائيلي" الخطير والمدمر الذي تتعرض له. والخروج من هذا المأزق الخطير بات يتطلب استنفار كل الإمكانيات الفلسطينية على أسس جديدة، تضمن إنهاء أي تفرد بالقرارات التي تمس مصير القضية الوطنية الفلسطينية.
نقدم في هذه الورقة الموجزة تصورًا محددًا لتفعيل آليات وترتيبات الديمقراطية التوافقية كبديل ضروري، وإن كان مرحليًا، لكل من التفرد بصنع القرار السياسي عبر التذرع بوحدانية تمثيل (م.ت.ف) للشعب الفلسطيني على ما فيها من عوار وانتهاك لصلاحياتها ودورها، ولغياب الانتخابات كرهًا أو طوعًا، هذا من جهة، وللتفرد بعملية التفاوض ذات العلاقة بقطاع غزة ومستقبله، من جهة ثانية.
في معنى اللجوء إلى التوافق ومبرراته
لا خلاف على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الأكثر معقولية في الكشف عن ميول الجمهور ومصالحه وتطلعاته. لكن لكل انتخابات سياقاتها السياسية والوطنية، وخلفياتها التي تؤسس لمعنى هذه الانتخابات ومضمونها، وما هو المأمول أن تحققه. وفي الحالات التي تعيش فيها بعض المجتمعات حالات انقسام عميق، لجأت هذه المجتمعات إلى تطبيق خيارات سياسية ومؤسسية أعادت تعريف الديمقراطية بما يخدم هدف الحفاظ على كياناتها الاجتماعية والسياسية في وجه مخاطر التشظي أو الغرق في حروب أهلية، فلجأت إلى ما يعرف بالديمقراطية التوافقية. فالديمقراطية، في نهاية المطاف، وبخاصة من الناحية الإجرائية، تحتمل عددًا من الصيغ، ولا تنحصر بالضرورة في النظم الأغلبية.
إن الوضع الفلسطيني الراهن بتقديرنا أحوج ما يكون إلى هذا النمط من الديمقراطية، حتى لو لم تكن خطوط الانقسام الفلسطيني ذات طابع إثني، أو طائفي، أو ديني مثل حال المجتمعات التي تطبق الديمقراطية التوافقية. فالانقسام الفلسطيني، مثلما نشير في هذه الورقة، وصل إلى مستويات حادة حوّلت الاستقطاب إلى ما يشبه الطائفية السياسية التي تعذرت أمامها الحلول، وفي مقدمتها الحل الديمقراطي المتمثل بالانتخابات. بل إن موجبات اللجوء إلى التوافق هي أكبر بما لا يقاس من موجبات الانتخابات.
لا تقدم الديمقراطية الأغلبية والإجرائية حلولًا فعالة في حالات الانقسام والاستقطاب الحاد والعميق في المجتمعات السياسية. فالانقسام حول القيم الوطنية، وتعريف طبيعة المرحلة، وأدوات الكفاح الوطني، وتصنيف الأعداء والحلفاء، يخلق سدًا منيعًا أمام الوسائل الديمقراطية. فهذه قضايا أسبق من الديمقراطية، ولكي يصبح لأي صيغة ديمقراطية معناها وفعاليتها في توحيد أي مجتمع سياسي، ينبغي، أولًا، الاتفاق على أسس العلاقات وقواعدها داخل هذا المجتمع السياسي.
التوافق كبديل مرحلي للانتخابات والمعروف في اللغة الأكاديمية بتعبير (Consociational Democracy) شأنه شأن الصيغ المختلفة المرافقة له من قبيل تقاسم القوة أو تشاركها (Power Sharing) ليست بدعًا في الحالة الفلسطينية، ولا في أي سياق تتعذر فيه سبل الديمقراطية الأغلبية، أو يُخشى من أن تتحول الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج حالة الاستقطاب والتضاد السياسي التناحري. إنه بمثابة إعادة تكييف للديمقراطية، بحيث لا تنقلب نتائج الانتخابات إلى تكريس للانقسام، أو تستغل للانقلاب على الديمقراطية ذاتها، بحيث تكون مقدمة للاستحواذ على الدولة (في هذه الحالة السلطة الفلسطينية)، وبخاصة في ظل فراغ الشرعية الذي يوجب اللجوء إلى الشرعية التوافقية التي تحتكم بها عادةً حركات التحرر الوطني بصفتها جبهات وطنية عريضة. بهذا المعنى، فإن التوافق يعتبر البديل الأكثر قابلية للتطبيق والأقل تهديدًا لاستقرار أي نظام سياسي لعيش حالة الاستقطاب الحاد. وهو ليس خيارًا مثاليًا، إذ أنه ينطوي على خطر إدامة الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية ومأسستها في المجتمعات التي تعيش صراعات من هذه الأنواع، وهو ما لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، باعتبار أن خطوط الانقسام الفلسطيني هي سياسية وتنظيمية بامتياز، ولا تنطوي على أبعاد مذهبية أو إثنية، وإن كانت في أحد جوانبها تحمل أبعادًا فكرية سياسية وأيديولوجية.
التوافق وإلحاح سؤال التمثيل
لم تعد المسألة الفلسطينية اليوم قضية حقوق في مهب رياح التغيرات الإقليمية والدولية الكبرى؛ من التحولات في التوازنات الإقليمية، إلى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية بأجندته العدوانية تجاه الحقوق الفلسطينية بشكل خاص. فإلى جانب ذلك، بات سؤال التمثيل الفلسطيني هو المطروح على الطاولة، على ضوء مشروع ترامب لتطهير قطاع غزة من سكانه، وعمليات التهجير القسري الداخلي في الضفة الغربية ومخاطر التهجير ومشروع الضم المتواصل فيها. يترافق ذلك مع سياسات "إسرائيلية" تهدف إلى نزع الصفة السياسية عن أي كيانية فلسطينية؛ سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؛ ناهيك عن تمثيل سياسي يحافظ على الترابط العضوي بينهما.
تبرز في هذا السياق، بشكل خاص، الخطط والمشاريع الأميركية التي طرحتها الإدارتان السابقة للرئيس بايدن، والحالية للرئيس ترامب. فقد أصرّت إدارة بايدن على موضوع "إصلاح السلطة الفلسطينية"، مستخدمة تعبير "سلطة متجددة" كشرط مسبق للسماح بعودتها إلى قطاع غزة، ما يذكرنا بالتجربة المريرة لاستحداث منصب رئيس الوزراء في العام 2002. بينما لا تبدي الإدارة الحالية أي اهتمام بأي دور للسلطة الفلسطينية، وتتجاهلها تمامًا، فإنها تترك شرط "الإصلاح" المزعوم للشركاء الإقليميين (العرب تحديدًا) ليفرضوه على السلطة الفلسطينية. وإلى جانب المخاطر الكبرى المترتبة على خطة ترامب لتطهير قطاع غزة عرقيًا، فإن ما تقوله هذه الخطة هو أن الفلسطينيين في غزة والضفة على السواء، لا يملكون الإرادة الحرة أو الإمكانية لتقرير مصيرهم، أو امتلاك تمثيلهم السياسي كشعب. وناهيك عن أن ترامب لم يفكر حتى باستشارة أو إشراك أي جهة فلسطينية أو عربية في طرح خطته، فقد فرض على العرب تقديم خطة بديلة سرعان ما رفضها.
إن استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة يعني، من ضمن ما يعنيه، تعميق انفصاله سياسيًا ومؤسسيًا ووطنيًا عن الضفة الغربية، وفي المقابل تسعى "إسرائيل" بكل قوتها إلى تحويل الضفة الغربية إلى فقاعات حكم ذاتي مناطقي منزوعة من أية حقوق، وخلق ما تصفه بعض الأوساط الأكاديمية بتعبير (Nested Sovereignties) في ظل حالة التحلل التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وحالة الموت السريري التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية.
ومما يفاقم من خطر سقوط أو إسقاط الصفة التمثيلية عن كل الكيانات السياسية الفلسطينية هو حالة التدهور النوعي في علاقات السلطة الفلسطينية وفتح من جهة، وحركة حماس من جهة ثانية، في ظل العلاقات المتشنجة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الرئيسية فيها بسبب مواقفها السياسية المعارضة. فعلى خلفية رفض الرئيس محمود عباس تنفيذ مخرجات مؤتمر بكين رغم موقف حركة حماس بقبول تشكيل حكومة توافق وطني، قدّم عباس في القمة العربية ما يمكن وصفه بأنه إصلاحات فوقية وفردية يراد منها لملمة حركة فتح والاكتفاء بها، وفي الوقت ذاته عزل حركة حماس واستبعادها من خلال وضع الشروط التعجيزية ذاتها أمام انضمامها لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو مشاركتها في إدارة قطاع غزة.
وقد تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بيانات الإدانة المتبادلة بين الطرفين، منطلقة من مبدأ الطعن في وطنية كل طرف واتهامه بالتفريط بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وصلت حدة الاستقطاب هذه إلى مستويات من العمق، بحيث باتت تهدد بالملموس، ولأول مرة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 التمثيل السياسي والوطني الفلسطيني الجمعي والمشروع. وعلينا أن نعترف بأن إنهاء هذا الانقسام الحاد لم يعد ممكنًا عبر الوسائل، ومن خلال الأطر والمؤسسات القائمة، وحيث فشلت كل المحاولات السابقة، وبأنه لا بديل عن التقدم بمبادرات تقوم على التوافق، الذي احتكمت له كل حركات التحرر الوطني، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية. وهو لا يعني، بأي حال، العودة إلى نظام المحاصصة الفصائلية، بل يقوم على منطق الشراكة والمشاركة واسعة النطاق لكل الفواعل الوطنية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية، وبما يتخطى حالة غياب شرعية التمثيل السياسي أو تآكلها في ظل الظروف الراهنة وتحدياتها.
التوافق ومسألتا الشرعية والإصلاح
لقد تحول الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ زمن إلى انقسام عميق، جعل العلاقات الوطنية والسياسية الفلسطينية لعبة صفرية، لا تقبل القسمة على أطراف الصدع الذي تعمق اجتماعيًا وفكريًا، وفي الممارسة العملية. وبالموازاة، انعدمت أو اختفت تمامًا وسائل الحوار بين القيادة الفلسطينية ومختلف المكونات الوطنية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وحل محلها لغة المزاودة والتخوين والتجييش. وفي أجواء المزايدة، تتم تغذية الانقسام وإسكات أصوات المعارضة. وبدلًا من بناء أسس التوافق، يتم تعزيز الشكوك بالآخر السياسي والفكري، وتحويل الحلفاء الطبيعيين إلى أعداء للمشروع الوطني، الذي لم يعد له وجود في مواجهة ما تتعرض له المناطق الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية. وهو ما أشارت له رسالة د. ممدوح العكر قبل نحو شهر، والموجهة إلى القيادة الفلسطينية، التي قدم فيها صياغة رصينة للخيارين المطروحين أمام الشعب الفلسطيني وقيادته: إما التمسك بما تحقق على امتداد ما يقارب العامين من التحولات والتماسك الداخلي من أجل تحقيق ذلك، أو مواجهة كارثة شاملة. ويضيف د. العكر أن ثمة شرطين لذلك: الوحدة الوطنية، وتحديد من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء والحلفاء. حتى الآن لم يتحقق أيٌّ من الشرطين بحكم أن حالة الاستقطاب تمتد لتطال إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية على خلفية الهوة العميقة في المقاربتين السائدتين، وتمتد كذلك إلى التضاد الصريح في التحالفات والعلاقات الإقليمية والدولية في كل من المقاربتين.
على هذه الخلفية، شهدت العلاقات الفلسطينية الداخلية تدهورًا نوعيًا شديد الخطورة في الآونة الأخيرة: أفقيًا بين التيارين السائدين؛ إذ يوشك كل منهما على اتهام الآخر بالخيانة الوطنية، وعاموديًا؛ إذ وضعت السلطة الفلسطينية نفسها وأدواتها وفصيلها المهيمن في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، بدءًا من عملية "حماية وطن" مرورًا بحملة التجييش في مواجهة المعارضة السياسية، وليس انتهاء بمهاجمة محاولات تعبئة المجتمع الفلسطيني وشيطنته وتخوينه الهادفة إلى تشكيل حالة شعبية ووطنية تساهم في الخروج من المأزق.
في ظل هذه التعقيدات، فإن الدعوة لانتخابات عامة تشمل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقدم حلًا. فالداعون لهذه الانتخابات من خارج السلطة وحركة فتح، يرون فيها أملًا للخروج من حالة المراوحة ومن هيمنة الاستبداد السياسي الذي تمارسه القيادة الفلسطينية. وهو مطلب بقدر ما هو محق ومبرر، فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة على تعزيز الانقسام وتكريسه في ظل غياب اتفاق وطني على إستراتيجية وطنية وكفاحية، وبرنامج سياسي-وطني، وتوافقات وتقييمات جدية شاملة حول التجارب السابقة التي أوصلتنا إلى هذا الانسداد.
إن ما تنتجه الديمقراطية التوافقية هو نظام سياسي يمنح كل مكون من مكونات المجتمع السياسي مكانه على طاولة صنع القرار، ويمنح الشرعية لتمثيل أساسه الإرادة الوطنية والسياسية للخروج من مأزق الشرعية التي تعيشه كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وأولها منظمة التحرير الفلسطينية؛ والسلطة الفلسطينية بطبيعة الحال. فكيف للمنظمة أن تحافظ على شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده على قاعدة كونها شكلًا من أشكال الائتلاف الوطني التوافقي، في حين يوجد فصيلان وازنان أحدهما (حركة حماس) التي كانت قد حققت انتصارًا انتخابيًا صريحًا في آخر انتخابات عامة لم تتكرر، خارج المنظمة؟ وكيف لهذه المنظمة أن تستعيد الثقة بها في أوساط الجمهور الفلسطيني وقواه الوطنية والاجتماعية، وقد تحولت إلى أداة إقصاء وفزّاعة فارغة المضمون بيد رئاستها الفردية؟
وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، فلسنا بحاجة للبرهنة على غياب شرعية مؤسساتها بلا استثناء، بفعل تغييب وتفكيك ضمانات توازن السلطات وشطب الهيئة التشريعية والتحكم بجهاز القضاء. كما لا يخفى على أحد بأن السلطة الفلسطينية قد فقدت قرارها المستقل. فالتدخلات الخارجية تارة بالإكراه، وتارة بالاتفاق، جعلت السلطة تبدو خاضعة تمامًا للإملاءات الخارجية، وبخاصة تلك ذات العلاقة بقضايا وطنية حساسة للغاية؛ مثل رواتب الأسرى والشهداء، والتعامل الأمني مع المقاومة في شمال الضفة الغربية، وما يعرف بإصلاح السلطة. هذا كله جعل الفلسطينيين شكاكين بجدوى الانتخابات وهم يشاهدون حجم التدخل الخارجي، وتلك الشرعية المستمدة من لاعبين خارجيين. وهذا مرده، بالأصل، إلى اتفاقيات أوسلو، وما ترتب عليها من إعادة تشكيل ما يشبه الهرمية الاجتماعية في التكوين العضوي للمجتمع الفلسطيني، من حيث الأكثر فالأقل أهمية سياسية، في نظام فردي استبدادي بامتياز. وهذا الاستبداد مقبول تمامًا من قبل اللاعبين الخارجيين، بغض النظر عن مقدار ما ينطوي عليه من انتهاك لمعايير الديمقراطية، طالما أنه يستجيب للمطالب الخارجية بإصلاح فوقي، ويقبل باستمرار الوضع السياسي القائم. حتى عندما تدعو الأطراف الخارجية للانتخابات، فإن موقفها السابق من انتخابات العام 2006 يبقى محل استهجان واستنكار نظرًا لرفضها الصريح لنتائجها. إن الفلسطينيين في هذه المعادلة مجبورون أن يفكروا مليًا قبل الإدلاء بأصواتهم إذا ما كانت نتيجة الانتخابات ستعجب واشنطن، وتل أبيب، وبروكسل، وبعض العواصم العربية.
التوافق بديلًا عن الانتخابات وإعادة إنتاج الواقع
من الزاوية النظرية البحتة، فإن إجراء الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة هي من المتطلبات الإجرائية للديمقراطية، ولكنها، بأي حال، لا تقدم حلولًا للمسائل الأكثر عمقًا في بناء النظام الديمقراطي. وفي سياق التحرر الوطني، فإن الانتخابات هي عملية مفصولة عن الواقع بحكم أن التحرر الوطني يحتاج، بالضرورة، إلى توحيد قوى التحرر على اختلاف ألوانها.
فالانتخابات هي وسيلة استدخال وإقصاء (inclusion and exclusion) في الوقت ذاته؛ أي أنها تفرز رابحين وخاسرين في إطار نظام سياسي استقرت فيه قواعد اللعبة الديمقراطية. منطق الانتخابات هذا يتنافى تلقائيًا (by default) مع منطق الوحدة الوطنية والتوافق بمعناه السياسي والوطني، وبمعناه التنظيمي المؤسسي الذي نقترحه هنا. أي أن التوافق الوطني والسياسي، إذا ما استقر وتمأسس، يمكنه أن يشكل قاعدة صلبة للانتقال إلى الانتخابات، وليس العكس. فأي نتيجة للانتخابات ستعني بالضرورة إقصاء الخاسر/ين، في حين أن استكمال مهمات التحرر الوطني لا تحتمل أي إقصاء أو استبعاد، وما سينتج عنهما من عدم استقرار وصراعات يصعب منعها أو الحد من تداعياتها.
هذا التوافق الذي يسبق ويتقدم على الانتخابات في الحالة الفلسطينية، لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم به، بل إنه منوط بمنظمة التحرير الفلسطينية حصريًا، ومن الناحيتين السياسية والوطنية، من خلال إصلاح هيكلي مؤسسي في بنى المنظمة، وإعادة الاعتبار لمؤسساتها وأنظمتها الداخلية، وفتح أبوابها للمشاركة والشراكة، ليس على قاعدة المحاصصة، بل التوافق، وعبر إشراك كل المكونات الحية للشعب الفلسطيني. وذلك ما لا تستجيب له أي انتخابات لمؤسسات السلطة الفلسطينية، حتى لو توفرت لها كل شروط النجاح، ومعايير اعتبارها ديمقراطية وذات مغزى سياسي ووطني. فكيف إذا كانت الانتخابات بالأصل معيبة من زاوية مقدار تلبيتها لمعايير الديمقراطية.
مخاطر اللجوء للانتخابات
إن أهم معايير الانتخابات الديمقراطية في نظام سياسي مستقر، هي عدم قدرة أي طرف على التأثير في نتائج الانتخابات لا بصورة قبلية ولا بعدية. فهل ينطبق ذلك على الحالة الفلسطينية الراهنة أو التي كانت سائدة سواء في انتخابات العام 2006، أو تلك التي ألغاها رئيس السلطة الفلسطينية بقرار منفرد في العام 2021؟
من حيث المبدأ، فإن قدرة الرئيس على إلغاء الانتخابات بتلك الكيفية، التي سبقتها سلسلة ممتدة من القرارات بقوانين شطبت حالة التوازن الضرورية بين مكونات ممارسة السلطة بدون استبداد أو سلطوية، هي دليل قاطع -وأيًَّا كانت المبررات- على أن الجهاز التنفيذي ممثلًا بالرئيس ومؤسسة الرئاسة، قادر وفق إرادته المنفردة على تعطيل أية عملية ديمقراطية، وإفراغ الانتخابات من مضمونها. ولعل قرار الرئيس الأخير بتعيين نائب له في كلا المنصبين (المنظمة والسلطة) دون الرجوع إلى مؤسسات المنظمة، و"العفو" عن كوادر حركة فتح دون الرجوع لمؤسسات الحركة، هو خير مؤشر على إصرار القيادة الفلسطينية على التصرف بدرجة كاملة من التحرر من القيود المؤسسية.
تقودنا هذه الملاحظة إلى السياق المتصل بهيمنة السلطة التنفيذية وحزبها المهيمن على مقدرات السلطة الفلسطينية بصورة مطلقة، وتوظيفها في تجييش مؤيديها وأنصارها والمستفيدين منها، بينما تحرم منها بقية الأطراف المنافسة. وقد بينت التحضيرات التي سبقت إلغاء الانتخابات في العام 2021، والأحداث التي رافقت عملية أجهزة أمن السلطة في جنين، كيف توظف أجهزة السلطة، وبخاصة أجهزة الأمن للدفاع عن فصيل بعينه، ومقدار تداخل بناهما وتبادل الأدوار بينهما على نحو حول الضفة الغربية إلى حيز مفتوح لأخطر أشكال الاستقطاب. وفي حالة الانتخابات المذكورة (وكذلك انتخابات العام 2006) تجندت أجهزة إعلام السلطة ومؤسساتها المدنية والأمنية ومواردها المالية في الدعاية والحشد لمصلحة حركة فتح، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد الفرص المتكافئة في خوض الانتخابات. إذ كيف يمكن لأي قوة سياسية أو حزب أو قائمة انتخابية أن تواجه أجهزة "الدولة" في انتخابات نزيهة وحرة، إلا إذا كان المطلوب إنتاج مؤسسة تشريعية شكلية وعاجزة عن خلق التوازن الضروري لكي تكون الانتخابات استدخالية وليست إقصائية، وبخاصة في ظل نظام سياسي مختلط من الناحية النظرية الدستورية، ورئاسي من الناحية الفعلية وقوة الأمر الواقع. وهذا ينقلنا إلى الملاحظة النقدية الأخيرة بشأن موجبات التوافق، والمتعلقة بالنظام المختلط/الرئاسي.
يكمن أحد أهم التحديات أمام الديمقراطيات الناشئة في اختيار التصميم المؤسسي لسلطة الحكم وممارسته، الذي يأتي، بالعادة، من خلال نصوص دستورية صريحة وصارمة لناحية توازن السلطات. ولأن مثل هذه الديمقراطيات تعاني، بالأصل، من هشاشة بناها القانونية، وضعف وقلة خبرة أجهزتها وقواها السياسية، فإن النظم الرئاسية أو المختلطة تعتبر بنظر الخبرة التجريبية خطيرة على التجربة الديمقراطية. فحاصل جمع هذا النظام -بما يمنحه من سلطات تنفيذية واسعة لمؤسسة الرئاسة مقابل الحكومة- مع البنى القانونية الهشة، سيمنح الرئيس منفردًا أو مع حزبه سلطة مطلقة. فكيف إذا كانت الحكومة، أيضًا، من الحزب نفسه، أو يشكلها الرئيس بمعزل عن أي جهة تشريعية، وهي التي يقع على عاتقها تنظيم الانتخابات؟
إن أية محاولة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني لن يكتب لها النجاح إذا ما بقي النظام السياسي على حاله بصفته نظامًا مختلطًا. والحال هذه، فإن متطلبات تغيير القانون الأساسي الفلسطيني لإحداث تغيير في بنية مؤسسات السلطة، يضع مسألة الإصلاح برمتها في يد الرئيس والمراسيم الرئاسية؛ ومن غير المتصور أن يقدم الرئيس على إصدار مرسوم يغير فيه هذه البنية لصالح نظام برلماني كامل. وهذه مسألة لا تحل إلا بنظام قائم على التوافق؛ فمن خلال التوافق يمكن التأسيس لتغيير شكل السلطة الفلسطينية ومضمونها وخصائصها من خلال الحد من سلطة مؤسسة الرئاسة كخطوة تمهد لتغيير النظام. وبدون مثل هذا التوافق، تصبح الدعوة إلى إصلاح السلطة وتغيير بنيتها ضربًا من الخيال، أو دعوة للاقتتال الداخلي.
خاتمة
ليس فحسب لأن الانتخابات لا تتصدى للأسئلة الأكثر أهمية حول معيقات الوحدة الوطنية، بل لأن انتظار الانتخابات وفق إعلان الرئيس محمود عباس في القمة العربية سيكون مكلفًا سياسيًا ووطنيًا. وفي ظل التراجع المفزع لروافع الكفاح الوطني والمقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، وما يجري من محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، فإن البديل هو العمل، وبدون تأخير، من أجل فرض التوافق كمهمة وطنية تعيد تأسيس العلاقات الفلسطينية الداخلية على قاعدة مشروع تحرر وطني يتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة، ويبني على مكتسباتها وإنجازاتها. وهنا سيبرز السؤال المحق الذي يحتاج إلى إجابة عنه، وهو: ما العمل فيما يتعلق باستمرار رفض القيادة الفلسطينية لكل مقترحات التوافق؟
إن استمرار المراوحة في مربع الانتظار والإحجام ذاته عن البدء بحراك وطني شامل لفرض التوافق، هو ما يساهم في الواقع باستمرار القيادة الفلسطينية على موقفها. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بهيمنة خطاب المزاودة هي التي تحول حتى الآن دون اتخاذ مواقف من قبل العديد من الفصائل الفلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية. إلا أن حالة الاستياء والرفض للنهج السائد في إدارة الشأن الفلسطيني بدأت بدفع قوى وازنة نحو مواقف أكثر جذرية، وقادت إلى مبادرات كبرى مهمة مثل "المؤتمر الشعبي 14 مليون"، والمؤتمر الوطني الفلسطيني، واجتماعات الفصائل في الدوحة عشية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ووجود قاعدة برنامجية متمثلة في اتفاق بكين، من شأنها أن تشكل مجتمعةً سياقًا وطنيًا وسياسيًا تبنى عليه أسس التوافق وآلياته. فالتحرك قدمًا من خلال جذب مزيد من القوى السياسية والاجتماعية إلى هذه الحراكات، وبما يشمل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وفصائلها، وحركة فتح، يمكنها أن تطلق دينامية ذات زخم شعبي تفرض نفسها، وتفرض التوافق على قاعدة تمثيل سياسي وطني تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بشرط إصلاحها واستعادة دورها، لتتمكن، بدورها، من فرض التوافق المؤسسي والسياسي على السلطة الفلسطينية.
تطبيق إعلان بكين ومقومات تجاوز التحديات والعقبات
د. عماد الدين محمد أبو رحمة
مقدّمة
على الرغم من مضى ما يقارب ثمانية شهور على توقيع "إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية" برعاية صينية، في 23 تموز/يوليو 2024، فإنه لم يتم اتخاذ أيه خطوات عملية لتنفيذ بنود الاتفاق؛ سواء فيما يتعلق بتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية، ومقاومة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، أو تفعيل وانتظام" الإطار القيادي المؤقت الموحد كإطار للشراكة في صنع القرار السياسي، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" مؤقتة، مهمتها توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء الانتخابات.[20]
وهذا يطرح أسئلة عدة حول دوافع أطراف الانقسام الفلسطيني لتوقيع الاتفاق، ومدى جديتهم في تطبيق بنوده، والعقبات والتحديات التي تحول دون البدء في تنفيذ الاتفاق، ومتطلبات تجاوز هذه العقبات، لجهة بلورة رؤية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على مخيمات الضفة الغربية ومدنها، وتسارع وتيرة مخطط الضم في الضفة الغربية، علاوة على محاولات تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتجاوز الخيار الفلسطيني لصالح مشاريع وصاية وبدائل عربية وإقليمية ودولية.
أولًا. سياق توقيع إعلان بكين
تم توقيع إعلان بكين بعد جولة الحوار الثانية، التي أجرتها الفصائل الفلسطينية في بكين برعاية صينية، في الفترة ما بين 21-23 تموز/يوليو 2024، حيث عقدت الجولة الأولى في شهر نيسان/أبريل 2024، من دون التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن تعقد الجولة الثانية في 24 حزيران/يونيو 2024، ولكنها تأجلت بسبب خلافات جوهرية بين حركتي فتح وحماس، تتعلق بأشكال المقاومة، والشراكة السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ومرجعيتها، والموقف من التزامات المنظمة بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات المبرمة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.[21]
وتتحدد ملامح السياق الذي جرى فيه توقيع الاتفاق بالعناصر التالية:
- استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم أميركي وغربي كامل وتواطؤ عربي، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هدف الحرب هو القضاء على حركة حماس، ورفضه عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، وسعيه إلى تشكيل إدارة محلية بديلة لسلطة حماس، أو إدارة مدنية تحت سلطة الاحتلال، أو تولي جهات عربية المسؤولية عن قطاع غزة في ظل بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية، إضافة إلى دعوته إلى تهجير سكان قطاع غزة.
وبالتوازي مع ذلك، صوت برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية ساحقة، في 21 شباط/فبراير 2024، على قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، إلى جانب تصويته على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في 18 تموز/يوليو 2024، بما يقطع الطريق على أية أوهام لأفق سياسي لحل الدولتين. كما صادق الكنيست، بقراءة تمهيدية، في 14 شباط/فبراير، على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس.[22]
وتسارعت وتائر تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، وفقًا لـ"خطة الحسم"[23] التي طرحها الوزير المتطرف، بتسلئيل سموترتش، بدعم كامل من حكومة نتنياهو، إضافة إلى الإجراءات التي تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية، والقضاء على المقاومة الفلسطينية في مخيمات الضفة ومدنها.
- تبني إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، موقفًا يتقاطع مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق برفض حكم حماس لقطاع غزة، أو عودة السلطة للحكم، والسعي إلى تشكيل إدارة مؤقتة ومستقلة لقطاع غزة، وفقًا للتصور الأميركي لـ"اليوم التالي للحرب على غزة"، وطرح فكرة إيجاد "سلطة متجددة" في مسعى لتحويل الرئيس عباس إلى رئيس فخري، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات لتقوم بالإصلاحات المطلوبة أميركيًا، وتؤدي الدور الأمني المطلوب منها بشكل أكثر فعالية.
- تزايد الضغوط العربية على الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، سواء التي تطالب السلطة بتغيير جذري ومصالحة حقيقية تؤهلها لتكون على طاولة "اليوم التالي للحرب على قطاع غزة"، أو تلك التي تسعى إلى إخراج السلطة من اللعبة عبر اتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء عُقد في أبو ظبي بين مسؤولين إماراتيين وأميركيين وإسرائيليين، لترتيب اليوم التالي للحرب.[24]
- تزايد فرص فوز دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأميركية، وبخاصة بعد انسحاب الرئيس بايدن، وما يحمله ذلك من مخاطر، نظرًا لتبني ترامب مواقف داعمة بقوة لحكومة اليمين الإسرائيلي وعدوانها على قطاع غزة، علاوة على دعمه لمخطط الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وفقًا للخطة التي أطلقها خلال فترة ولايته الأولى ("صفقة القرن")، بما يقطع الطريق على إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
- تزايد حدة الاستقطاب الفلسطيني الداخلي، بناء على الموقف من الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبه من حرب إبادة جماعية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتداعيات هذه الحرب. صحيح أن القيادة الفلسطينية أدانت الحرب على غزة وحملت حكومة نتنياهو وإدارة بايدن المسئولية عن استمرارها. ولكنها، في المقابل، اتبعت سياسة الانتظار، ولم تسع الى تفعيل مؤسسات وأطر العمل الوطني من أجل بلورة رؤية وطنية مشتركة للتصدي لحرب الإبادة في غزة، ولم تفعل شيئا لمواجهة التوسع الاستيطاني والعدوان الإسرائيلي المتصاعد على مخيمات ومدن الضفة الغربية، أو تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في موسكو، في شباط/فبراير 2024، وغيرها من الاتفاقات.
وفي هذا السياق، سعت القيادة الفلسطينية إلى الاستفادة من الظروف القائمة من أجل استعادة حكمها لقطاع غزة، وحمّلت حركة حماس جزءًا من المسؤولية عن حرب الإبادة على غزة، وأطلقت حملة تحريض ضد مجموعات المقاومة في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها "مجموعات خارجة عن القانون"، تسعى إلى نقل الحرب إلى مدن الضفة الغربية. وقد أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا، في 14 تموز/يوليو 2024 (أي قبل صدور إعلان بكين بأيام معدودة) اتهمت فيه حركة حماس بأنها "بتهربها من الوحدة الوطنية، وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال، (تكون) شريكًا في تحمُّل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية"، في حين رفضت فصائل فلسطينية هذه التصريحات واعتبرتها "مسيئة للشعب الفلسطيني"، وطالبت حركة حماس بسحبها، لأنها "تعطي المبرر لجيش الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا، وتحمل المسؤولية عن هذه المجازر للمقاومة".[25] وفي المحصلة، ساهم الانقسام الداخلي في تعزيز انكشاف الوضع الفلسطيني على التدخلات الخارجية، ومنع إمكانية بلورة تصور فلسطيني موحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية، بل وشجع الأطراف الخارجية على طرح حلول وبدائل إقليمية ودولية تتجاوز حركة حماس والقيادة الفلسطينية.
ثانيًا. دوافع توقيع الإعلان
يبدو أن العوامل السابقة دفعت الطرفين، فتح وحماس، إلى إبداء مرونة أكبر، أفضت في المحصلة إلى جسر قضايا الخلاف الجوهرية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في جولات الحوار السابقة (بما في ذلك الجولة الأولى من حوار بكين)، والتوافق على صيغة اتفاق يمكن وصفه بأنه "اتفاق متوازن"، لأنه يحقق مصالح لكلا الطرفين.
فنص الإعلان لم يتضمن الشروط المعلنة من قبل الرئيس أبو مازن، التي كان يصر عليها وفد حركة "فتح" في لقاءات الحوار السابقة، وهي:[26] الالتزام بالنظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة والتزاماتها الدولية (بما في ذلك الاتفاقات التي وقعتها مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي)، والالتزام بالشرعية الدولية (بما يشمل شروط الرباعية الدولية)، وتشكيل حكومة تكنوقراط بقرار من الرئيس وتلتزم ببرنامجه السياسي، وأن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام هو مسؤولية المنظمة.
وفي المقابل، قبلت حماس ألا تكون في الواجهة، وأن تتخلى عن حكمها المنفرد لقطاع غزة، وتركت للرئيس أبو مازن صلاحية دعوة الإطار القيادي الموحد، وتشكيل الحكومة.
وبناء على ذلك، تضمن الإعلان التالي:
- تضمن بندًا ينص على تفعيل وانتظام الإطار القيادي المؤقت والموحد للمشاركة في صنع القرار السياسي، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق القاهرة، 2011)، الذي يتيح مسؤوليات كبيرة للإطار القيادي المؤقت.
- أكد على المقاومة وفقًا للقانون الدولي، من دون أية إشارة للسلاح الشرعي الواحد والقانون الواحد أو للمقاومة الشعبية السلمية.
- لم يتطرق إلى التزامات المنظمة فيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي أو الشرعية الدولية.
- تضمن الاتفاق بندًا ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بتوافق الفصائل، وبقرار من الرئيس بناء على القانون الأساسي، مهمتها توحيد المؤسسات وإعادة الإعمار والتمهيد للانتخابات.
ولكن، الإعلان لم يتضمن آليات لتنفيذه وفقًا لجدول زمني متفق عليه، وترك للرئيس أبو مازن صلاحية الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت، وكذلك صلاحية الدعوة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك لم يتضمن توافقًا على تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة ملف المفاوضات التي تتصل بوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، بما يعزز الموقف التفاوضي الفلسطيني، ويكرس وحدانية التمثيل الفلسطيني، ويقطع الطريق على محاولات فرض بدائل إقليمية ودولية وتجاوز الخيار الفلسطيني.
وفي المحصلة، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي لتطبيق الاتفاق، علاوة على فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وفاق وطني، أو لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة. كما تفاقمت حدة الاستقطاب الداخلي بعد إطلاق أجهزة السلطة الفلسطينية حملة أمنية في جنين، في كانون الأول/ديسمبر 2024، تحت مسمى "حماية وطن"، استهدفت مجموعات المقاومة الفلسطينية، بدعوى "معالجة سنوات من الفوضى وضمان أمن المواطنين"، وملاحقة من وصفهم الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، بـ"الخارجين على القانون" في جميع أنحاء الضفة الغربية.[27]
وهذا يحيل إلى السؤال عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الطرفين إلى توقيع الإعلان:
- عدم رغبة الطرفين في تحمل المسؤولية عن فشل التوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية.
- رغبة الطرفين في إرضاء الصين، لكونها دولة كبرى داعمة للحقوق الفلسطينية، وتحظى بمكانة دولية مؤثرة.
- توقيع الاتفاق من شأنه أن يعزز شرعية الرئيس أبو مازن، ويتيح له استخدامه، بشكل تكتيكي، للتلويح لإسرائيل والإدارة الأميركية والدول العربية الحليفة لها بأن لديه خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها، في حال استمرت حكومة نتنياهو في رفضها لعودة السلطة لقطاع غزة، وسعيها إلى تقويض السلطة في الضفة الغربية، وإذا تواصلت المساعي الدولية والإقليمية لتجاوز دور القيادة الفلسطينية وفرض بدائل إقليمية ودولية.[28]
وفي كل الأحوال، فإن ما تضمنه الاتفاق حول مشاركة حماس في الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، يمكن تبريره بكونه لا يعني دخولها إلى المنظمة، لأن القرار يبقي في يد اللجنة التنفيذية للمنظمة. كما أن تشكيل حكومة وفاق وطني من شخصيات مستقلة، ولا تشارك فيها الفصائل، هو مطلب أميركي ودولي وإقليمي أساسًا.
- أما فيما يتعلق بحركة حماس، فإن تطبيق الاتفاق يتيح لها أن تكون شريكًا في عملية صنع القرار الفلسطيني، ويوفر لها مظلة الشرعية الفلسطينية التي تحتاجها لإحباط مخطط شطبها، حتى لو كان الثمن تخليها عن سلطتها في غزة، وعدم مشاركتها في حكومة السلطة. كما أن رهان حماس الرئيسي يكمن في قوتها وحضورها الميداني في قطاع غزة، الذي يجعلها قوة لا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة في الوقت الراهن.
ثالثًا. عقبات تطبيق إعلان بكين
بناء على ما سبق، يمكن الإشارة إلى العديد من العوامل، الداخلية والخارجية، التي تحول دون تطبيق الاتفاق، وأبرزها:
- الإعلان، شأنه في ذلك شأن الاتفاقات السابقة، جاء تحت وطأة ظروف وضغوط داخلية وخارجية، بهدف تحقيق غايات تكتيكية، ولم يكن نابعًا من منظور إستراتيجي ينطلق من أولوية استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. والدليل على ذلك أنه لم يتم الاتفاق على آليات بجدول زمني لتطبيق الإعلان، ما جعل قرار دعوة الإطار القيادي المؤقت وتشكيل الحكومة بيد الرئيس.
- الصياغات التوافقية للإعلان لم تنبع من توافق حقيقي حول قضايا الخلاف الجوهرية بين الطرفين، فتح وحماس، التي كانت سببًا في إعاقة تطبيق الاتفاقات السابقة، وهي: التوافق على البرنامج السياسي وإستراتيجية التحرر الوطني، بما في ذلك سلاح المقاومة ومرجعيتها وأشكال المقاومة، والاتفاق على أسس الشراكة التعددية داخل مؤسسات المنظمة والسلطة، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال.
- تضارب الأجندات التي يتبناها طرفا الانقسام، وتماهيهما مع خطوط التقسيم والصراع في المنطقة، أدى إلى تعزيز انكشاف الوضع الفلسطيني على التدخلات الخارجية، وجعلهما أكثر تأثرًا بضغوط وتدخلات القوى الإقليمية والدولية المعيقة للمصالحة. وهذا يعد عاملًا رئيسيًا من عوامل تعطيل تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
- معارضة حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية والدول الأوروبية لانضمام حركة حماس للمنظمة أو مشاركتها في السلطة، وتصنيفها على أنها "حركة إرهابية". وهذا، أيضًا، يعد من العوامل الرئيسية لعدم تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة، لأن الرئيس أبو مازن يخشى من أن يؤدي ذلك إلى مقاطعته دوليًا. ويبدو أن هذه المخاوف تعاظمت بعد تنفيذ حركة حماس لهجوم السابع من أكتوبر، وما أعقبه من رد فعل إسرائيلي وأميركي وغربي.
رابعًا. متطلبات تجاوز العقبات
- توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف كافة، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على أسس الشراكة والتعددية، وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية، التي ساهمت في تكريس الانقسام، وتحوله إلى صراع على السلطة والتمثيل.
- عدم رهن المصالحة بالضغوط الداخلية والخارجية، أو بالاعتبارات التكتيكية والمصالح الفئوية لهذا الطرف أو ذاك، فهذا -وكما دللت التجربة- لن يفضي، في أحسن الأحوال، إلا إلى حلول جزئية ومؤقتة، لا تعالج الأسباب الجوهرية والعميقة للانقسام.
- ما سبق يستدعي تبني منظور وطني شامل للمصالحة، يقوم على أولوية المصالحة، والتوافق على البرنامج السياسي وإستراتيجية التحرر الوطني، وأشكال النضال ومرجعيتها، وأسس الشراكة التعددية داخل مؤسسات المنظمة والسلطة، وإعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة التي فرضها اتفاق أوسلو وملحقاته.
- النأي بالنفس عن المحاور والصراعات العربية والإقليمية، وبلورة رؤية وطنية لاستعادة الدعم العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية، بكونها قضية تحرر وطني، وعلى أساس برنامج سياسي وطني يتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الحق في مقاومة الاحتلال.
- ضرورة الاتفاق على آليات بجدول زمني ملزم لتطبيق بنود الاتفاق، وبخاصة ما يتعلق بعقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق، بما يؤدي إلى توحيد مؤسسات المنظمة والسلطة على أساس برنامج سياسي موحد، وإستراتيجية نضالية للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
- التوافق على رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، بحيث تشمل خطة وطنية موحدة للنضال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتصدي لمخطط الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة، ومواجهة مخطط التهجير في غزة والضفة، ومواجهة محاولات فرض حلول وبدائل إقليمية ودولية من طرح رؤية فلسطينية لـ"اليوم التالي للحرب على غزة"، تنطلق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحديد خياراته المستقبلية بشكل مستقل، إلى جانب الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتطبيق القرارات الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني، ضمن دولة مستقلة كاملة السيادة.
- تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يتعلق بوقف حرب الإبادة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وغيرها من القضايا، بما يعزز وحدانية التمثيل الفلسطيني.
الجلسة الثانية
إدارة الجلسة: وفاء عبد الرحمن
أحمد الطناني: نحو رؤية وطنية موحَّدة لتعزيز الصمود ومواجهة مخططات التهجير والضم
أنطوان شلحت: إسرائيل وفلسطينيو 1948 تحت وطأة الحرب على قطاع غزة: تعزّز نظرة "العدو من الداخل"!
هدير البرقوني: آفاق نجاح الخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إ عمار وتنمية غزة.
إبراهيم فريحات: إطار مقترح لحوار فلسطيني إقليمي دولي لتوسيع مساحات التوافق والفعل الداعم للحقوق الفلسطينية
نحو رؤية وطنية موحَّدة لتعزيز الصمود
ومواجهة مخططات التهجير والضم
أحمد الطَّناني
تواجه القضية الفلسطينية تهديدات غير مسبوقة، مع تصاعد مشاريع الضم والاستيطان والتهجير القسري التي تقودها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بدعم أميركي واضح. تسعى هذه المشاريع إلى إفراغ الضفة من الفلسطينيين، وفرض سيادة إسرائيلية كاملة عليها، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، لدفع سكانه إلى الهجرة القسرية. جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لكشف هذه الأهداف بوضوح، إذ استخدم الاحتلال التدمير الشامل، والحصار، وسلب الموارد، أدواتِ تهجيرٍ ممنهَجة.
في الضفة، تتسارع خطوات الضم عبر توسيع الاستيطان، وتشديد القوانين التي تمنع الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم، إضافةً إلى الحملات العسكرية التي تستهدف مدن الضفة ومخيماتها، وآخرها حملة "السور الحديدي"[29] التي تهدف إلى إعادة هيكلة شمال الضفة الغربية جغرافيًا وديموغرافيًا، بينما تعمل إسرائيل على إعادة صياغة "الترانسفير" بمفهوم "الهجرة الطوعية"، بدعم مباشر من قادة الصهيونية الدينية. في الوقت ذاته، يساهم الانقسام الفلسطيني في تفتيت الجهود الوطنية، ما يُضعف القدرة على التصدي لهذه المخاطر الوجودية.
تهدف هذه الورقة إلى بلورة رؤية وطنية موحَّدة لتعزيز الصمود، ومواجهة مشاريع التهجير والضم، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير، وتفعيل المقاومة الشاملة، وإنهاء الانقسام، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل التحرك الدبلوماسي، ودعم إعادة الإعمار في قطاع غزة. كما تؤكد ضرورةَ بناء موقف عربي مشترَك، يدعم الخطة المصرية-الفلسطينية، ويوفر غطاءً سياسيًا لمواجهة الانحياز الأميركي والتصفية الإسرائيلية للقضية الفلسطينية.
تتطلب مواجهة هذه التهديدات تحركًا وطنيًا عاجلًا، يُعيد الاعتبار إلى المشروع الوطني الفلسطيني، ويؤسِّس لإستراتيجيةِ مقاومةٍ شاملةٍ قادرةٍ على حماية الحقوق الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تصفية القضية.
المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية: تهجير، ضم، انقسام يعمِّق الأزمة
منذ بدايات المشروع الصهيوني، شكَّلت سياسة التهجير القسري ركيزةً أساسيةً في الإستراتيجية الإسرائيلية للسيطرة على الأرض الفلسطينية وإفراغها من سكانها الأصليين. بدأت هذه السياسة مع نكبة العام 1948، إذ طُرد أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم عبر المجازر الجماعية والترويع، وتدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية، ما أسَّس لنهج إسرائيلي يقوم على فرض وقائع ديموغرافية جديدة تُحوِّل الفلسطينيين إلى سكانٍ بلا وطن.[30] تكررت هذه السياسات في نكسة العام 1967، التي شهدت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تفكيك الترابط الجغرافي الفلسطيني، ومنع إقامة أي كيان سياسي مستقل في المستقبل.
بمرور العقود، تطورت خطط التهجير الإسرائيلية لتصبح أكثر تعقيدًا، فلم تعُد قائمةً على الطرد المباشر فحسب، بل باتت تعتمد على إستراتيجيات طويلة الأمد، مثل التضييق الاقتصادي، وهدم المنازل، وسحب الإقامات، وتحويل الحياة الفلسطينية إلى معاناة يومية تدفع السكان إلى الهجرة "الطوعية". في قطاع غزة، تحوَّل الحصار الإسرائيلي إلى أداة تهجير غير مباشرة، فاستُخدِم التدمير الممنهَج للبنية التحتية، وفرض القيود المشدَّدة على حركة الأفراد والبضائع، واستهداف القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، لدفع السكان إلى البحث عن حياة أكثر استقرارًا خارج القطاع.[31] ومع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، برزت هذه السياسات في أوضح صورها؛ إذ مثَّلت هذه الحرب ذروة التصعيد والتعبير الأوضح عن خطط الحسم الإسرائيلية، عبر السعي إلى خلق واقع جديد قائم على التدمير الشامل والتهجير القسري، تحت غطاء العمليات العسكرية.
في الضفة الغربية، لم تعُد إسرائيل تكتفي بتوسيع المستوطنات أو دعم جماعات المستوطنين المسلحة، بل تحوَّلت سياسات الضم إلى جزء من الأجندة الرسمية للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين الصهيوني المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير. أعلن سموتريتش أن العام 2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية،[32] في خطوة تعكس نية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الضم الفعلي عبر خطوات قانونية وعسكرية وإدارية متسارعة، تهدف إلى إخضاع الضفة الغربية بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، وتقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى جيوب معزولة غير مترابطة. بالتوازي مع ذلك، عاد الحديث في أوساط الصهيونية الدينية عن إعادة الاستيطان في قطاع غزة، إذ يدعو قادة اليمين المتطرف إلى استعادة المستوطنات التي أُخلِيَت في العام 2005، وفرض واقع استيطاني جديد في القطاع، تحت ذريعة السيطرة الأمنية الكاملة، ومنع أي تهديد مستقبلي لإسرائيل.[33]
تزامنت هذه التوجهات مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما عزَّز اندفاع الحكومة الإسرائيلية نحو تنفيذ مخططاتها التوسعية دون قيود دولية حقيقية. في خلال ولايته السابقة، منح ترامب إسرائيل غطاءً سياسيًا غير مسبوق، من خلال اعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وإعلانه "صفقة القرن"، التي أعطت الضوء الأخضر لضم أكثر من 30% من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن.[34] اليوم، ومع استعادته للرئاسة، تُعَدُّ الإدارة الأميركية الحالية الأكثر انحيازًا للمشروع الصهيوني، إذ ينظر إليها قادة اليمين الإسرائيلي بوصفها فرصة ذهبية لفرض "حسم الصراع"، واستكمال مشروع التصفية النهائية للحقوق الفلسطينية، عبر سياسات الضم والتهجير. ويظهر ذلك بوضوح من خلال إعادة تبنِّي إدارة ترامب لمفاهيم مثل "الهجرة الطوعية"، التي يروِّج لها قادة الصهيونية الدينية كبديل لحل الدولتين، ووسيلة لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.[35]
في ظل هذه التهديدات، لا تزال الساحة الفلسطينية تعاني من انقسام سياسي حاد، يُضعِف قدرتها على التصدي لهذه المشاريع التصفوية. منذ العام 2007، أدى الانقسام بين فتح وحماس إلى غياب إستراتيجية فلسطينية موحَّدة؛ إذ تتبنى السلطة الفلسطينية في الضفة سياسات قائمة على المراهنة على المسار السلمي والحراك الدبلوماسي، بينما تخوض المقاومة في قطاع غزة مواجهات عسكرية مستمرة، دون وجود رؤية موحدة لإدارة الصراع. سمح هذا التناقض لإسرائيل باستغلال الفجوة الفلسطينية لتعزيز مشاريعها التوسعية، وإعادة هندسة الخريطة السياسية والجغرافية لصالحها. كما أن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لم تتمكن من استيعاب القوى الفلسطينية الأخرى ضمن إطار وطني شامل، ما جعلها عاجزة عن تشكيل جبهة موحَّدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
لقد شكَّلت حرب الإبادة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 ذروة التصعيد الإسرائيلي، فلم يَعُد الاحتلال يكتفي بسياسات الضم التدريجي أو القمع العسكري المحدود، بل انتقل إلى مرحلة جديدة تهدف إلى فرض واقع سياسي وجغرافي لا يمكن التراجع عنه. لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها، بل باتت تعمل علنًا على تصفية أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، عبر استكمال مشروع الضم، وتكريس الاستيطان، وفرض التهجير القسري كأمر واقع. ومع استمرار الانقسام الفلسطيني، وضعف التحرك العربي والدولي، تبدو القضية الفلسطينية أمام خطر وجودي غير مسبوق، يتطلب تحركًا فلسطينيًا عاجلًا لإعادة بناء الوحدة الوطنية، وإطلاق رؤية مقاومة واضحة لمواجهة هذه المخططات، قبل أن يصبح الاحتلال الإسرائيلي أمرًا لا رجعة فيه.
المشهد الإنساني والميداني في فلسطين: دمار واسع وسياسات تهجير ممنهجة
حتى آذار/مارس 2025، تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أودى بحياة الآلاف في قطاع غزة، وشرَّد الملايين، ودمَّر البنية التحتية بشكل واسع، ضمن مخطط يهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، بما يخدم سياسات الضم والتهجير القسري.
في قطاع غزة، فاقت حصيلة الضحايا 61,709 شهداء، بينهم 17,881 طفلًا و12,316 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 111,000 جريح، مع نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، فقد معظمهم منازلهم بفعل العدوان المتواصل. لم يقتصر التدمير على الأحياء السكنية، بل امتد ليشمل القطاعات الحيوية كافة، فقُدِّرت الخسائر المادية المباشرة بـ29.9 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 19.1 مليار دولار، ما يعني انهيارًا شبه كامل للحياة المدنية.[36]
استهدف العدوانُ البنية التحتية استهدافًا ممنهَجًا، إذ دُمِّر 330,000 مبنى، بينها 272,000 وحدة سكنية بالكامل، مع أضرار جسيمة طالت 60% من شبكة الطرق، وانهيار قطاع الطاقة بسبب تدمير منشآت الكهرباء والمياه، ما أدى إلى أزمة حادة في الخدمات الأساسية. لم يكن قطاع الصحة بمنأى عن هذا الدمار، فقد خرج 18 مستشفى من الخدمة كليًا، بينما تعرَّض 17 مستشفى آخر لأضرار جزئية، ما فاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة يفتقدون للعلاج. كما أصبح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني عرضة للأمراض المعدية، نتيجة تلوث المياه وتكدس النفايات، في ظل انعدام الخدمات الصحية الكافية.
على صعيد قطاع التعليم، تعرضت 1661 منشأة تعليمية للقصف، بينها 927 مدرسة وجامعة وروضة أطفال ومراكز تعليمية دُمرت بالكامل، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12,800 طالب و800 معلم، وحرمان 785,000 طالب من استكمال تعليمهم. أما الاقتصاد، فشهد انهيارًا شبه كامل، مع تراجع الناتج المحلي بنسبة 83%، وارتفاع معدلات البطالة إلى 80%، ما خلق أزمة اجتماعية عميقة، فقد ارتفع التضخم بنسبة 309.4%، وسط شلل اقتصادي شامل.[37]
في الضفة الغربية، تواصلت عمليات القتل والاعتقال والاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، وقد استشهد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 940 فلسطينيًا، منهم 110 فلسطينيين منذ بداية العام 2025، بينهم 17 طفلًا و4 نساء،[38] في عمليات عسكرية متفرقة استهدفت المدن والمخيمات الفلسطينية. تركزت هذه العمليات، بدرجة أساسية، في مخيمات جنين وطولكرم ونابلس، وقد أدى القصف والتوغل العسكري إلى تدمير واسع للبنية التحتية، شمل 500 منزل ومنشأة في جنين، وأكثر من 100 منزل في طولكرم، إضافةً إلى تفكيك مناطق سكنية متجاورة، ما أفقد بعض الأحياء 30% من أبنيتها التقليدية، في إطار سياسة إعادة الهيكلة الديموغرافية للمخيمات.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفَّذ الاحتلال 935 عملية اقتحام للمخيمات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، وإصابة 1250 آخرين، واعتقال 2,368 شخصًا، وتدمير 800 وحدة سكنية، وتهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من منازلهم. تأتي هذه العمليات في سياق مخطط تهجيري ممنهَج يستهدف إعادة رسم الخارطة السكانية في الضفة، عبر تحويل المخيمات والتجمعات السكنية إلى مناطق غير صالحة للحياة، لدفع السكان إلى النزوح القسري.[39]
على صعيد التوسع الاستيطاني، شهدت الضفة الغربية والقدس في العام 2024 تصعيدًا استيطانيًا غير مسبوق، فقد ارتفع عدد المستوطنين إلى 770,000 مستوطن، موزَّعين على 180 مستعمرة و256 بؤرة استيطانية. وافقت سلطات الاحتلال على 173 مخططًا لبناء 23,461 وحدة استيطانية جديدة، وإنشاء 51 بؤرة استيطانية، منها 36 بؤرة رعوية، ما يعكس توسعًا غير رسمي في السيطرة على الأراضي. كما تمت مصادرة 46,597 دونمًا بذرائع مختلفة، بما في ذلك 20,000 دونم كمحميات طبيعية، و803 دونمات بالاستملاك، و1,073 دونمًا عبر أوامر عسكرية.[40]
تعكس هذه المعطيات واقعًا ميدانيًا كارثيًّا؛ إذ يتجه الاحتلال نحو فرض الضم التدريجي وتحويل التهجير القسري إلى أمر واقع، عبر سياسات تجمع بين العنف العسكري، والتدمير الممنهج، والتضييق الاقتصادي، والاستيطان المكثف. يتطلب هذا الواقع تحركًا فلسطينيًا موحَّدًا، لمواجهة المخاطر التي تهدِّد الوجود الفلسطيني، وإفشال المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة.
دواعي الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة
تُشكِّل الوحدة الوطنية الفلسطينية اليوم ضرورةً لا غنى عنها، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية، إذ لم تَعُد مشاريع الضم والتهجير والاستيطان، إلى جانب محاولات حسم الصراع نهائيًّا وفق الرؤية الصهيونية، تهدِّد الحقوق السياسية للفلسطينيين فحسب، بل تهدِّد، أيضًا، وجودهم على أرضهم. إن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني يُضعِف القدرة على التصدي لهذه المخططات، ويَمنح الاحتلالَ فرصة ذهبية لتنفيذ سياساته دون مقاومة حقيقية، ما يستدعي تحركًا وطنيًا جادًا لإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على أسس صلبة وقابلة للاستدامة.
- الوحدة بوصفها شرطًا لاستكمال مَسيرة التحرر الوطني والديمقراطي
منذ عقود، كانت الوحدة الوطنية الفلسطينية الركيزةَ الأساسيةَ للنضال الفلسطيني، فقد أثبت التاريخ أن الفترات التي شهدت أعلى مستويات التوافق الوطني كانت الأكثر تأثيرًا في مقاومة الاحتلال وإفشال مخططاته. ومع ذلك، أدّى الانقسام الفلسطيني المستمر منذ العام 2007 إلى إضعاف العمل الوطني المشترك، وخلق حالة من التشرذم السياسي والاجتماعي، ما استغله الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الاستيطان، وتعميق سيطرته الأمنية، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
لا يمكن للفلسطينيين استكمال مَسيرة التحرر دون إطار وطني موحَّد يُوجِّه طاقاتِ الشعب الفلسطيني نحو هدف التحرر والاستقلال. فلم تَعُد المعركة مع الاحتلال عسكرية أو سياسية فحسب، بل أصبحت، أيضًا، معركة بقاء وهوية، ما يتطلب توحيد الجهود في الداخل والخارج، ضمن مشروع وطني يُمثِّل الكل الفلسطيني، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة المرحلة القادمة.
- مواجهة مخططات حسم الصراع والإجهاز على الكينونة الفلسطينية
تشهد المرحلة الحالية تصعيدًا غير مسبوق من قبل حكومة الاحتلال، التي يقودها تحالف اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير. لقد أصبحت سياسات الضم والتهجير والاستيطان والعدوان العسكري جزءًا من مشروع شامل يُعرف بـ"حسم الصراع"،[41] يسعى إلى إنهاء أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وطمس الهوية الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من أي أدوات قوة تمكنهم من الصمود والمقاومة، ومن ثم الإجهاز على وجودهم على الأرض.
تُشير خطط حكومة الاحتلال وخطواته المتصاعدة إلى المسارعة في إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، ما يعني تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى "جزر معزولة" تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة. في الوقت ذاته، تُحاول إسرائيل إعادة رسم المشهد الديموغرافي في قطاع غزة عبر سياسات التجويع والحصار والتدمير، لدفع سكانه نحو الهجرة القسرية، في تكرار لسيناريوهات النكبة والنكسة.
في مواجهة هذه المخططات، لم يَعُد أمام الفلسطينيين خيار سوى المسارعة إلى بناء وحدة وطنية حقيقية، تُنهي الانقسام، وتعيد ترتيب الصفوف، وتُوحِّد القرار السياسي والميداني، في إطار مشروع مواجهة شاملة ضد الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
- التصدي للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية
تُظهِر التطورات الأخيرة أن القضية الفلسطينية باتت أمام منعطف خطير، إذ لم تَعُد التهديدات مقتصرةً على التمثيل السياسي للفلسطينيين، بل امتدت إلى تهديد وجودهم على أرضهم، من خلال سياسات التهجير والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهويد القدس، وعزل الضفة الغربية.
لقد أصبحت إسرائيل تعمل على الإجهاز على ما تبقَّى من أوراق القوة الفلسطينية، مستغِلةً حالة التشرذم الداخلي، والتراجع العربي، والانحياز الغربي المطلق لها، ما يجعل الحاجة إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية مسألةً مصيريةً لا تحتمل التأجيل.
يعني غياب الوحدة استمرارَ الاحتلال في الاستفراد بكل منطقة فلسطينية على حدة، وفرض سياسات تهجير واستيطان تدريجية، دون أن يواجِه مقاومةً موحَّدةً قادرةً على ردعه ورفع تكلفة سياساته.
- الوحدة الوطنية بوصفها شرطًا لاستعادة المبادرة الفلسطينية
لا يمكن للفلسطينيين مواجهة هذه التحديات دون إعادة جمع شمل الصف الفلسطيني، وفق رؤية وطنية واضحة، تعتمد على شراكة سياسية حقيقية بين الفصائل والقوى الوطنية كافة. ليس المطلوب اليوم مجرد اتفاقات لإدارة الانقسام أو حوارات غير منتجة، بل إرادة سياسية حقيقية للانطلاق في قطار الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وفق خطط وطنية واضحة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
نحو بلورة رؤية وطنية موحدة لتعزيز الصمود ومواجهة مخططات التهجير والضم
تتطلب مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية بلورة رؤية وطنية موحَّدة، تقوم على أسس سياسية وميدانية واضحة، تستند إلى وحدة الهدف والموقف، وتعزيز الصمود الشعبي، ورفع تكلفة الاحتلال سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين، وفرض الضم التدريجي للضفة الغربية، وتصفية القضية الفلسطينية ككل، لا يمكن مواجهة هذه المشاريع إلا من خلال إستراتيجية شاملة، تشارِك فيها القوى الوطنية كافة، وتعتمد على أدوات متعددة، تشمل المقاومة، والسياسة، والدبلوماسية، والمقاومة الشعبية، والاقتصاد، والتحرك القانوني الدولي.
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس شراكة وطنية شاملة
لا يمكن الحديث عن رؤية وطنية موحَّدة دون إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تكون مظلة حقيقية تمثِّل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج. تقتضي هذه الرؤية:
- تفعيل صيغة الإطار القيادي المؤقَّت (الأمناء العامون)، والتجهيز لعقد مجلس وطني توحيدي يعمل على إقرار خطة وطنية شاملة للمواجهة والصمود، ويشكِّل المرجعية السياسية والتنظيمية لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية.
- إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن تمثيل جميع الفصائل، يشمل ذلك حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، وغيرها من الفصائل غير الممثَّلة حاليًا.
- عقد مؤتمر وطني شامل يحدِّد البرنامجَ السياسيَّ العامَّ الذي يجب أن يكون مشترَكًا بين جميع القوى الوطنية، وبحضور شبابي ونسوي واضح، بما يضمن وحدة القرار الوطني الفلسطيني.
- إعادة بناء الهياكل التنفيذية لمنظمة التحرير ومنظماتها الشعبية، وضمان استقلاليتها عن أي نفوذ حزبي أو فصائلي، بحيث تعود المنظمة قيادة وطنية تمثِّل الفلسطينيين كافة.
- تبنِّي إستراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة
يُعَدُّ تعزيز المقاومة الشعبية والميدانية محوريًا في التصدي للضم والاستيطان. ولتحقيق ذلك يجب:
- تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، من خلال حملات واسعة للتصدي للمستوطنين، والرباط في الأراضي المهددة بالمصادرة، وتعزيز صمود القرى الفلسطينية المهدَّدة بالإخلاء، مثل الخان الأحمر، ومسافر يطا، والأغوار.
- تصعيد العمل الميداني ضد الاحتلال في الضفة الغربية، عبر حراك منظَّم في المدن والمخيمات الفلسطينية، يهدف إلى عرقلة سياسات الضم وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال.
- توحيد أدوات المقاومة، بحيث تُنسَّق الجهود بين مختلف الفصائل، وفق رؤية إستراتيجية تضمن عدم استفراد الاحتلال بمنطقة معينة أو فصيل معين.
- تعزيز المقاومة المدنية والاقتصادية، من خلال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومقاطعة العمالة الفلسطينية في المستوطنات، والعمل على بناء اقتصاد وطني مقاوم يقلِّل من الاعتماد على الاحتلال.
- استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام
الانقسام الفلسطيني أحد أكبر العوائق أمام بلورة رؤية وطنية موحَّدة، إذ يساهم في إضعاف الجبهة الداخلية، ويَمنح الاحتلالَ فرصة لاستغلال هذا الانقسام في فرض سياساته التوسعية. لذلك، يجب أن تتضمن أيةُ رؤية وطنية خطواتٍ جادةً لإنهاء الانقسام، تشمل:
- تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقَّتة تتولى إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس، وتضع خطة سياسية وأمنية موحَّدة لمواجهة الاحتلال.
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحيث تصبح مهمتها الأساسية حماية الفلسطينيين من الاحتلال.
- التجهيز لعقد انتخابات عامة تشمل الرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني الفلسطيني، لإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة الجمود السياسي.
- دعم إعادة إعمار غزة، والتوافق على الصيغة الانتقالية للقطاع
بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، باتت الحاجة ملحَّة لدعم الخطة المصرية-الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع،[42] والعمل على تذليل كل العقبات أمام تنفيذها، ونزع أية مبررات سياسية قد تعيق تقدمها. إن تعزيز إعادة الإعمار جزءٌ أساسيٌّ من الصمود الفلسطيني؛ إذ يسهم في تثبيت السكان في أماكنهم، ويواجِه محاولات الاحتلال دفع الغزيين نحو الهجرة الطوعية عبر خلق بيئة معيشية غير قابلة للحياة.
كذلك، فإن إنجاز التوافق على الصيغة الانتقالية لإدارة قطاع غزة يُعَدُّ أمرًا جوهريًّا، لمنع الاحتلال من استخدام "اليوم التالي" ذريعةً لإعادة العدوان، أو استمرار فرض الحصار. يجب أن يكون التوافق الوطني الفلسطيني على هذه الصيغة نتاج حوار وطني جامع، بحيث تُرتَّب المؤسسات الحكومية والأمنية بتوافق ودعم وطني، وإشراف مصري، تمهيدًا لإعادة توحيد المؤسسات الحكومية تحت مظلة حكومة توافق وطني فلسطيني، وفقًا لمخرجات اجتماع بكين.
كما تجب المسارعة في تنفيذ خطط تعافٍ لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في قطاع غزة، بما يضمن العودة التدريجية لمظاهر الحياة الطبيعية، ويحبط مخططات التهجير والهجرة الطوعية التي يسعى الاحتلال إلى فرضها عبر خلق بيئة معيشية غير مستقرة.
- بلورة رؤية عربية موحدة لدعم المشروع الوطني الفلسطيني
في مواجهة الانحياز الأميركي الواضح للخطط الإسرائيلية التصفوية، أصبح من الضروري العمل على بلورة رؤية عربية موحَّدة تدعم خططَ الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومتطلباتِ إعادة الإعمار، وجهودَ إعادة توحيد القطاع الحكومي الفلسطيني، وخططَ التعافي من آثار العدوان.
يجب أن تصبح هذه الرؤية عنوان الطرح العربي المشترك، بحيث تُراكِم على مخرجات القمة العربية في القاهرة والخطة المصرية-الفلسطينية، وتوفِّر مظلةً عربيةً لحماية الحقوق الفلسطينية من الضغوط الخارجية، وتعزيز الدعم العربي في المحافل الدولية، ورفع تكلفة الانحياز الأميركي إلى جانب الاحتلال.
يتطلب ذلك تفعيلَ الدور العربي في مواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية، والعملَ على تحشيد الدعم الدبلوماسي والسياسي للقضية الفلسطينية، وإعادةَ وضعها على رأس الأولويات الإقليمية والدولية. كما يجب أن تتضمن الرؤيةُ العربيةُ دعمًا مباشرًا للجهود الفلسطينية في مقاومة الاستيطان، وتعزيز الصمود في القدس والضفة الغربية، ومنع إسرائيل من فرض مخططات التهجير والضم.
- بلورة خطة استجابة إغاثية شاملة لتعزيز الصمود
لمواجهة نتائج العدوان الإسرائيلي وتأثيراته بعيدة المدى، يجب تبنِّي خطة إغاثية وطنية شاملة، تقوم على أوسع تكامل بين الجهات الحكومية، والمنظمات الأهلية، والفصائل، والقطاعات الجماهيرية، مع تحشيد الدعم العربي والدولي. ترتكز هذه الخطة إلى:
- إعادة النازحين إلى مناطق سكنهم، وتنفيذ عمليات إعادة تأهيل أولية للمساكن التي تضررت جزئيًا، وترميم البنية التحتية.
- تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدَفة بالتوسع الاستيطاني، من خلال توفير الدعم المباشر لسكانها، ومنع تهجيرهم، ورفع تكلفة الاستيطان على الاحتلال.
- دعم أهالي القدس في مواجهة محاولات التهجير، عبر تمويل مشاريع الإسكان، وتقديم المساعدات المالية للمقدسيين المهدَّدين بفقدان منازلهم، وتعزيز الحضور الفلسطيني في البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
- تفعيل التحرك الدبلوماسي والقانوني لمحاسبة الاحتلال
- العمل على تدويل القضية الفلسطينية، من خلال تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والجاليات في تحويل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى قضية رأي عام دولي.
- إطلاق حملات دولية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوسيع الدعم الدولي لمقاطعة إسرائيل.
- المراكمة على ما تم إنجازه في محكمتَي العدل الدولية والجنايات، ومتابعة الجهود في ملاحقة الاحتلال وقادته على جرائمه.
خلاصة
إن مواجهة مشاريع الضم والتهجير الصهيونية، تتطلب رؤيةً وطنيةً فلسطينيةً موحَّدة، تقوم على وحدة الصف، وتعزيز المقاومة، والصمود الاقتصادي، والتحرك الدبلوماسي، وتفعيل الدور الشعبي. كما أن مواجهة المخططات التصفوية تتطلب إسنادًا عربيًا جادًا، يعمل على دعم المسار الفلسطيني في إعادة البناء والتعافي، ويواجِه محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تجري عبر سياسات الضم والتهجير. لا يمكن للقضية الفلسطينية أن تواجِه هذه التحديات الكبرى دون تحقيق توافق وطني داخلي، مدعوم برؤية عربية مشتركة، تضع خطوطًا حمراء أمام المشروع الصهيوني، وتمنح الفلسطينيين القدرة على تعزيز صمودهم في أرضهم ومواجهة الاحتلال.
إسرائيل وفلسطينيو 1948 تحت وطأة الحرب
على قطاع غزة: تعزّز نظرة "العدو من الداخل"!
أنطوان شلحت
(1)
مُنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يوم عملية طوفان الأقصى وإعلان إسرائيل حرب الإبادة الجماعيّة والتدمير الشامل على قطاع غزة، يتعرّض الفلسطينيّون في أراضي 1948 إلى ملاحقة سياسية بذرائع أمنيّة شتى، وإلى حملة قمع شعواء لحرية التعبير المُقيّدة أصلًا.
ووفقًا لأحد التقارير الدورية الصادرة عن مركز "عدالة" الحقوقيّ، الذي تتطرّق معطياته إلى الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فإن هذا القمع يُعتبر نتاجًا لجهود منسقة وواسعة النطاق بين المكاتب الحكومية والمؤسسات الإسرائيلية المتعدّدة والجماعات اليمينية المتطرفة، حيث تستهدف جميعها الفلسطينيين وغيرهم ممن يحتجّون ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. ويجري اتهام كل من يعبّر عن رأيه؛ سواء فعل ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق وقفات احتجاجية، بدعم تنظيمات مُعرّفة كـ "إرهابية" وفق القانون الإسرائيلي، وبـ "التحريض على الإرهاب".
وقد جرى سبر غايات هذه الملاحقة في بيانات قوى سياسية عديدة في أراضي 1948، ومنهم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي عقد مؤتمره العام في خضم الحرب، في حزيران/يونيو 2024، ونوّه في بيانه الختامي بأنه علاوة على التحريض والترهيب تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل، بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحملة ملاحقة واسعة داخل المجتمع الفلسطيني لمنع أي تعاطف أو دعم لشعبنا في قطاع غزة، حتى لو كانت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي ضد قتل الأبرياء والدمار. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص، ولا سيما من بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الفنانين، بحجة نشر تغريدات داعمة أو متعاطفة مع قطاع غزة. وكان من الواضح أنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الهجمات والقمع تجاه المجتمع الفلسطيني، وتوجيه الرغبة في الانتقام تجاه كل من هو فلسطيني، واشتدت محاولات إعادة صوغ قواعد التصرف السياسي لهذا المجتمع بموجب ما يحدّده "الإجماع الصهيوني".
ويمكن القول إن الدلالات التي ينطوي عليها هذا السلوك الإسرائيلي حيال الفلسطينيين في أراضي 1948، تحمل إجابات عن أسئلةٍ تخُصّ الراهن والماضي القريب وربّما البعيد، وليس هذا فحسب، إنما، أيضًا، تتيح إمكان تحليل ما يمكن أن يحدث في المستقبل وتوقعه.
لعلّ أولى الدلالات، التي يتعيّن التوقف عندها، هي أن الأدوات المستخدمة في التعامل مع الفلسطينيّين في أراضي 1948 في وقت الحرب، تشي بأن المؤسسة الإسرائيليّة تتعامل معهم على أنهم أعداء محتملون. إضافة إلى ذلك، بيّنت الحرب على قطاع غزة هشاشة المواطنة الممنوحة إلى الفلسطينيّين في إسرائيل، وخضوعها التامّ إلى الدوافع والحاجات الأمنيّة وحاجات الإجماع الصهيونيّ وشروطه، كما أن الحرب أفضت، ولا تزال تفضي، من خلال المبادرة إلى محاولة سنّ قوانين جديدة ما زالت في طور التشريع (وسوف تقتضي أن نتوقف عندها لدى إقرارها بصورة نهائيّة)، إلى محاولة محو هامش سياسيّ أتيح للفلسطينيين في إسرائيل لممارسة أبسط حقوقهم المدنيّة، وإلى محاولة فرض حدود جديدة للتعبير والعمل السياسيّ والحزبيّ.
أمّا الدلالة الثانية، فهي تتعلّق بالتحليل القانوني لسياسات القمع والفصل العنصري. وهنا يتعيّن التذكير بأن الحرب على قطاع غزة شنتها إسرائيل بعد نحو عامين ونصف العام مما وصف بأنه "أحداث أيار/مايو 2021"، التي تحمل فلسطينيًا اسم "هبّة الكرامة" (اندلعت الهبّة على خلفية عمليات إسرائيلية تهدف إلى إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جرّاح في القدس، فقد عايش الشباب الفلسطيني الاحتجاج ضد إخلاء السكان الفلسطينيين، ونالهم من قمع الشرطة هناك واستفزاز المستوطنين ما نالهم. وساهمت مشاركة فلسطينيي الداخل في احتجاج حي الشيخ جرّاح وتصاعد هذه المشاركة وانكشافهم للقمع الإسرائيلي للاحتجاجات، سواء أكانت احتجاجات فلسطينية أم يهودية ضد إخلاء السكان، في زيادة الاهتمام والانتماء لهذه القضية في صفوف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وبدأت قضية الشيخ جرّاح تأخذ اهتمامًا متزايدًا في صفوف الفلسطينيين في الداخل بموازاة ربطها مع مسألة السيطرة على بيوتهم في المدن الساحلية حيفا ويافا وعكا، وفي اللد والرملة).
ويظهر هذا التحليل القانوني، الذي أجراه خبراء عدّة في المجال، وجود نظامين مختلفين لتنفيذ القانون وتطبيقه؛ واحد للعرب الفلسطينيين، وآخر لليهود، ومن ضمن ذلك كيفية تعامل الشرطة والنيابة العامة، ومعالجة الملفات من جانب المحاكم والأحكام القاسية التي أصدرتها وغيرها. وظهر ذلك عقب التوقف عند وسائل الرقابة والملاحقة التي تم استخدامها خلال الهبة، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي، أو في الحيّز العام، وقمع الحق في الاحتجاج وحرية التعبير. وكل هذا تردّد صداه بقوّة أكبر وأخطر في فترة الحرب على قطاع غزة. ويُشار في هذا السياق إلى أنه عند التعمّق في بنود لوائح الاتهام التي جرى تقديمها ضد الفلسطينيين في أراضي 1948، والمرتبطة بمشاركتهم في "هبّة الكرامة"، يتّبيّن أنّ النيابة الإسرائيلية العامة شكّلت ذراعًا أخرى لإحكام القبضة على الفلسطينيين في الداخل، حيث تعاملت معهم بكونهم "العدو من الداخل" الذي قام بفتح جبهة إضافيّة ضد الدولة في أثناء خوضها الحرب مع "العدو من الخارج"، وفقًا لتوصيف جرى استخدامه من جانبها.
ارتباطًا بهذا السياق للأحداث، وبغية تسليط الضوء على دلالة ثالثة، يقوم "مركز أكورد" (هو، كما يكتب على موقعه، منظمة اجتماعية أكاديمية تعمل على تطوير وإتاحة المعرفة الأكاديمية المبتكرة في علم النفس الاجتماعي، من أجل تعزيز علاقات المساواة والتسامح والاحترام بين مختلف الفئات الاجتماعية في إسرائيل، وكذلك بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات المجاورة في المنطقة) منذ العام 2021، وكل بضعة أشهر، بمراقبة "مستويات الكراهية وانعدام الثقة بين المجموعتين، اليهودية والفلسطينية". وبحسب المركز، كشفت البيانات بعد الحرب على غزة، عن زيادة كبيرة جدًا في كراهية اليهود تجاه الفلسطينيين: قبل الحرب، كان مستوى الكراهية تجاه الفلسطينيين يبلغ 2.5 (على مقياس من 1 إلى 6)، بينما يبلغ هذا الرقم بعد الحرب أعلى من 4. ويشير إلى معطيين آخرين مثيرين: الأول، ارتفاع درجة تأييد اليهود للعنف ضد الفلسطينيين من 1.37 في آذار/مارس 2023 إلى 1.89 في تشرين الأول/أكتوبر 2023 (في المقابل، انخفض خلال هذه الفترة دعم الفلسطينيين للعنف ضد اليهود)؛ الثاني، قفزت درجة تأييد اليهود للخطاب العدواني ضد الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي من 1.5 إلى 2.25، على المقياس نفسه، خلال هذه الفترة (شهد هذا التوجه، أيضًا، انخفاضًا في الدعم من الفلسطينيين). ويقول القيمون على المركز، إن معنى هذه المعطيات هو "التطبيع أو التفهم أو التسامح مع عنف اليهود تجاه الفلسطينيين في إسرائيل".
كما يشير هؤلاء إلى أن كثيرين من الجمهور الفلسطينيّ "يعيشون شعورًا بالعجز شبه الكامل. ويقولون لأنفسهم: في مواجهة مثل هذا التطرّف الكبير للمجتمع اليهودي، والاضطهاد في أماكن العمل والجامعات، من الذي سيحمينا؟ شرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؟". هذه تجربة لديها، أيضًا، الكثير من إمكانيات التفجر. كذلك، فإن مئات آلاف الأشخاص ممنوعون من التعبير عن مشاعرهم الأساسية: يجب على الفلسطينيين في إسرائيل ألا يقولوا إنهم ضد قتل أو معاناة الأطفال أو الأبرياء في قطاع غزة. وهذه تجربة صعبة ستكون لها عواقبها على العلاقات بين اليهود والفلسطينيين.
ويعتبر "مركز أكورد" إحدى الجهات الإسرائيلية التي أشارت إلى الأجواء السائدة في إسرائيل حيال الفلسطينيين في الداخل إبان الحرب. وإضافة إليها، حازت هذه الأجواء على اهتمام "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب (INSS)، الذي أظهرت استطلاعات أجراها في صفوف الفلسطينيين أن 57 بالمائة من المستطلعة آراؤهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، و67 بالمائة من هؤلاء في كانون الأول/ديسمبر 2023، يفترضون أن "الدولة تنتهك حقهم في التعبير تحت ستار الحرب". كما كشف استطلاع آخر أن نحو 50 بالمائة من الفلسطينيين يفضلون الامتناع عن التعبير عن آرائهم بشأن الحرب، وإبداء تعاطُفهم، علنًا، مع الفلسطينيين في قطاع غزة، خوفًا من العقوبات.
وفي ضوء هذه المعطيات قدّم هذا المعهد عددًا من التوصيات التي من شأن قراءتها أن توضّح جوهر السلوك العام الذي لجأت إليه إسرائيل حيال الفلسطينيين في أراضي 1948.
في أولى هذه التوصيات، يقرّ المعهد الإسرائيلي لأبحاث الأمن القومي بأنّ الحق في التعبير هو أساس النظام الديمقراطي، على الرغم من إقراره في الوقت عينه بأن هذا الحق ليس مطلقًا، وبخاصة في أوقات الطوارئ، إذ يمكن فرض قيود على هذا الحق، وبصورة خاصة في مجال منع التحريض وتشجيع "الإرهاب"، من أجل "الحفاظ على أمن الدولة". إلا إن هناك، بين هذه الضرورات القاطعة، درجات كثيرة من النشاطات التي يجب السماح بإقامتها، ديمقراطيًا. وهناك حاجة، أيضًا، إلى فرض القيود على حرية التعبير بصورة قائمة على المساواة، والامتناع عن الإفراط في إنفاذ القانون، وهو ما يؤدي إلى إجراء تحقيقات جنائية واعتقالات من شأنها أن تؤدي إلى إحباط، وإلى اندلاع الاحتجاجات. وفي هذا الصدد يتعيّن على جهات إنفاذ القانون أن تكون مهنية، وأن تتعامل مع كل قضية بصورة منفردة. كما يجب السماح بالتجمهرات القانونية، بصورة تناسبية، لا تتضارب مع حالة الطوارئ القائمة.
وورد في توصية أخرى أنه يتعيّن على "سلطات الدولة التعامل مع المجتمع الفلسطيني لا بصفته عدوًا داخليًا" كما أنّ "الانتهاكات المحتملة للنظام العام، تتطلب استجابة شرطية مدنية".
وقيل في توصية ثالثة إنه يجب أن يؤخذ في الحسبان، أيضًا، في ظل الأجواء المتوترة أن تقوم عناصر من اليمين الصهيوني المتطرف، ذات التوجه المعادي للفلسطينيين بوضوح، بتنفيذ القانون بنفسها، ومواجهة مجموعات فلسطينية بادّعاءات حماية اليهود. وأشير على نحو خاص إلى أن التسلح الواسع خلال الأشهر الأخيرة، قد يغذي العنف بين اليهود والفلسطينيين. وبرأي المعهد، يتمثل دور الشرطة وجهات إنفاذ القانون، في هذا الصدد، في كبح من تصفهم بأنهم "فئات متطرفة" من الجانبين، والحؤول بينها وبين "جرّ المجتمع إلى أعمال شغب".
إجمالًا بالوسع ملاحظة جزئيتين في كل ما يخص تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في أراضي 1948 إبان الحرب على غزة:
الأولى، جزئيّة النظرة الإسرائيلية العامة حيالهم، التي لا تنفك ترى فيهم بمثابة عدو داخلي وطابور خامس ومثار قلق إستراتيجي، ما يستلزم استمرار التعامل معهم بمقاربة أمنية فقط.
والجزئية الثانية، هي التنائي عن الاستثمار في التربية على مناهضة العنصرية حيال الفلسطينيين والعرب عمومًا، كما تثبت ذلك التقارير الإسرائيلية الرسمية على نحو دوري، بما يخدم تكريسها ضدهم كجنس بشري أدنى، غير مستحق لأي حقوق جماعية. وبموجب ما يقرّ به حتى عدد كبير من الباحثين الإسرائيليين، فمن الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن المؤشرات إلى تغلغل فكرة دمج فلسطينيي الداخل في الاقتصاد الإسرائيلي داخل صفوف جهات مسؤولة كثيرة، بمن فيها بعض صناع القرار، من شأنها أن تنطوي على مؤشر على استبطان فكرة استحقاقهم حقوقًا جماعية.
ولا شك في أن أحد أبرز الأمور التي برهنت عليها الحرب، لدى قراءة تداعياتها من وجهة نظر إسرائيلية، أن الفلسطينيين في الداخل ما زالوا في مهداف سياسة القمع والاستعلاء والاستعداء الإسرائيلية. ولا يجوز القول بأي حال إنها هي من أعادتهم إلى هذا المهداف، لأنهم لم يغادروه أصلًا حتى في ذروة التعبير عن "لهاث" إسرائيل وراء دمجهم اقتصاديًا ومن ثم سياسيًا، مع وجوب ملاحظة أن محاولات هذا الدمج الأخير، كما تبدّت في الآونة الأخيرة، لم تغادر غايتها الأداتية الصرف، وبالتأكيد لن تغادرها برسم الحرب الأخيرة.
(2)
تنشط بين الفلسطينيين في أراضي 1948 ثلاث قوى سياسية رئيسية هي: الحزب الشيوعي الإسرائيلي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة – الحزب السياسي للجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي.
ووفقًا لمتابعة دقيقة أجراها مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقية، تمثلّت أبرز مواقف الحزب الشيوعيّ والجبهة من استمرار حرب الإبادة في ما يلي: معارضة الحرب؛ رفض واستنكار قتل المدنيّين من الجانبَيْن الفلسطينيّ والإسرائيليّ؛ المطالَبة بإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين ضمن صفقة تبادل؛ التصدّي للفاشيّة؛ التصدّي لسياسة الإخراس والملاحَقة للفلسطينيّين في الداخل؛ تحميل حكومة اليمين [حكومة بنيامين نتنياهو السادسة) مسؤوليّة الأحداث من دون التركيز على الإجماع الإسرائيليّ القائم الداعم للسياسات الحكوميّة، بما يشمل أحزاب المعارضة؛ التشديد على أهمّيّة وتعزيز العمل والنضال اليهوديّ العربيّ. في واقع الأمر، هذه المواقف لم تخرق الإطارَ المعهود والتقليديّ في سياسات الحزب الشيوعيّ الإسرائيلي والجبهة، بل أكّدت على برامج الحزب التاريخيّة، من دون تعامل مع التغيُّرات العميقة التي جاءت بها عملية طوفان الأقصى والحرب على غزّة. ومن هذه التغيُّرات، إعادة تعريف الإجماع الصهيونيّ وأهداف الدولة، ومواقف أحزاب المعارَضة ودَوْرها، وتجنُّد المجتمع الإسرائيليّ بغالبيّته ودعمه لحرب الإبادة في غزّة، وتفريغ المواطَنة الممنوحة للمواطنين الفلسطينيين من مضمونها السياسيّ والقانونيّ.
أما القائمة العربيّة الموحَّدة، فاستمرت بعد 7 أكتوبر في نهجها السابق، الساعي إلى نيْل رضى واستحسان المجتمع الإسرائيليّ وأحزابه السياسيّة والرأي العامّ الإسرائيليّ (تجدر الإشارة إلى أن القائمة العربية الموحدة شاركت في الائتلاف الحكومي الذي أقيم في إسرائيل برئاسة نفتالي بينت، رئيس حزب "يمينا" اليميني، ويائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، الوسطي، الذي تأتّى عنه إقامة حكومة أطلقت على نفسها اسم "حكومة التغيير" التي استمرت ولايتها بين 13 حزيران/يونيو 2021 و29 كانون الأول/ديسمبر 2022). وأطلقت القائمة مواقف مقبولة على الإجماع الإسرائيليّ حول طوفان الأقصى، وحمّلت حركةَ حماس مسؤوليّة قتل مدنيّين إسرائيليّين. كذلك عارضت القائمة الحرب ودعت إلى حلّ سلميّ، وطالبت المجتمع العربيّ بالتحلّي بالمسؤوليّة المطلوبة في هذه الظروف الطارئة كي لا توفّر ذرائع للمتطرّفين في إسرائيل للانتقام من المجتمع العربيّ، من دون أن تتطرّق إلى سياسات المؤسَّسة الأَمنيّة تجاه المجتمع العربيّ، بل يمكن القول إنها استوعبتها وتعاملت معها بتفهُّم.
أمّا قراءة التجمُّع الوطنيّ الديمقراطيّ للمشهد الناجم عن الحرب على غزّة، فقد شخّصت الدلالات المركزيّة التالية: نحن حيال حرب إبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ في غزّة، تُنتِج مرحلة سياسيّة جديدة في ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة. وطوفان الأقصى والحرب على غزّة هما بمثابة فشل للإستراتيجيّة الإسرائيليّة إزاء القضيّة الفلسطينيّة، على الأقل في العَقدَيْن الأخيرَيْن. وفيما يتعلّق بالفلسطينيين في الداخل، رأى التجمّع أنّ سياسة كَمّ الأفواه، وملاحَقة المجتمع العربيّ الفلسطينيّ، وموجة التحريض، ستحمل إسقاطات على مكانة هؤلاء الفلسطينيين وعلى مضامين المواطَنة الممنوحة لهم. كما أنّ الحرب ستؤدّي إلى مراجَعة الأسئلة الجوهريّة المتعلّقة بمكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وفي قضيّة الاحتلال. وفقًا للتجمُّع، يبقى الأمر الأهم أن الحرب على غزّة أثبتت مرّة أخرى استحالةَ فصل قضايا المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل المعيشيّة والمدنيّة عن القضيّة الوطنيّة والقوميّة وعن مسألة إنهاء الاحتلال في أراضي 1967.
(3)
في الأسابيع الأخيرة، أطلق التجمّع الوطني الديمقراطي مبادرة جديدة لحوار وطني ومجتمعي شامل، يهدف إلى إعادة تنظيم عمل المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعمل مؤسساته السياسية.
ونبعت الحاجة إلى هذه المبادرة من ثلاثة أسباب مركزية:
أولًا، خطورة المرحلة التاريخية التي تواجه شعبنا وقضيّتنا الفلسطينية في إثر السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية القضاء على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافّة. هذه المحاولة تضعنا جميعًا أمام خطر جدّي وحقيقي يفرض على الجميع الدخول في حوار وطني شفاف ومسؤول، يرمي إلى فهم تحديّات المرحلة بداية، ومن ثمّ وضع إستراتيجيات وخطط بغية التصدّي لهذه التحديّات.
ثانيًا، حالة الانقسام المُزمن بين الفصيلين الأساسيين في قيادة شعبنا، إضافة إلى حالة الانقسام والتشرذم السياسي في الداخل، حيث أدتا إلى حالة مستعصية من العجز السياسي، وإلى فشل ذريع في التعامل مع أصعب تحدٍّ نمرّ به كشعب فلسطيني منذ النكبة العام 1948. على مستوى الداخل الفلسطيني، أدّى هذا العجز إلى غياب عنوان سياسي واضح وموحّد لمجتمعنا يستطيع أن يوفّر مخرجًا حقيقيًا، وأن يتصدّى للتحديّات كافة التي تفرضُها السياسات اليمينيّة المتطرّفة لحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير كسياسات كمّ الأفواه ومنع حرية التعبير، والتحريض اليومي المستمرّ، وسلسلة القوانين العنصرية الخطيرة، ومحاولات تجريم العمل السياسي الوطني وحصاره.
ثالثًا، حرب الإبادة في قطاع غزة كشفت، بشكل كبير، عن ازدواجية المعايير في الساحة الدولية، وعجز المنظومة الدولية عن منع جرائم الحرب والإبادة. كما كشفت هذه الحرب عن مستوى الانحدار السياسي والأخلاقي في المجتمع الإسرائيلي الذي دعم، في حالة من الإجماع، هذه الحرب وجرائمها، ولم يخرج منه تقريبًا أي صوت جدّي لتيار سياسي منظّم ضد الحرب وجرائمها باستثناء الأحزاب العربية طبعًا. كما كشفت حرب الإبادة أيضًا عن بقاء الفلسطينيين في الداخل وحدهم بدون ظهير عربي أو دولي أمام الكمّ الهائل من التحدّيات والسياسات العنصرية، وبدون أن يكون لهم تنظيم وعنوان سياسي قادر على التعامل مع هذه التحدّيات.
ويهدف الحوار إلى ما يلي: أولًا، صوغ ميثاق وتعاقد وطني جامع للعمل السياسي الجماعي في الداخل، على أن يأخذ الميثاق بعين الاعتبار التحوّلات في المجتمع والمؤسسة الإسرائيلية، وإسقاطات الحرب الحالية على المشهد السياسي. ثانيًا، صوغ إستراتيجيات عملية لكي تشكّل بوصلة لشعبنا ومجتمعنا كما تشكّل قوة فاعلة ووازنة قادرة على التعبئة والتنظيم السياسي والتوجيه والحماية. كما تكون قادرة على فرض موقف جماعي منسجم بوسعه أن يقيم سدًّا منيعًا ضدّ المحاولات كافّة الساعية إلى تشويه مجتمعنا ومحاصرتنا في وطننا.
وأعلن أصحاب المبادرة أنها لن تكون محصورة في نطاق التيارات السياسية الفاعلة فقط، وسيتم تقديمها ونقاشها والوصول من خلالها إلى أكبر عدد ممكن من جمعيات العمل الأهلي، وإلى الحركات الطلابية والشبابية، وإلى رؤساء السلطات المحلية وشخصيات مؤثّرة في مجتمعنا من المثقفين والإعلاميين. وكل ذلك بهدف أن تتحوّل هذه المبادرة إلى عقد سياسي اجتماعي شامل، يرسم القاسم المشترك الذي نستطيع الالتفاف حوله، وإعادة تنظيم العمل السياسي في الداخل من خلاله.
(4)
لا بُدّ من القول إنه منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000، التي شارك فيها الفلسطينيون في أراضي 48 في ما بات يُعرف لاحقًا باسم "هبّة أكتوبر 2000"، وقتل منهم خلالها 13 شابًا برصاص الشرطة الإسرائيلية، تبنّت إسرائيل إستراتيجيتين في سياق التعامل مع المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وكلتاهما تصبّان في مسعى تحقيق هدف واحد: تفكيك المشروع السياسي الجماعي للفلسطينيين في الداخل، الذي من شأنه أن يكون جامعًا لهم. وقد تمثلت الإستراتيجية الأولى في تجريم العمل السياسي، وملاحقة حركات وقيادات سياسية تشدّد في خطابها على تنظيم الجماهير الفلسطينية ذاتيًا. وشهد الحقل السياسي الفلسطيني، خلال العقد الأول بعد الانتفاضة الثانية، حملة حثيثة وكثيفة في ملاحقة حركات وقيادات سياسية، وحتى ملاحقة نشطاء سياسيين، وهي تعتبر بكيفية ما بمثابة إعادة بناء وتفعيل للملاحقة السياسية التي دأبت عليها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين منذ تأسيسها العام 1948، ولكن بطرق أكثر ذكاء. وكانت ذروة هذه العملية هي حظر الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، وإعلان أنها خارج القانون خلال العقد الثاني بعد الانتفاضة، وسبق ذلك إضعاف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من خلال ملاحقة مؤسسه وزعيمه الدكتور عزمي بشارة.
أما الإستراتيجية الثانية فهي مُركّبة جدًا. وتتمثل، بالأساس، في محاولة دمج الفلسطينيين كأفراد في المجتمع الإسرائيلي، ويمكن القول إن ما ساعد في ذلك هو التوجهات النيوليبرالية في الاقتصاد الإسرائيلي التي تبنتها الدولة بعد صعود اليمين إلى سدّة الحكم. وتعززت هذه التوجهات أكثر فأكثر بعد الانتفاضة، ولا سيما بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية ابتداء من العام 2009. ولم تكن هذه السياسات خاصة بالسكان العرب، بل كانت بمنزلة توجه عام في الدولة، فاليمين الإسرائيلي ينطلق من ناحية أيديولوجية من توجهات نيوليبرالية في الاقتصاد، يقف في صلبها انسحاب الدولة من الاقتصاد وتعميق الخصخصة، وإفساح المجال أمام قوانين السوق من أجل قيادة دفة الاقتصاد، فضلًا عن اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في العولمة. وضمن هذا التوجه العام عملت مؤسسات الدولة على إفساح المجال أمام دمج العرب في الاقتصاد الإسرائيلي كأفراد، إنما من دون تمكينهم من بناء اقتصاد عربي مستقل، حتى لو كان على نطاق محلي ضيّق. وفي واقع الأمر صرفت الدولة المليارات لدمج العرب في الاقتصاد، وتعتبر الخطة الاقتصادية الخمسية (الخطة 922) جزءًا من هذا التوجه. كما ينطلق هذا التوجه من أن الأدوات الاقتصادية النيوليبرالية تفكّك المجتمع إلى أفراد، وتضرب العمل السياسي الجماعي، وكان رهان الدولة هو على أسرلة المجتمع الفلسطيني، لا سيما أسرلة فئاته الشابة. وإلى حدّ ما، كان يبدو أن هذه السياسات ناجحة، وأنها استطاعت أن تخضع الفلسطينيين في إسرائيل سياسيًا.
ينبغي أن نضيف إلى ما تقدّم أمرين يتحتم أخذهما في الاعتبار بهذا الشأن:
أولًا. أن أداء معظم الأحزاب السياسية الناشطة بين الفلسطينيين في أراضي 1948 على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بإسرائيل منذ أعوام عدة، وتسببت بذهابها إلى جولات انتخابية عدة - هذا الأداء كان منطويًا على قدر من ملامح الأسرلة المذكورة إلى درجة تصاعد معها الشعور بأن العمل السياسي العربي في الداخل يمكن أن يكون عنصرًا مؤثرًا في حلبة السياسة الإسرائيلية؛ سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، والمقصود بهذا الصعيد الأخير هو سياسة إسرائيل الخارجية إقليميًا ودوليًا، وبخاصة سياستها إزاء قضية فلسطين.
ثانيًا. انتشار الجريمة والعنف في صفوف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، ما أدّى إلى إضعاف هذا المجتمع من الداخل.
في ضوء كل ما تقدّم ذكره، اعتبرت الهبّة من جانب فلسطينيي 1948 في أيار/مايو 2021 مفترقًا مهمًا آخر في مسيرتهم، وبالأساس إلى ناحيتين: الأولى، أنها كانت امتدادًا للمعركة من أجل قضية فلسطين التي بدأت في القدس وامتدت إلى قطاع غزة وشملت الضفة الغربية؛ والثانية أنها عزّزت رؤية الفلسطينيين من جانب إسرائيل، دولة وسكانًا، كجزء من العدو الفلسطيني.
وخلصت أغلبية الدراسات التي تناولت تلك الهبّة الشعبية إلى أنه ستكون لها تداعيات مستقبلية محتملة عديدة، نذكر منها ما يلي:
أولًا. من شأنها أن تعمّق الشرخ بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، حيث كشفت الأحداث التي شهدتها خلالها عن بنية عنصرية لدى قطاعات في المجتمع اليهودي، لم تسلّم، ويبدو أنها لن تسلّم، بفكرة أن العرب الفلسطينيين في إسرائيل لهم انتماء وطني، وهم جزء من الشعب الفلسطيني ومن قضيته.
ثانيًا. قد تؤدي الهبّة إلى ابتكار سياسات جديدة للمؤسسة الإسرائيلية الرسمية في محاولة لإخضاع المجتمع العربي، بحيث يكون الهدف الأساسيّ لهذه السياسة هو زرع حالة الخوف والردع لدى الشباب العربي مثلما فعلت بعد هبّة القدس والأقصى في تشرين الأول/أكتوبر 2000.
ثالثًا. قد تساهم الهبّة في إعادة التفكير في النهج السياسي للمجتمع الفلسطيني في الداخل، الذي صعد إلى سطح الأحداث في الآونة الأخيرة على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، والقصد هو النهج الذي ينطلق من فكرة التأثير عبر الاندماج في السياسة الإسرائيلية، عبر السعي إلى دخول حكومات أو التوصية على مرشحين، وتهميش الخطاب الوطني والمطالب الجمعية لمصلحة مطالب مدنيّة.
رابعًا. قد تؤدي الهبّة إلى تفكير المؤسسة الإسرائيلية من جديد بخطورة انتشار السلاح في المجتمع العربي، وانتشار الجريمة كأحد أسباب الإحباط الذي أدى إلى اندلاع هبّة الناس الشعبية.
خامسًا. ستساهم الهبّة في تعزيز الأدوات القمعية ضد الاحتجاجات الشعبية والسياسية المقبلة في المجتمع العربي، وفي مزيد من توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين في إسرائيل.
سادسًا. من المتوقع أن تساهم الهبّة في إعادة الاعتبار إلى الخطاب الوطني الفلسطيني، وفي العودة إلى خطاب الحقوق الجماعية الذي تراجع إلى درجة ملموسة في الأعوام الأخيرة.
(5)
واضح لكُثر أن ما يسعى إليه اليمين الإسرائيلي الحاكم الآن، الذي يوصف بحق بأنه "يمين إسرائيليّ جديد" (بخلاف اليمين الإسرائيلي التقليدي الذي تبنى فكر زئيف جابوتنسكي) هو تحقيق ثلاث غايات: 1. اقتصاد حرّ؛ 2. حوكمة؛ 3. تطرّف قومي. وهو سعي بدأ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009.
ومثل هذه الغاية هي ديدن نتنياهو وحزبه الليكود منذ أعوام طويلة، تحت غطاء تمجيد ما يسمى بـ "مبدأ الحوكمة"، وكأن مهمة الدولة الرئيسية هي الحكم، بأي ثمن ومهما يحصل، في حين أنه من بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة -السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية- يشكل القانون مهمة السلطتين الأولى والثانية، وليس الأمر صدفة أو عبثًا، فنظام القانون هو الذي ينظم إدارة الدولة، وهو الذي يسبغ الشرعية على أعمالها ونشاطاتها. ومثلما سبق لأحد أساتذة العلوم السياسية في إسرائيل أن أشار، فإن مصدر كلمة "شرعية" هو من كلمة (Lex) اللاتينية التي تعني "قانون"، في حين أن أولئك الذين يتحدثون باسم "مبدأ الحوكمة" يدّعون عمليًا أن السلطتين اللتين تحفظان نظام القانون يجب أن تكونا في خدمة السلطة الثالثة، التنفيذية، وهو مبدأ مشوّه، ويتكئ عليه أي نظام دكتاتوري. كما يدّعي هؤلاء أن المحكمة العليا تهيمن على الكنيست (البرلمان) واستولت على "إرادة الشعب".
فقط للتذكير: إن من يقود خطة إضعاف المنظومة القضائية أو الانقلاب القضائي هو وزير العدل الحالي ياريف ليفين (الليكود). وليفين نفسه كان حدّد في سياق مقابلة صحافية مطوّلة مع صحيفة "معاريف" في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أن غاية مثل هذه الحملة التشريعية تتمثل، بالأساس، في إصابة ثلاثة أهداف على المستوى الإسرائيلي الداخلي. وهذه الأهداف هي:
أولًا. المحكمة الإسرائيلية العليا التي وصفها ليفين بأنها "تيار يساري لنخبة ضئيلة من حي رحافيا الأشكنازي (في القدس الغربية) تتبنى جدول أعمال ما بعد صهيوني".
ثانيًا. وسائل الإعلام التي وصفها بأنها "تمارس حرية التشهيـر والتحقير".
ثالثًا. منظمات المجتمع المدني اليسارية، وأساسًا منظمات حقوق الإنسان، التي قال إنها "تلحق أضرارًا فادحة بالسيادة الإسرائيلية".
ومنذ ذلك العام، قيل تعقيبًا على هذا الوضع إنه: "تزداد يومًا بعد يوم الإشارات الميدانية التي تُظهر مفهومًا مدنيًا جديدًا لدى الإسرائيليين، فحواه أن الأفكار السياسية التي تتجاوز الإجماع (القومي) تشكل خطرًا، ومن يجرؤ على توجيه النقد إلى السلطة، يتم النظر إليه على أنه يشكل تهديدًا".
غالبية التحليلات الإسرائيلية المناهضة لخطة ليفين هذه أكدت، حتى قبل انطلاق حملة الاحتجاجات العاصفة عليها، أنها ستلحق أضرارًا بـ"الديمقراطية الإسرائيلية" (للسكان اليهود) وبحقوق الإنسان، وأنها ستحوّل إسرائيل من دولة ديمقراطية (كما يعتقدون ويدَّعون) إلى دولة أخرى ... وهناك استخدامات وصفية عديدة لهذه الدولة المتحولة: ديموكتاتورية؛ كلبتوقراطية (حكم الفاسدين)؛ كاكي-ستوقراطية (الحكم السيئ) ... وغيرها.
وإذا كان اليمين في إسرائيل يعتقد أن المحكمة العليا تعتدي على حقوق السلطتين التنفيذية والتشريعية المُنتخبتين، فهذا لا يعني، بأي حال، أنها كذلك في كل ما يتعلق بالقضايا التي تندرج تحت مُسمّى "الأمن".
آفاق نجاح الخطة العربية حول التعافي
المبكر وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة
هدير البرقوني
تقديم
تمثِّل إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار التحدي الأكبر لدى سكان القطاع، الذين لا يزالون يواجهون حرب الإبادة الإسرائيلية بحقهم على مدار عام ونصف، وقد قدَّمت مصر خطتها الخاصَّة بإعادة إعمار القطاع إلى القمة العربية الاستثنائية، التي عُقِدت في القاهرة في مطلع آذار/مارس الماضي، تحت شعار "قمَّة فلسطين"، لمناقشة وإقرار "خطَّة مصرية لإعادة إعمار غزَّة من دون تهجير سكَّانها"، في محاولة لصياغة موقف عربي موحَّد، ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان القطاع.[43]
تسعى ورقة العمل هذه إلى تقييم فرص نجاح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة. وتركز على محاور تشمل وصف حجم الأضرار والخسائر، وتحديد التحديات الحالية والمحتملة للخطة العربية، وتحليل مواقف الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين وأدوارهم. كما تسلِّط الورقة الضَّوء على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في قطاع غزة في عملية إعادة الإعمار. وتختتم الورقة بتقديم توصيات تناولت أهمية تبني نهج وحدوي يضمن مشاركة جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
ملخص لخسائر وأضرار قطاع غزة جراء الحرب الأخيرة
تشير تقديرات البنك الدولي[44] إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار، لا تشمل تكاليف توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لـ"إبقاء السكان على قيد الحياة" خلال السنوات المقبلة.[45]
- تقدَّر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بنحو 30 مليار دولار.
- كان قطاع الإسكان، إلى حد بعيد، أكثر القطاعات تضررًا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
- تقدَّر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
- تقدَّر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمُّل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
الخطة المصرية
تبنَّت القمة العربية الاستثنائية، التي عُقِدت في القاهرة في 4 آذار/مارس الماضي، خطةً أعدتها جمهورية مصر العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه،[46] إذ طرحت خطة قيمتها 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركِّز على الإغاثة الطارئة، وإعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى.
تستهدف الخطة إعادة إعمار القطاع بطريقة شاملة تجعله قادرًا على استيعاب 3 ملايين نسمة بحلول العام 2030، وتشمل مشاريع إعادة بناء المنازل المدمرة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير القطاع الصناعي والزراعي، وتحديث المؤسسات الصحية والتعليمية. واحتوت الخطة على جانب سياسي وأمني، وآخر خاص بالإعمار، في إطار حل نهائي للقضية الفلسطينية.
وتقترح الخطة "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاءة واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".
وتعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم للخطة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، بمشاركة الدول المانحة، والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي، ومنظمات المجتمع المدني.[47]
بموجب الخطة، ستدير غزة "لجنة تكنوقراط" استعدادًا لعودة السلطة الفلسطينية، وستُدرِّب مصر والأردن قوة شرطة، وستُنشر قوات حفظ سلام دولية في القطاع.
وفي اجتماع موسَّع للجنة الوزارية العربية الإسلامية[48] حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، على هامش "منتدى أنطاليا" الدبلوماسي في تركيا، الجمعة، تناول وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خطة إعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده في مصر، الذي سيركز على تنفيذ الخطة. واستعرض عبد العاطي رؤية مصر لسبل إنجاح المؤتمر وورش العمل المنبثقة عنه، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص، وآليات التمويل، فضلًا عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة، مؤكدًا دور مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة. ونوَّه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية في إطار الخطة، وأهمية تمكين لجنة إدارة شؤون غزة والحفاظ على الوحدة بين الضفة وغزة و"القدس الشرقية". وأكد الاجتماع أهمية مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في حزيران/يونيو القادم برئاسة مشتركة لفرنسا والسعودية، والعمل على خلق الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية". وأكد وزراء الخارجية العرب في الاجتماع دعم الخطة ومؤتمر إعادة الإعمار.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في 19 آذار/مارس الماضي، تشكيلَ مجموعة عمل عربية لمتابعة قرارات القمة الطارئة، بما في ذلك إنشاء صندوق إعادة الإعمار، وصندوق رعاية الأطفال مبتوري الأطراف والأيتام.[49]
مواقف القوى الفاعلة
الموقف الفلسطيني
رحبت حركة حماس بالخطة، ودعت إلى توفير جميع مقومات نجاحها.[50] كما رحبت السلطة الفلسطينية بها كذلك ودعت إلى تبنِّيها.[51]
المواقف العربية
تبنَّت الدول العربية المُشارِكة في القمَّة الخطةَ، فيما كان مستوى التمثيل العربي أقلَّ من المتوقَّع، إذ شهدت غياب عدد من قادة العرب المؤثّرين، وبخاصة زعماء السعودية والإمارات والجزائر، ما أدَّى إلى ظهور تفسيرات متناقضة[52] يربط معظمها هذا الغياب بنفقات إعادة الإعمار.[53]
الموقف الإسرائيلي
سارعت الخارجية الإسرائيلية إلى مهاجمة مخرجات القمة العربية، وعدَّت أن بيانها الختامي "لا يعكس الواقع بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأنه "يستند إلى مفاهيم قديمة"". وبرَّرت القراءاتُ الإسرائيليةُ رفضَ الخطةِ بانعدام واقعيتها، وخطورتها على "إسرائيل" من حيث إبقاء الغزيين في القطاع، والإبقاء على حماس في المشهد، وأن الخطة تكرِّس حل الدولتين،[54] وتدعو إلى تدويل الصراع، ما يعني إيلاء دور مركزي إلى الأمم المتحدة، وتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمطالبة بمحاسبة "إسرائيل" جرَّاء ارتكابها جرائم حرب.[55]
الموقف الأميركي
إلى جانب الأسلوب الأميركي العام في الاستفادة من الحروب التي تشعلها و"صعود رأسمالية الكوارث"، يتبنَّى دونالد ترامب أسلوب "سماسرة العقارات" الذي يتضح في ترويجه منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي مخططات امتلاك غزة، وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وتهجير سكانها، والعمل على إيجاد أماكن بديلة لهم. وعلى الرغم من أنه يعُدُّ "إسرائيل" دولة واقعة تحت الوصاية،[56] فإن ثمة عاملًا حاسمًا في الموقف الأميركي يتمثل بطبيعة وحجم الفائدة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة بإدارة ترامب من الخطة العربية. وقد صدرت تصريحات أميركية، بُعيد إعلان الخطة، تؤكِّد أن ترامب لا يزال متمسّكًا بمقترحاته السابقة، إلى جانب إصراره على "إعمار غزّة خاليةً من حماس"،[57] كان آخرها الاثنين الماضي، عقب اجتماع مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، إذ صرح ترامب: "سنسمِّي غزة "منطقة الحرية" (freedom zone) بعد نقل السكان منها، في إطار خططنا لتوفير حلول جديدة للنزاع".[58]
مع ذلك، كانت واشنطن أعطت موافقة مبدئية على الخطة، لكنها اشترطت موافقتها بإبعاد حماس عن السلطة في القطاع ونزع سلاحها.[59] وأكدت مصادر، قبل استئناف حرب الإبادة ضد القطاع، أن ثمة مناقشات تجري بين مسؤولين مصريين وأميركيين بشكل موسَّع حول الخطة، وأن الإدارة الأميركية طلبت الاطلاع المفصل على الأسماء التي ستدير غزة مستقبلًا، مع ضرورة إبعاد أية أسماء مرتبطة بحماس.[60]
المواقف الدولية المرحِّبة
شارك الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، في أعمال القمّة العربية في مطلع الشهر الماضي، وعبَّروا عن ترحيبهم ببيان القمة الختامي ودعمهم للخطّة العربية لإعمار غزّة.[61]
كما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمه للخطة. وقد وصل إلى القاهرة، في 7 نيسان/أبريل الجاري، في زيارة رسمية[62] لمدة 48 ساعة، لإجراء محادثات تتناول الخطة بشكل خاص،[63] في إطار ما وصفه بيان قصر الإليزيه بـ"مساعي الرئيس الفرنسي للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة". وفي ختام الزيارة، التي تضمن جدولها تفقُّد ماكرون إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستشفى العريش، ولقاء عدد من الجرحى الفلسطينيين، أكد الرئيسان رفضهما القاطع لأية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد ماكرون في خلال زيارته رفضه مشاركة حماس في حكم القطاع. وصرحَّ في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري: "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة (وينبغي) ألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل"، وتابع أنه يتطلع لحكم "فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية"، مجدِّدًا تأييده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة في مواجهة مقترح ترامب باستثمارات أميركية لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع إعادة توطين سكان القطاع في دول الجوار مثل مصر والأردن.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن الحل السياسي وحده كفيل بضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، مشيرًا إلى مؤتمر "حل الدولتين" في حزيران/يونيو المقبل، الذي قال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في خلاله، واضعًا ذلك في إطار تحرُّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بـ"إسرائيل".[64]
وفي قمة ثلاثية جمعت الرئيسين الفرنسي والمصري إلى جانب العاهل الأردني عبد الله الثاني في القاهرة، في 7 نيسان/أبريل، أجرى القادة الثلاثة مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، ناقشوا فيها التطورات في غزة، في اليوم ذاته الذي استقبل فيه ترامب رئيسَ وزراء الاحتلال في البيت الأبيض. وكان القادة الثلاثة قد شددوا في بيان مشترك على أن "السلطة الفلسطينية الممكَّنة"، يجب أن تتولى حصرًا مسؤولية الحكم في غزة بعد وقف إطلاق النار، وأن "الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة"، داعين إلى "عودة فورية" لوقف إطلاق النار.
إيجابيات الخطة:
- تقديم رؤية تجيب عن سؤال "اليوم التالي" للحرب في غزة.
- رفض فكرة التهجير، وتقديم بديل عملي لمخطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورؤية لإعادة الإعمار والشعب الفلسطيني على أرضه.
- وجود شبه إجماع عربي على هذه الخطة.
- تعامل الخطة مع موقف حماس، وتأكيد أن انتهاء جميع أعمال المقاومة متعلق بالتوصل إلى اتفاق الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
- ربط تنفيذ الخطة بمسار سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والحفاظ على الحق الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
- ربط الحل في قطاع غزة بالوضع في الضفة الغربية والقدس.
- تأكيد مركزية السلطة الفلسطينية، عبر إصلاح وتطوير مؤسساتها وأجهزتها، وإشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله على مرحلة انتقالية في قطاع غزة تديرها لجنة إدارية من التكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
- اتساع حجم الدول والمؤسسات التي من المفترض أن تشارك في إعادة الإعمار.
التحديات الحالية والمحتملة:
- استئناف دولة الاحتلال حربَ الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتعنت الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب حتى اللحظة، وبخاصة في ظل ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي الأكثر تطرفًا.
- ضعف الإرادة السياسية العربية اللازمة لتنفيذ الخطة، والحديث عن عجز مالي عربي بشأن تمويلها.
- لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التمويل المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة سيتوفر قريبًا.[65] وقد عرقلت قضايا التمويل إعادة الإعمار في المراحل ما بعد الحروب الإسرائيلية السابقة ضد القطاع.[66]
- تراجع دور المجتمع المدني في قطاع غزة فيما يتعلق بترتيبات إعادة إعمار القطاع، ونقص التواصل بين المجتمع المدني في قطاع غزة والكيانات القائمة على وضع الخطة وتنفيذها، وتهميش مجتمعات قطاع غزة المحلية فيما يتعلق بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار، ما يجعل عملية إعادة الإعمار غير شاملة، ويضع مصير المجتمع الغزي في أيدٍ لا يمتلك أصحابها دراية كافية بطبيعة هذا المجتمع.
التوصيات
ضرورة تبنِّي نهج وطني وحدوي فلسطينيًا: ضرورة العمل على إحياء الوحدة الوطنية، وتحييد ملف إعادة الإعمار عن الانقسامات السياسية، ما يتطلَّب حوارًا وطنيًا جادًا وخلَّاقًا، ينطلق من أرضية أنَّ "إسرائيل" المسؤولة عن الوضع الراهن، وأن مواجهتها تتطلب وحدة الصف الفلسطيني".[67] وإذا كانت الوحدة الكاملة متعذرة على المدى المباشر، فيمكن الشروع في أشكال من الوحدة الميدانية وتوسيع القائم منها.[68]
الضغط العربي والدولي من أجل إلزام الاحتلال بوقف الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة: يتوجب الآن تكثيف الجهود العربية والدولية، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، تمهيدًا لوقف تام لإطلاق النار، ثم العمل على توفير ضمانات للحفاظ على وقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، يتضمن ذلك الضغط لإدخال مواد البناء الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار.
تمتلك الدول العربية أوراق ضغط كثيرة، وبخاصة السعودية في ظل الاتفاقيات المتوقَّعة مع كل مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وعلى الدول أن تمتلك ما يكفي من الإرادة لاتخاذ موقف عربي موحَّد وحاسم لدعم الخطة العربية وتنفيذها، ومواجهة الإدارة الأميركية بأن هذا الموقف غير قابل للمساومة، يقتضي هذا بالحد الأدنى موقفًا ممانعًا، يربط بين وقف حرب الإبادة والانسحاب التام من قطاع غزة، والالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ وبين إعادة الإعمار.[69]
تأمين التمويل لإعادة الإعمار: يتطلب تأمين التمويل عقدَ المؤتمر المخصص لحشد الدعم اللازم للخطة، ويقتضي ذلك توفر الإرادة السياسية العربية الكاملة وتوفر الدعم الدولي، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة.
إشراك المجتمع المحلي والمدني في قطاع غزة وتعزيز الرقابة والمساءلة: وضع آليات عملية لإشراك المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والنخب الشبابية في قطاع غزة في إعادة الإعمار، وتسمح للمجتمع المحلي في القطاع بالمشاركة الفاعلة في العملية. وتكليف تلك المؤسسات بإنشاء هيئة متعددة الأطراف وآليات رقابة فعَّالة،[70] وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحرص على أخذ احتياجات السكان في قطاع غزة في الحسبان.
خطة وطنية إستراتيجية وتنموية شاملة: لا يمكن أن يقتصر التعافي في قطاع غزة على إعادة الإعمار، بل يجب أن يترافق مع سياسات إستراتيجية وتنموية شاملة، تأخذ الدروس من التجارب السابقة، وتأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن تحقيق تنمية مستدامة، وتهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، وضمان الوصول إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.[71]
خاتمة
بينما أثار استئناف "إسرائيل" حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تساؤلاتٍ حول مصير المشاورات بشأن خطة إعادة إعمار القطاع، فإن محاولات الترويج للخطة لا تزال مستمرة.
لقد قُدِّمت الخطة المصرية بوصفها وثيقة تدل على إمكانية إيجاد بديل في مواجهة الضغوط الأميركية الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيِّين من قطاع غزة، ودون وحدة وطنية فلسطينية وسياسات إستراتيجية شاملة، ودون إرادة عربية كاملة تضغط في اتجاه موافقة الولايات المتحدة على الخطة العربية لإعادة الإعمار ودعمها، فإن الخطة ستبقى حبرًا على ورق.
إن تطبيق خطة إعادة الإعمار المصرية، المتبناة عربيًا، يجب أن يُمنَح الأولوية في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وأن تكون الخطة مدخلًا جديدًا لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء أية عملية تسوية. ومن شأن آلية عمل جادة تعطي المجتمع المدني والنخب الشبابية والنسوية في قطاع غزة دورًا أقوى في عملية إعادة الإعمار، أن تكون بمثابة عامل أساسي في تفعيل أدوارهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية نحو النهوض بالحالة الفلسطينية الراهنة، بما يتجاوز الآفاق الضيقة التي خلقها الاحتلال وعزَّزها الانقسام الفلسطيني.
إطار مقترح لحوار فلسطيني إقليمي دولي لتوسيع
مساحات التوافق والفعل الداعم للحقوق الفلسطينية
إبراهيم فريحات[72]
على الرغم من التحول الكبير في الرأي العام العالمي، وبخاصة داخل الولايات المتحدة الأميركية لصالح الحقوق الفلسطينية في الأعوام القليلة الماضية، فإن هذا التحول لم تصاحبه إستراتيجية وطنية فلسطينية للاستفادة من هذا الزخم للدفع بالحقوق الفلسطينية إلى الأمام. فقد أظهر آخر استطلاع رأي من قبل مؤسسة جالوب أوائل العام 2025، أن نسبة التعاطف مع الفلسطينيين لدى أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 59% مقابل 21% فقط لصالح الإسرائيليين، في حين كانت النسبة لدى الحزب نفسه العام 2023 هي فقط 38% لصالح الفلسطينيين مقابل 40% لصالح الإسرائيليين.[73]
بقيت التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية مقتصرة على محاولات عشوائية غير منظمة وغير مرتبطة بإستراتيجية وطنية متكاملة، تعمل على التواصل مع هذا التأييد الكامن لتفعيله باتجاه التأثير على صناعة القرار السياسي؛ سواء في الولايات المتحدة أو غيرها. كما يلاحظ أن نسبة المبادرات الداعمة للحقوق الفلسطينية من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية، واتحادات الطلبة مثلًا، تفوق بأضعاف مما هو عليه الحال من قبل الفلسطينيين أنفسهم.
من الضروري التذكير بأن أشكال النضال الوطني قد تطورت في العقود الأخيرة، بحيث لم يعد النضال التحرري مقتصرًا على الشعار والحجر والاعتصامات والإضرابات، ليأخذ أشكالًا كثيرة لا تقل أهمية عن الأساليب التقليدية؛ مثل العمل من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي، والإعلام الرسمي، والجوانب القانونية والاقتصادية وغيرها. كما تطورت ساحات النضال الوطني، بحيث لم تعد مقتصرة على المخيم والقرية والمدينة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء الفلسطيني، بل توسعت ساحات النضال لتصل إلى الجامعات الأميركية المرموقة؛[74] مثل كولومبيا، وهارفارد، وكاليفورنيا، والمحاكم الأميركية،[75] وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية؛ مثل "هيومن رايتش واتش"، و"أمنستي إنترناشيونال" التي أصبحت تقاريرها حول وجود نظام إسرائيلي للأبارتهايد في فلسطين أكثر تأثيرًا من تصويت دول رسمية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.[76]
وعليه، فإن تطور ساحات النضال وأشكاله، إضافة إلى التعاطف الدولي مع الحقوق الفلسطينية، يتيحان مساحة عمل شاسعة للفلسطينيين للتفاعل معها، والتقدم باتجاه تحقيق المصير للشعب الفلسطيني. وللتذكير هنا، فإن تفكيك نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا قد جاء ليس بفعل النضال الوطني على أرض جنوب أفريقيا فحسب، ولكن، أيضًا، بفعل حركة التضامن الدولي التي كان لها دور محوري في نزع الشرعية عن نظام الأبارتهايد ثم تفكيكه. الفلسطينيون مدعوون اليوم للعمل على ثلاث ساحات رئيسية: الداخلية، والإقليمية، والدولية، للاستفادة من التحولات في الرأي العام العالمي، والتقدم باتجاه تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني:
أولًا. المستوى الداخلي: من المهم جدًا فهم العلاقة التي تربط المستوى الداخلي بالمستويات الإقليمية والدولية؛ إذ يضطلع بالداخل صياغة رؤية وطنية واضحة، وأخذ دور القيادة في النضال الوطني حتى يتم تعزيزه بالمستويات الأخرى، وهذه معادلة لا يبدو أن المستوى الرسمي الفلسطيني في العقود الأخيرة قد فهمها أو عمل بها؛ إذ ينظر، بالعادة، إلى أن الحلول تأتي من الخارج (دولي وإقليمي)، وهذا فهم خاطئ لما يمكن أن تقدمه الأطراف الدولية، ولذا ما انفكت القيادة الفلسطينية عن مطالبة الأطراف الدولية بفرض حلول على إسرائيل في الكثير من خطاباتها. على العكس من ذلك، فإن نقطة البداية تكمن في بلورة رؤية واضحة لمشروع وطني نضالي يأخذ الفلسطينيون الدور القيادي فيه، ثم تدعمه الأطراف الدولية والإقليمية، وليس العكس، وإذا لم تضطلع القيادة الفلسطينية بدورها في أخذ دفة القيادة، فلن يكون هناك دعم دولي كافٍ، فالخارج لا يقود، وإنما يدعم. وعليه، فالمتوقع من الداخل الفلسطيني للاضطلاع بدوره القيادي العمل على ثلاثة محاور:
- صياغة رؤية وبرنامج سياسي فلسطيني يتناسب مع المرحلة الحالية، وتتوافق عليه الأطراف الفلسطينية الفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني. هناك طرفان رئيسيان، أحدهما يتبنى العمل المسلح وبدون شرعية على الساحة الدولية، وآخر يتبنى المفاوضات بلا نهاية ودون شرعية داخلية. هذه الثنائية يجب كسرها ببرنامج سياسي يتفق على الحدود الدنيا فيها للعمل الوطني، بحيث يكتسب شرعتين داخلية وخارجية، وهذا ممكن جدًا، وذلك حتى تستطيع الأطراف الدولية دعمه.
- المصالحة الداخلية: أعفى الانقسام الفلسطيني الكثير من الدول، وبخاصة العربية، من القيام بدورها تجاه القضية الفلسطينية، على اعتبار أن "الفلسطينيين أنفسهم غير متحدين". وبما أن إنهاء الانقسام الفلسطيني أصبح حلمًا بعيد المنال، فهناك حدود دنيا يمكن الاتفاق عليها متمثلة في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، أو -على الأقل- تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة على غرار الانتفاضة الأولى، وبدون ذلك ستتحول الساحة الفلسطينية إلى "بورصة سياسية" لاستثمارات سياسية إقليمية ودولية خادمة لمصالحها، وليس لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يلوم الفلسطينيون إلا أنفسهم بهذه الحالة، وليس الأطراف المستثمرة بالبورصة السياسية الفلسطينية، إذ أنهم هم من فتحوا هذه البورصة للاستثمار.
- إستراتيجية صمود فلسطينية اقتصادية بجوهرها لتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم، ومقاومة مشاريع الاستيطان والتهجير. وهناك الكثير مما يمكن فعله هنا لتعزيز الصمود الاقتصادي.
ثانيًا. المستوى الإقليمي: لم ينخفض الدعم العربي للقضية الفلسطينية تاريخيًا كما هو الحال اليوم، وذلك لأسباب متعددة، منها ما هو خاص بالوضع العربي نفسه؛ مثل حالة الاستقطاب الإقليمي، والثورات العربية الداخلية، ومنها، أيضًا، ما هو مسؤول عنه الطرف الفلسطيني نفسه، حيث سمح بأن يكون جزءًا من حالة الاستقطاب العربي. ولذا، فإن العمل الفلسطيني على الساحة الإقليمية يتطلب ما يلي:
- النأي عن حالة الاستقطاب العربي بأشكالها كافة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية العربية أيًا كان الوضع السياسي فيها. لقد حافظت القضية الفلسطينية، تاريخيًا، وبحكم شرعيتها وعدالتها، على كونها عاملًا موحدًا للعرب الذين قد يختلفون على سوريا واليمن وليبيا مثلًا، ولكنهم يتوحدون حول فلسطين. ومن المهم التأكيد، هنا، على ضرورة احترام الفلسطينيين الأولويات الوطنية العربية، وعدم تقديم المصلحة الفلسطينية على أولويات الدول، بل لإيجاد طريقة من خلال الحوار للمواءمة والتعايش بين هذه الأولويات، حيث لا تؤثر الأولوية الوطنية على القضية الفلسطينية. وبلغة أخرى، أصبح من المستبعد على الكثير من الأنظمة العربية، قبول المنطق الذي حكم العلاقة بين الفلسطينيين والعرب بما يعبر عنه بفلسطين دومًا "قضية العرب الأولى"، ومن الضروري للفلسطينيين التخلي عن هذا المنطق في حوارهم مع العرب، حيث إن للعرب، أيضًا، أولوياتهم هم، التي لا تتعارض، بالضرورة، مع مركزية قضية فلسطين بالنسبة لهم. وبلغة أخرى، القضية الفلسطينية هي مركزية بالنسبة للكثير من العرب، ولكنها ليست "القضية الأولى".
- تعزيز الشراكات العربية الرسمية من خلال تنسيق المواقف مع القوى العربية المؤثرة، وبخاصة خلال فترة حكم الرئيس ترامب للسنوات الأربع القادمة. وفي هذا المضمار، يجدر التأكيد على ضرورة قيام الفلسطينيين بالتنسيق القريب والمتواصل والمكثف مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لما لها من دور مؤثر في سياسات الإدارة الأميركية الحالية. كذلك التنسيق مع الدول التي تقوي الموقف الفلسطيني، وبخاصة مصر والجزائر والمغرب والعراق وقطر، فلكل من هذه الدول زاوية محددة يمكن لها أن تقوي الموقف الفلسطيني (الجزائر)، ومؤثر في قرارات الإدارة الأميركية (مصر، والمغرب، والعراق، وقطر).
- تنسيق على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية ومثقفيها وأكاديمييها والقوى والاتحادات المنضوية تحت إطارها (كتاب، طلاب، امرأة) مع القوى غير الرسمية، من خلال الحوار مع القوى المماثلة لها على الساحة العربية، على سبيل المثال لا الحصر: حوار أكاديمي سعودي-فلسطيني، حوار برلماني على مستوى المجلس المركزي لمنظمة التحرير مع برلمانات/مجالس شورى عربية. كذلك هناك مساحة للعمل لقوى منظمة التحرير للعمل مع قوميات/أقليات أخرى مثل حوار فلسطيني-كردي لمنع الاصطفاف مع مخططات إسرائيل الجديدة التي نادى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول تحالف إسرائيل مع الأقليات في المنطقة.
ثالثًا. المستوى الدولي: تاريخيًا، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وُجد التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية بدرجات عالية في ساحات مثل دول عدم الانحياز، والكتلة الشرقية، والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى القوى العربية والإسلامية. ولكن، تمدد هذا التأثير حديثًا وبدرجات غير مسبوقة إلى دول أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، وما يعني ذلك من تأثير في صناعة القرار الدولي على المستوى الرسمي كاعتراف دول مؤثرة بالسياسة الدولية مثل السويد وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا والنرويج، والمستوى الشعبي كما هو الحال تقريبًا في كل المجتمعات الأوروبية والأميركية.
لقد شكلت العقيدة السياسية سابقًا أساسًا للتأييد الدولي لفلسطين مثل الاشتراكية، وعدم الانحياز، والقومية العربية والإسلامية، ولكن يلاحظ، اليوم، أنه تم استبدال "العقيدة السياسية" كأساس لهذا الدعم، بـ"القيم الإنسانية" المتمثلة بالحرية والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، ... وغيرها من القيم الإنسانية. هذا الاستبدال يشكل دعمًا أكبر وقاعدة أوسع للقضية الفلسطينية، حيث يشترك، فقط، من يؤمنون بالعقائد السياسية كالاشتراكية، والقومية العربية، في دعم القضية الفلسطينية، ليتم استبدال ذلك بقيم إنسانية يشترك فيها المجتمع الإنساني، وكل من يؤمنون بقيمه ككل، وليس جماعات معينة ذات أفكار وعقائد سياسية مشتركة بينهما فقط.
للاستفادة من الحراك على الساحة الدولية، فمن المهم، أيضًا، إدراك التحولات التي أصابت النظام الدولي مؤخرًا، والتي تراجعت فيها الولايات المتحدة عن لعب دور القائد لنظام دولي قائم على تعزيز دور النظام الدولي، إلى الدولة الوطنية الساعية إلى تحقيق مصالح اقتصادية مدعومة بترسانة عسكرية هائلة. هذا يعني أن تحالفات دولية كثيرة آخذة بالتبلور، ومن أهمها، فيما يخص القضية الفلسطينية، التحالف الأوروبي الذي اتسعت الفجوة بين مواقفه السياسية وتلك الصادرة من واشنطن. هذا يخلق هامشًا لشراكة أوروبية-فلسطينية على المستوى السياسي أقوى مما كان عليه الحال عندما كان الموقف الأميركي مشكلًا للموقف الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية. بلغة أخرى، فالساسة الفلسطينيون بحاجة إلى التنسيق الأقوى مع بروكسل كحليف نسبي محتمل تختلف مواقفه لدرجة معقولة عن الموقف الأميركي. كذلك من الضروري الانتباه إلى وجود حالة من المخاض السياسي على الساحة الدولية لتشكل ما يمكن تسميته بـ"حلف المتضررين" من سياسة الإدارة الأميركية الترامبية، يمكن للفلسطينيين أن يجدوا لأنفسهم دورًا فيها.
صحيح أن "النظام الدولي" الجديد ما زال في طور التشكل، وقد يكون من الصعب التنبؤ باتجاهاته خلال السنوات الأربع القادمة للإدارة الترامبية في الحكم، لكن "المجتمع الدولي" قد حسم أمره، وفي أكثر من عاصمة غربية بتحالفه المبني على القيم الإنسانية مع الفلسطينيين، وما التظاهرات التي حشدت مئات الآلاف في شوارع واشنطن ولندن وباريس وبرلين إلا دليل على موقف المجتمع الدولي المناصر للحقوق الوطنية الفلسطينية. وآخذين بعين الاعتبار، بأن الأنظمة الديمقراطية في هذه الدول تسمح، وبهامش كبير، للرأي العام فيها بالتأثير في القرار السياسي، فإن لدى الفلسطينيين قوة هائلة في المجتمعات الغربية تحديدًا، للتواصل معها وتفعيلها باتجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل. فقد أظهر استطلاع رأي حديث في أوروبا أن 65% من الإيطاليين يدعمون وقف تجارة السلاح بين بلدهم وإسرائيل، في حين وصلت النسبة في بلجيكا إلى 62%، وفرنسا 51%، وألمانيا 49%، والسويد 50%.[77] مرة أخرى، هذه النسب لم تكن موجودة بحدودها الدنيا قبل أعوام قليلة في المجتمعات الغربية. ومن الضروري التذكير، في هذا المضمار، بالجامعات الأميركية التي قادت التظاهرات الدولية في العالم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية في غزة.
وعند الحديث عن "المجتمع الدولي"، فلا يمكن إغفال دور القانون الدولي والمنظمات الدولية ذات المصداقية العالية في تقاريرها حول الأوضاع الفلسطينية ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي هناك، والتي هي الأخرى بحاجة إلى تفعيل من خلال التنسيق المباشر معها، لمحاصرة السياسات العنصرية الإسرائيلية في فلسطين. هذه القوى هي الحليف الجديد والقوي للشعب الفلسطيني في المجتمع الدولي الذي يجب على القيادة الفلسطينية التعامل معه، وبناء حركة تضامن دولية على غرار جنوب أفريقيا.
وحتى لا نغرق في التوصيفات العامة للحل، فلا بد من الحديث عن الآليات التي يمكن للقيادة الفلسطينية استخدامها لتفعيل الطاقات الكامنة الداخلية والإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية:
أولًا. إنشاء خلية إدارة أزمة تشارك فيها قوى وطنية فلسطينية حزبية ونقابية ومثقفون وأكاديميون وصحافيون لمتابعة العمل على الساحتين العربية والدولية. الممثلون في هذه الخلية يجب أن تكون لديهم مهارات قيادية وفنية في السياسة والإعلام والمجتمع المدني، ولديهم الالتزام الواضح بالانخراط في العمل الوطني بشكل مكثف.
ثانيًا. تشكيل لجنة تنسيق عليا فلسطينية (بعض أعضاء خلية الأزمة) وعربية ودولية ممن لديهم القدرات والانتماء للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. مثل هذه اللجنة سيكون لها دور حيوي في التأثير بالنشاطات العفوية التي يتم تنظيمها في العديد من العواصم العالمية، وبخاصة كيف يمكن ترجمة هذه النشاطات للضغط على صانع القرار في العواصم الغربية لاستصدار قرارات سياسية لصالح الحقوق الفلسطينية.
ثالثًا. إطلاق منصة إعلامية دولية تكون عنوانًا إعلاميًا للنضال الفلسطيني المشروع، تضطلع بالتواصل والتنسيق مع المنصات الإعلامية الدولية المختلفة التي تناصر بمفردها الحقوق الوطنية الفلسطينية. يمكن لهذه المنصة الإرشاد حول قضايا متعددة، منها كشف حقيقة ما يجري على الأرض، ليس في قطاع غزة فحسب، ولكن، أيضًا، ما يجري في الضفة الغربية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وتوجيهية، أيضًا، حول الشركات والمؤسسات المرتبطة بالاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة وغزة، التي تتطلب مقاطعتها، وكذلك الاختراقات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، ... وغيرها. من المهم أن يكون هناك عنوان إعلامي فلسطيني، وهو ما تفتقده الساحة الدولية حاليًا.
رابعًا. إطلاق العديد من مبادرات الحوار مع الجهات العربية والدولية بهدف التأثير في الموقف الإقليمي والدولي، من خلال الحوار والانفتاح على الآخر، وعدم ترك الأمر للإعلام الموجه ليوصل الرسالة المضادة للحقوق الوطنية الفلسطينية. ولنتذكر أنه إذا ما ترك فراغ حول المعلومات، وحقيقة ما يجري ما لم تقم أنت بتعبئته، فإن غيرك سيقوم بذلك. من أهم وظائف الحوار أنه يطمئن الأطراف الأخرى المترددة أن دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يكون على حساب قضاياهم وأولوياتهم الوطنية، وأن المعادلة الصفرية لا تحكم موقفهم من القضية الفلسطينية. على سبيل المثال، فإن موقف أوكرانيا المخيب للآمال في الأمم المتحدة في الامتناع عن التصويت لصالح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا يخدم قضيتهم هم بالدرجة الأولى، وأن امتناعهم عن التصويت لإنهاء احتلال عسكري لأراضي الغير (الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حيث امتنعت أوكرانيا عن التصويت) ينفي عنهم صفة مقاومة احتلال أجنبي لأراضيهم، وهو ما تقوم عليه الرواية الأوكرانية.
أخيرًا، يمكن القول إن نجاح الخطوط العامة لإستراتيجية وطنية فلسطينية مؤثرة في الساحتين الإقليمية والدولية، يتطلب، بالدرجة الأولى، توفر الإرادة السياسية الفلسطينية لتبني مشروع سياسي مقاوم للاحتلال وفق ما يشرعه القانون الدولي، وأن هذه الإرادة السياسية تستند إلى توافق وطني يتجاوز تعدد العناوين الممثلة للشعب الفلسطيني.
الجلسة الثالثة
إدارة الجلسة: خليل شاهين
أبي العابودي: حق تقرير المصير الفلسطيني وتعزيز الصمود نداء الحرية والكرامة
تصور حول دور المجتمع المدني
حق تقرير المصير الفلسطيني وتعزيز الصمود
نداء الحرية والكرامة
أُبيّ العابودي
يواجه الشعب الفلسطيني تهديدات وجودية بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف اقتلاعه من أرضه عبر ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتوسع الاستيطاني والضم الزاحف الذي يغير ملامح المشهد الديموغرافي. ولم يقتصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى الضفة الغربية، حيث تشهد مدن مثل جنين وطولكرم هجمات متكررة تهدف إلى تفريغ مخيماتها والعديد من أحيائها من سكانها، وإعادة رسم خريطتها السكانية.
يحدث كل هذا في ظل انهيار العقد الاجتماعي ما بين المواطنين الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية، كما تم تجسيده في وثيقتي إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وسبق ذلك تفريغ الميثاق الوطني الفلسطيني من مضمونه، وفي ظل تقويض المكانة التمثيلية لهيئات منظمة التحرير ومؤسساتها، وتراجع أداء مؤسسات الحكم الفلسطينية، كافة، المحكومة أصلًا بسقف قيود اتفاق أوسلو وملحقاته الاقتصادية والأمنية والمدنية، وانتشار الفساد بأشكاله المختلفة، وأهمها الفساد السياسي، وتجويف مؤسسات الحكم ليصبح نظام الحكم الفلسطيني قائمًا على الرجل الواحد، وتعطيل الانتخابات العامة، والتداول السلمي للسلطة، وتغييب أسس الشراكة السياسية في المنظمة والسلطة، إضافة إلى التنصل من اتفاقات المصالحة كافة، وآخرها إعلان بكين، وتراجع قدرة حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة على الحكم نتيجة جرائم الاحتلال في القطاع.
في ظل هذه الظروف، يصبح تعزيز الصمود الفلسطيني السبيل الوحيد لحماية الوجود الفلسطيني، والتصدي لجرائم الإبادة، ومنع محاولات الضم والتهجير القسري، وتعزيز قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم بعيدًا عن فرض أي أشكال من الوصاية الخارجية، في سياق عملية تستهدف استنهاض الحالة الوطنية والجماهيرية الفلسطينية، وتفعيل حاضناتها العربية والعالمية، عبر حشد جهود وطاقات جميع مكونات المجتمع المدني، من قوى ومنظمات أهلية وشعبية، ونقابات، وحراكات مجتمعية ونسوية وشبابية، إضافة إلى القطاع الخاص، في معركة الدفاع عن الوجود والصمود على طريق توفير مقومات التحرر الوطني وتقرير المصير.
تركز هذه الوثيقة على تقديم مقاربة قوامها تعزيز دور المجتمع المدني في بناء مقومات الصمود الفلسطيني، ليس عبر تقديم رؤى نظرية أو طرح أفكار عامة فحسب، بل من خلال الوصول إلى حلول واقعية وملموسة للوضع الراهن. تهدف هذه الوثيقة إلى توفير رؤية قابلة للتنفيذ تساهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني، عبر تطوير نموذج سياسي بديل يعتمد على اللجان الشعبية، وتعزيز الحماية الدولية كوسيلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة الإعمار كجزء من إستراتيجية الاستقلال الاقتصادي، إضافة إلى ترسيخ اقتصاد التضامن الاجتماعي (التكافل الاجتماعي) كعامل أساسي يساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين من أراضيهم.
ويأتي تبني هذه الرؤية من المجتمع المدني الفلسطيني ضمن شقين؛ الأول سياسي يتضمن حماية حق تقرير المصير ومبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والشراكة السياسية، أما الشق الثاني فهو مجتمعي يضع تعزيز الصمود عنوانًا مركزيًا لعمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وقد جاءت هذه الرؤية نتيجة حوارات موسعة مع عدد كبير من الناشطين والناشطات الاجتماعيين والمؤسسات الأهلية (85 شخصية من الضفة) في الضفة الغربية، وتبقى بحاجة لإغناء وإضافة رؤى الفاعلين الفلسطينيين الآخرين من أماكن تواجد الفلسطينيين الأخرى.
ومن نافل القول إن هذه الوثيقة ستبقى مسودة قابلة للتعديل والإضافة والحذف حتى يتباها أوسع ائتلاف من المجتمع المدني الفلسطيني.
أولًا. الرؤية السياسية وحق تقرير المصير والعودة وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية
حق تقرير المصير هو حق تاريخي للشعب الفلسطيني، وقد تم إقراره وفق قرارات دولية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أصبح التجلي السياسي لهذا الحق وفق القانون الدولي بالتأكيد على إنهاء الاحتلال والاستيطان واعتراف 146 دولة بدولة فلسطين ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 (بما يمثل 75% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة)، وتصبح حماية هذا الحق وإعادة التوكيد عليه مهمة وطنية فلسطينية، في وجه محاولات الإلغاء وإبادة الوجود المادي والسياسي للفلسطينيين، أو إعادة فرض الوصاية عليهم. ومن نافل القول، أيضًا، التأكيد على أهمية حماية حق العودة في ظل محاولات تصفيته وإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
إلا أن حماية هذه الحقوق تتطلب، أيضًا، تعزيز عوامل القوة الفلسطينية الداخلية، وأهمها الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتعزيز الممارسات الديمقراطية بداخلها، ومن هنا يصبح التمسك بإنجاز المصالحة الوطنية وفق إعلان بكين، بما يتضمن من تشكيل قيادة وطنية موحدة، وحكومة وفاق وطني، ووفد مشترك لإدارة المفاوضات مع الوسطاء من أجل إيقاف جريمتي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس، وبما يحمي وحدانية الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها منذ العام 1967.
ثانيًا. ضرورة التنظيم الشعبي الفلسطيني وإحياء اللجان الشعبية
أثبتت السنوات الماضية أن غياب القيادة الفلسطينية الجماعية والمؤسسات الموحدة، قوّض القدرة على تمثيل الفلسطينيين أو الدفاع عن حقوقهم، مع تزايد سطوة مواقع القوة والنفوذ ذات المصلحة في بقاء الوضع الراهن من حيث علاقات التبعية مع الاحتلال، وكذلك عرقلة جهود تحقيق الوحدة الوطنية؛ إذ باتت القيادة الفلسطينية تعمل ضمن قيود يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وتفتقر إلى التجديد الديمقراطي، وترتكز على الهيمنة وحكم الفرد، ما جعلها عاجزة عن توفير الحماية لشعبها، أو القيام بمبادرات تقود إلى التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا الفلسطيني. وفي المقابل، أظهرت حركة حماس تشبثًا باستمرار سيطرتها الانفرادية على إدارة قطاع غزة طيلة 16 عامًا من الانقسام، حتى بدء جريمتي العدوان والإبادة وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
في هذا السياق، تصبح اللجان الشعبية البديل الأمثل لتنظيم المجتمع الفلسطيني على المستويات المحلية بعيدًا عن الهيمنة السياسية، حيث يمكن لهذه اللجان، ضمن رؤية حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حقّا العودة وتقرير المصير أن تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الحياة اليومية، وتوفير الحماية الذاتية، وتعزيز الحراك الجماهيري ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. لقد كانت اللجان الشعبية في الانتفاضة الأولى نموذجًا ناجحًا للصمود، حيث قامت بتنظيم آليات العيش المشترك بعيدًا عن سيطرة الاحتلال، وشكلت دعامة أساسية لتعزيز الاستقلالية المجتمعية. إعادة إحياء هذه اللجان في مختلف المناطق الفلسطينية، وبخاصة في المخيمات والقرى الأكثر تهديدًا بالتهجير، يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين.
كما يمكن أن تشكل هذه اللجان قوة ضغط مجتمعية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، ونشر التجديد والممارسات الديمقراطية فيه، ويمكن أن يطلق تحالف المجتمع المدني الفلسطيني مع هذه اللجان نداء الحرية والكرامة، الذي يعيد التأكيد على رؤية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، والتمسك بمنظمة التحرير كمنجز تاريخي، مع التأكيد على إنجاز المصالحة وفق إعلان بكين، بما يتضمن من تشكيل قيادة وطنية موحدة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، ووفد مشترك لإدارة المفاوضات مع الوسطاء من أجل إيقاف جريمتي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس، وبما يحمي وحدانية الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها منذ العام 1967.
ثالثًا. ضرورة وجود إستراتيجية وطنية للنضال
المقاومة بمختلف أشكالها واجب وحق طبيعي للشعوب التي يقع عليها الظلم والاستعمار، وأكدت قرارات دولية متعددة وميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق، وتم تأكيده، أيضًا، بشكل خاص للشعب الفلسطيني وفق قرار الجمعية العامة 2649 للعام 1970.
إلا أن ممارسة هذا الحق مقيدة، أيضًا، بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم استهداف المدنيين. ويجب أن تخضع وسائل النضال وأولوياتها وتوقيت ممارستها لقرارات الحركة الوطنية، آخذة بعين الاعتبار الظروف الوطنية والإقليمية والدولية، ومدى تكامل هذه الوسائل وقدرتها على تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ومن هنا يدعو المجتمع المدني الفصائل الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إلى إقرار إستراتيجية وطنية للنضال، تبحث في تكامل أشكال النضال وأولوياتها وانسجامها مع القانون الدولي الإنساني من أجل إنجاز الحقوق الفلسطينية وحماية الوجود الفلسطيني.
رابعًا. الاستفادة من القرارات الدولية وتعظيم الجهد المحلي كوسيلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي
تفاقمت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في ظل غياب أي تحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية للاستفادة من القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال؛ مثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، للضغط على الحكومات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على تحمل مسؤولياتها القانونية. لكن لا يمكن الاعتماد على المواقف الدولية فحسب، بل يجب تعزيز الحماية الشعبية على الأرض، عبر تنظيم فرق مجتمعية لحماية المدنيين، وتطوير آليات إنذار مبكر في المناطق الأكثر استهدافًا، إلى جانب تعزيز العمل القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. إن دمج الجهود الشعبية مع التحركات الدولية يمكن أن يعزز مناعة المجتمع الفلسطيني ضد سياسات التهجير والاقتلاع.
خامسًا. إعادة الإعمار بعد الإبادة الجماعية أداة لتعزيز الصمود
دمر العدوان الإسرائيلي أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وترك آلاف العائلات بلا مأوى، فيما شهدت الضفة الغربية، وبخاصة جنين وطولكرم، عمليات هدم واستهداف مباشر للمخيمات الفلسطينية بهدف إضعاف البنية السكانية الفلسطينية. في هذا السياق، تصبح إعادة الإعمار جزءًا من إستراتيجية لتعزيز صمود الفلسطينيين في أراضيهم، وليس مجرد عملية ترميم للبنية التحتية. إن إعادة الإعمار يجب أن تتم بإشراف هيئة وطنية مستقلة، تضم، أيضًا، مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين والهندسيين، لضمان عدم استخدامها كأداة ضغط سياسي. كما أن تبنّي نموذج اقتصادي يعتمد على الاستقلال الذاتي، من خلال دعم الزراعة البيئية، وتعزيز الصناعات المحلية، وإنشاء مشاريع إنتاجية تعزز من قدرة الفلسطينيين على العيش بكرامة، دون الحاجة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي المشروط، هو أمر أساسي في هذه العملية. أما المخيمات التي تعرضت للإزاحة القسرية، مثل جنين وطولكرم، فتحتاج إلى إستراتيجيات عاجلة لضمان بقاء سكانها، من خلال تقديم الدعم الفوري للأسر المتضررة، وتوفير السكن البديل المؤقت، وتعزيز مشاريع إعادة التأهيل المجتمعي لمنع فرض واقع جديد يخدم مخططات الاحتلال الإسرائيلي في تفريغ الأرض.
سادسًا. تعزيز دور مؤسسات التضامن الاجتماعي وحماية الفلسطينيين من التهجير
تلعب مؤسسات التضامن الاقتصادي الاجتماعي دورًا حيويًا في تعزيز صمود الفلسطينيين من خلال توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا من مواجهة الأزمات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. ومع تزايد معدلات التهجير القسري، يصبح دعم هذه المؤسسات ضرورة ملحة لضمان استمرار الفلسطينيين في أرضهم، ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. يمكن لمؤسسات التضامن الاجتماعي أن تساهم في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم مشاريع الإسكان للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم، إضافة إلى تعزيز خدمات الصحة والتعليم في المناطق المهمّشة. كما يجب أن تعمل هذه المؤسسات على تطوير برامج تنموية تساعد الفلسطينيين على بناء اقتصاد مستقل، بعيدًا عن الهيمنة الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. إلى جانب ذلك، فإن تعزيز التنسيق بين مؤسسات التضامن الاجتماعي المختلفة، يساهم في توحيد الجهود وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة، ما يعزز مناعة المجتمع الفلسطيني، ويمنحه القدرة على مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك بنيته المجتمعية.
سابعًا. التكافل الاجتماعي حصن ضد التهجير القسري
تعمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي على تفتيت البنية الاجتماعية الفلسطينية، من خلال فرض الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن والقرى، والاستيلاء على الأراضي المصنفة (ج) بهدف تهجير الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم. هذه السياسات تؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتضعف قدرة الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم. في مواجهة هذه التحديات، يجب تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي كأداة رئيسية لحماية الفلسطينيين من التهجير. يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم التعاونيات الإنتاجية، وإنشاء صناديق مجتمعية لدعم الأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل للشباب عبر مشاريع صغيرة ومستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، لضمان امتلاك الفلسطينيين أسباب البقاء في وطنهم رغم كل محاولات الاقتلاع.
التوصيات
لضمان تحقيق الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التهجيرية، من الضروري التركيز على مجموعة من التدابير الفعّالة التي تشمل تشكيل لجان شعبية في المدن والقرى والمخيمات لتعزيز الحماية المجتمعية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار لضمان التوزيع العادل للمساعدات دون تسييسها. كما يجب تعزيز العمل القانوني والدبلوماسي لتفعيل الحماية الدولية ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، ودعم مشاريع الزراعة البيئية والاقتصاد التضامني لتمكين الفلسطينيين اقتصاديًا، وتقليل التبعية للتمويل الخارجي. إضافة إلى ذلك، ينبغي توحيد جهود مؤسسات التضامن الاجتماعي لضمان استجابة فعّالة للأسر المتضررة، وتطوير برامج تدريب مهني وتعليمي للشباب لتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب تنظيم حملات دولية لفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الحراك الشعبي والمناصرة على المستوى الدولي. وأخيرًا، لا بد من الضغط على السلطة الفلسطينية لتبني سياسات وطنية تعزز صمود الفلسطينيين، وتوفر بيئة داعمة للمقاومة الشعبية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية وفق إعلان بكين.
تشير هذه الرؤية إلى أن الصمود الفلسطيني ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. إن بناء التنظيم الشعبي، من خلال اللجان الشعبية، وتعزيز الحماية الدولية، وإعادة الإعمار بطريقة تضمن الاستقلال الاقتصادي هي أمور أساسية في هذه العملية. في نهاية المطاف، فإن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب إرادة مجتمعية قوية، وقدرة على التكيف مع التحديات، وإستراتيجيات واضحة تعزز قدرة الفلسطينيين على البقاء في وطنهم رغم كل السياسات التي تهدف إلى اقتلاعهم. المجتمع المدني الفلسطيني يمتلك القدرة على لعب دور رئيسي في هذه المواجهة، من خلال بناء نماذج تكافلية واقتصادية واجتماعية وتربوية تجعل من الصمود الفلسطيني حقيقة واقعة لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي تجاوزها.
ويمكن أن يتم ذلك من خلال التوصيات التالية:
- تشكيل ائتلاف لاستكمال الحوار المجتمعي حول هذه الوثيقة وإغنائها بالملاحظات والتعديلات في أماكن تواجد الفلسطينيين كافة، وعبر التفاعل المباشر مع الفاعلين الاجتماعيين.
- أينما أصبح الوضع جاهزًا بتوافق عدد كاف من الفاعلين من المجتمع المدني والناشطين، يتم تشكيل هذه اللجان الشعبية، وتبدأ بتحديد مهامها وأنشطتها.
- يتم التخطيط لمؤتمر واسع بعد الانتهاء من الوثيقة من أجل إعلانها بشكل رسمي وإطلاق نداء الحرية والكرامة كأوسع ائتلاف شعبي مدني فلسطيني يستنهض طاقات المجتمع الفلسطيني ضمن رؤية وطنية تحررية.
- العمل على توفير مقومات الصمود المعنوية والمادية للفلسطينيين الصامدين على أرض فلسطين، وبخاصة في المخيمات الفلسطينية.
- تنسيق الجهود ما بين المؤسسات الإغاثية والتنموية والحقوقية الفلسطينية والقطاع الخاص واللجان الشعبية، من أجل رفع كفاءة التدخلات لتعزيز الصمود.
- مخاطبة المجتمع من القائمين على المبادرة بشكل مستمر، ووضع الجميع في صورة الحوارات وتطوراتها والإنجازات على الأرض، لرفع ثقة المجتمع الفلسطيني بإمكانية الإنجاز.
المشاركون/ ات
|
د. إبراهيم فريحات |
أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا |
|
أ. أبي عابودي |
المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء |
|
أحمد الطناني |
باحث في الشأن السياسي |
|
أ. آمال صيام |
المديرة العامة لمركز شؤون المرأة |
|
أ. أمجد الشوا |
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية |
|
أ. أنطوان شلحت |
كاتب وباحث في الشؤون الإسرائيلية |
|
أ. تحسين عليان |
مدير البرامج في مؤسسة الحق |
|
د. حسن أيوب |
أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح |
|
أ. خليل شاهين |
مدير البرامج في مركز مسارات |
|
أ. روان زقوت |
ناشطة شبابية |
|
أ. سمر ثوابتة |
إعلامية |
|
د. طلال أبو ركبة |
محلل سياساتي |
|
د. عزمي الشعيبي |
مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) |
|
د. عماد أبو رحمة |
مدير مركز مسارات في غزة |
|
أ. هاني المصري |
المدير العام لمركز مسارات |
|
أ. هدير البرقوني |
باحثة سياسية |
|
أ. وفاء عبد الرحمن |
مديرة مؤسسة فلسطينيات |
[1] جياب، نادية. "هل يكون إحياء منظمة التحرير الفلسطينية سيئة أفضل من عدم وجودها؟"، مسارات، ص 116.
[2] برهم، عبد الله. 2007. "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية- إشكالية الهيكلية والبرنامج" (رسالة ماجستير)، نابلس: جامعة النجاح الوطنية، ص97- 104.
[3] نجم، علي. 2020. "مسألة التمثيل الفلسطيني: الانتخابات مقابل الإجماع"، شبكة السياسات الفلسطينية: https://al-shabaka.org/policy-focusview
[4] محسن، صالح. 2007. "المجلس الوطني الفلسطيني: إعادة التشكيل وعدالة التمثيل، منظمة التحرير الفلسطينية تقيم التجربة وإعادة البناء"، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ص 56.
[5] دراغمة، أمين. 2020. "دورة المجلس المركزي الفلسطيني وتحديات المرحلة"، مركز رؤية للتنمية السياسية: https://vision-pd.org/wp-content/uploadst.com
[6] الروس، عماد. 2018. "خبراء وقادة بفتح يكشفون معلومات صادمة عن الصندوق القومي": https://arabi21.com/story/119%8A
[7] نائلة، خليل. 2018. "إعادة تشكيل المؤسسات السياسية الفلسطينية: الهدف تكريس تفرد عباس"، العربي الجديد: https://www.alaraby.co.uk/% B3
[8] "يرفض 80% من الجمهور المستطلعة آراؤه إعطاء الثقة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية"، للمزيد انظر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم 57: https://pcpsr.org/ar/node/622
[9] حيدري، نبيل. "منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس": الصراع في شأن النفوذ"، مجلة الدراسات الفلسطينية:
https://www.palestine-studies.org/ar/node/34919?utm_source=chatgpt.com
[10] الشوبكي، بلال. 2022. "انضمام حماس والجهاد إلى منظمة التحرير: هل هو ممكن، وكيف؟"، شبكة السياسات الفلسطينية:
[11] تعددت الجهود العربية والدولية الهادفة إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية في سياق تحقيق المصالحة الوطنية، حيث بُذلت جهود كبيرة على مدار سنوات الانقسام الفلسطيني. وقد أسفرت هذه المساعي عن توقيع العديد من الاتفاقيات التي سعت إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية وتعزيز الدور التمثيلي لمنظمة التحرير. للمزيد، انظر:
- قدس برس. 2025. "محاولات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية... تحديات ومالات" (ورقة حقائق): https://qudspress.com/181049/
- العجري، محمود. 2019. "تحليل مضمون اتفاقيات المصالحة الفلسطينية من منظور سيكوإستراتيجي: دراسة لاتفاقيات المصالحة من (2007- 2017)"، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإنسانية:
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/viewFile/4943/3185
- سوارت، ميا. 2019. "المصالحة الفلسطينية وإمكانية تحقيق العدالة الانتقالية"، مركز بروكنجز الدوحة:
[12] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. 11/3/2025. آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 271 | قطاع غزة:
[13] البنك الدولي. 18 شباط/فبراير 2025. التقرير المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية. ملخص تنفيذي:
[15] وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) unrwa.org. 10/2/2025. تهجير قسري واسع النطاق في الضفة الغربية يؤثر على 40 ألف شخص.
[16] الأمم المتحدة-فلسطين. 9/2/2024. مفوض حقوق الإنسان "التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.
[17] الأورومتوسطي لحقوق الإنسان - يوروميد. 25/1/2025. 16 عامًا من المرارة: جيل وُلد محاصرًا.. تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة
[18] الجزيرة. 22/1/2025. الاحتلال يخنق الضفة الغربية بـ898 حاجزًا عسكريًا
[19] شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. 12/2/2022. ربط مفاهيم الصمود بمتطلبات العمل الإنساني والتنمية:
- للمزيد انظر: "إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، رام الله، 22/7/2024: https://bit.ly/4bJL3f5.
- "خلافات جوهرية بين فتح وحماس تقلّص فرص تطبيق إعلان بكين"، الشرق الإخبارية، 23 تموز/يوليو 2024: https://bit.ly/4iMUvRg
- أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
- للمزيد حول "خطة الحسم"، انظر إلى: أشرف بدرة. قراءة تحليلية في خطة "الحسم" لحزب الصهيونية الدينية، الدوحة: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، نيسان/أبريل 2023: https://bit.ly/3DO3K4J
- "اجتماع أميركي إسرائيلي إماراتي سري حول "اليوم التالي" لغزة"، موقع عرب 48، 23/7/2024: https://bit.ly/41LXyTY
- "الرئاسة الفلسطينية اعتبرت حماس "شريكًا" في مجازر غزة.. كيف ردّت الفصائل؟"، الجزيرة نت، 14/7/2024: https://bit.ly/4hsS05p
[26] "كواليس اتفاق المصالحة الفلسطينية في بكين ... الشيطان في المواعيد"، العربي، 25/7/2024: https://bit.ly/41Rxequ
- "حملة "حماية وطن" في جنين: معالجة سنوات من الفوضى وضمان أمن المواطنين"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، رام الله، 16/12/2024: https://bit.ly/4j39sij
[28] هاني المصري. "هل انهار اتفاق بكين، أم جُمّد لوقت الحاجة؟"، موقع مركز "مسارات"، رام الله، 30/7/ 2024: https://bit.ly/4iJLecC
[29] "عملية السور الحديدي في الضفة: عدوان إسرائيلي ممنهج يمهّد للضم الكبير"، نون بوست: 28/1/2025: https://2u.pw/MurARmO7.
[30] ماهر الشريف. "النكبة ومراحل التهجير القسري"، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية، 15/5/2024: https://2u.pw/HkgL6ewZ.
[31] "خنقٌ وعزلة 17 سنة من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة"، المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: https://2u.pw/NRwthgf.
[32] "سموتريتش: 2025 عام فرض سيادة إسرائيل على الضفة مع عودة ترامب"، العربي الجديد، 11/11/2024: https://2u.pw/jrxcbTwN.
[33] "مشروع الاستيطان اليهودي في قطاع غزة"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، 4/12/2024: https://2u.pw/eMGW2Lt9.
[34] ""صفقة القرن" والمستوطنات الإسرائيلية"، BBC: https://2u.pw/2SMpuPzt.
[35] ""الهجرة الطوعية": الخطر الحقيقي في خطة ترمب"، شبكة قدس، 12/2/2025: https://2u.pw/ZIPEFdwF.
[36] "الإعلام الحكومي بغزة يكشف أرقامًا لخسائر حرب الإبادة الإسرائيلية"، الجزيرة نت، 2/2/2025: https://2u.pw/N3xfIkwS.
[37] المصدر السابق.
[38] إحصائيات مرصد شيرين: https://www.shireen.ps/.
[39] "تهجير إسرائيل للمخيمات ... إعادة هندسة الضفة الغربية"، العربي الجديد، 13/2/2025: https://2u.pw/6LhCBrvx.
[40] "تقرير الانتهاكات الاحتلالية السنوي 2024"، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1/1/2025: https://2u.pw/o56HDxMS.
[41] ""الترانسفير" الجديد.. خطة "سموتريتش" لحسم الصراع الصهيوني مع الفلسطينيين"، شبكة قدس، 17/12/2022: https://2u.pw/bRImD2pV.
[42] "القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، فما هي؟"، BBC، 4/3/2025: https://2u.pw/36t1hhHy.
[43] "القمة العربية في القاهرة.. السيسي يعلن عن خطة مصر لإعمار غزة دون تهجير"، التلفزيون العربي، 4/3/2025: https://tinyurl.com/yzvzhx2r.
[44] Gaza & West Bank Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA)، البنك الدولي، 18/2/2025: https://tinyurl.com/v99cskvc.
[45] رائد حلس. إستراتيجيات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، الدوحة: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 27/2/2025: https://tinyurl.com/2vww4kyn.
[46] مسوَّدة الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، 4/3/2025: https://tinyurl.com/s7kbt2a9.
[47] "مصر تتطلع إلى دعم أممي لـ"الخطة العربية" حول إعمار غزة"، صحيفة الشرق الأوسط، 15/3/2025: https://tinyurl.com/4psuctt2.
[48] "وزير الخارجية يستعرض خطة إعمار غزة وآليات التمويل على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية"، المصري اليوم، 11/4/2025: https://www.almasryalyoum.com/news/details/3421497.
[49] "اجتماع عربي طارئ بالقاهرة يناقش التصعيد الإسرائيلي في غزة"، صحيفة الشرق الأوسط، 19/3/2025: https://tinyurl.com/mrk74j9b.
[50] "قمة القاهرة تعتمد الخطة المصرية لإعمار غزة وترفض التهجير"، الجزيرة نت، 4/3/2025: https://aja.ws/korn1d.
[51] "مصطفى يدعو لتبني الخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة كخطة عربية إسلامية مشتركة"، وكالة "وفا"، 7/3/2025: https://www.wafa.ps/pages/details/116526.
[52] UAE lobbying Trump administration to reject Arab League Gaza plan, officials sayميدل إيست آي، 17/3/2025:
[53] حسن نافعة. "ملاحظات أولية على القمّة العربية"، العربي الجديد، 8/3/2025: https://tinyurl.com/wkjt2ywm.
[54] "ردود الفعل الإسرائيلية على الخطة المصرية لإعمار غزة"، الجزيرة نت، 5/3/2025: https://aja.ws/fxrfa2.
[55] أنطوان شلحت. "أبرز مآخذ إسرائيل على القمّة العربية"، العربي الجديد، 12/3/2025: https://tinyurl.com/nhbjmzja.
[56] أنطوان شلحت. "في آخر الاستنتاجات الإسرائيلية حيال مستقبل الحرب ضد غزة: الحسم ما زال بعيد المنال"، مركز الناطور للدراسات والأبحاث، 17/3/2025: https://tinyurl.com/4pa97aaa.
[57] Sommet arabe: un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire Gaza، يورونيوز، 5/3/2025: https://fr.euronews.com/embed/2765350.
[58] Trump: Palestinians could live in redeveloped Gaza 'freedom zone الجزيرة إنجلش، 7/4/2025: https://aje.io/ac4hbr.
[59] "تقرير: ترامب وافق على الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بشروط"، وكالة معا، 17/3/2025: https://www.maannews.net/news/2136312.html.
[60] "مناقشات مصرية أميركية موسعة حول خطة إعادة إعمار غزة"، العربية، 17/3/2025: https://ara.tv/utor1.
[61] "قمة القاهرة تعتمد الخطة المصرية لإعمار غزة وترفض التهجير"، مرجع سابق.
[62] "ماكرون والسيسي وعبد الله الثاني يدعون لهدنة في غزة وحكم بقيادة "السلطة الفلسطينية الممكّنة""، فرانس 24، 7/4/2025: https://f24.my/B4dn.
[63] "ماكرون يعلن عقد قمة في باريس لدعم أوكرانيا ويعتزم زيارة مصر لبحث إعادة إعمار غزة"، فرانس 24، 21/3/2025: https://f24.my/B24r.
[64] "ماكرون يأسف لمعلومات "مغلوطة" عن اعتراف محتمل بدولة فلسطينية"، دويتشه فيله عربية، 11/4/2025: https://p.dw.com/p/4t3Bj.
[65] رائد حلس. "إستراتيجيات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد الحرب"، مرجع سابق.
[66] سلطان بركات وفراس المصري. "إنعاش عملية إعادة إعمار غزة المتعثرة"، معهد بروكنجز، 22/8/2017: https://tinyurl.com/p2he3p5n.
[67] عمار علي حسن. "كيف سيتصرف العرب بعد رفض أميركا وإسرائيل نتائج قمة القاهرة؟"، الجزيرة نت، 10/3/2025: https://aja.ws/j422w7.
[68] هاني المصري. "اليوم التالي للقضية الفلسطينية"، مركز مسارات، 4/3/2025: https://tinyurl.com/5n7jumyt.
[69] المرجع السابق.
[70] رائد حلس. "إستراتيجيات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بعد الحرب"، مرجع سابق.
[71] المرجع السابق.
[72] د. إبراهيم فريحات: أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، والرئيس المؤسس للجمعية العربية لدراسات الصراع. عمل سابقًا خبيرًا أول في السياسات الخارجية بمعهد بروكنجز، ودرس موضوع النزاعات الدولية في جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن. من مؤلفاته: ثورات غير مكتملة، وإيران والسعودية وترويض صراع فوضوي وتحرير وساطة الصراع في العالم العربي، وحكم المتمردين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
[73] Sharon Zhang, “Poll Finds 6 in 10 Democratic Voters Now Back Palestinians Over Israelis,” Truthout, March 6, 2025, https://truthout.org/articles/poll-finds-6-in-10-democratic-voters-now-back-palestinians-over-israelis/.
[74] Ibrahim Fraihat and Basem Ezbidi, “The Lasting Impact of Trump's 'Deal of the Century' on the Question of Palestine,” Middle East Critique 33, no. 1 (March 2024): 121–141: https://doi.org/10.1080/19436149.2023.2261082.
[75] انظر، على سبيل المثال، القضية المرفوعة من قبل الصحافية الأميركية آبي مارتن ضد جامعة جورجيا سوثيرن يونفيرستي التي سحبت دعوتها للصحافية لأنها لم توقع على وثيقة تمنع مقاطعة إسرائيل، حيث حكمت المحكمة لصالح الصحافية مارتن. للمزيد، انظر:
Jordan Howell, “In Challenge to Georgia’s Anti-BDS Law, Federal District Court Sides with Journalist Disinvited from Georgia Southern University,” FIRE, May 27, 2021, https://www.thefire.org/news/challenge-georgias-anti-bds-law-federal-district-court-sides-journalist-disinvited-georgia
[76] Human Rights Watch. A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. April 27, 2021. https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
[77] Palestine Institute for Public Diplomacy, Polling 2024, accessed April 11, 2025: https://www.thepipd.com/resources/polling-2024/.